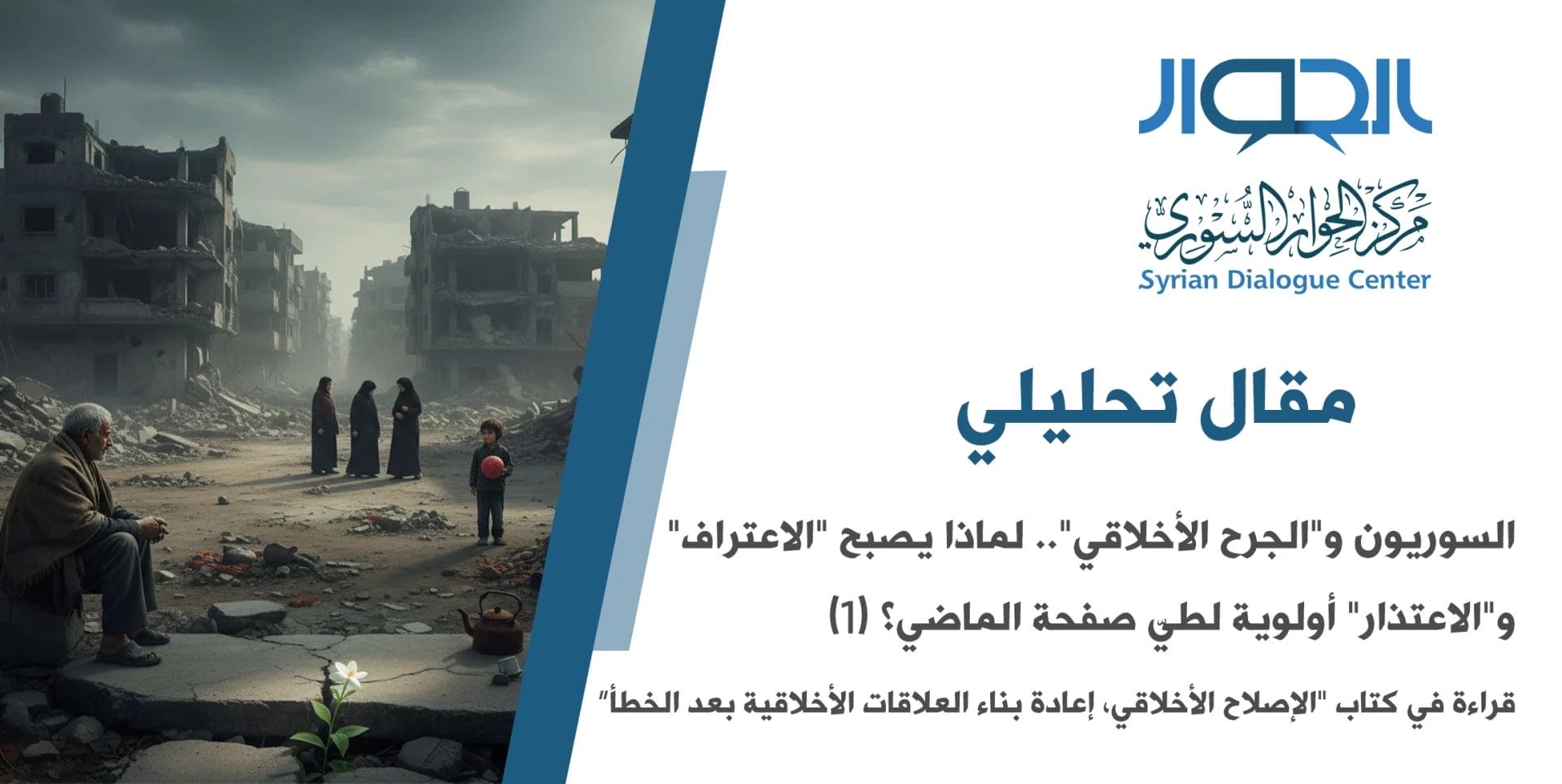
السوريون و”الجُرح الأخلاقي”.. لماذا يصبح “الاعتراف” و”الاعتذار” أولوية لطيّ صفحة الماضي؟ (1)
قراءة في كتاب "الإصلاح الأخلاقي، إعادة بناء العلاقات الأخلاقية بعد الخطأ"
شهد السوريون منذ سقوط نظام الأسد كثيراً من النقاشات والتجاذبات الحادة حول العديد من القضايا الإشكالية، وأهمها مسار العدالة الانتقالية، إذ يبدو أن هناك وجهات نظر مختلفة؛ بعضها من ينظر إلى هذا المسار بكونه مساراً محدوداً يُلزم كبار المجرمين فقط، وهو أمر ليس ذا أولوية في بلد أنهكته الصراعات؛ وهو فريق يريد طيّ صفحة الماضي بأكملها دون النبش فيها أو الاعتراف بفداحتها والاستمرار في دوره السابق وكأنّ شيئاً لم يكن مستفيداً من سياسة العفو العام الذي تبنّته الحكومة الجديدة عند استلامها السلطة، يقابله فريق ثانٍ ما زال عالقاً في لحظة الألم ينتظر الإنصاف والعدالة التي تردّ له جزءاً من اعتباره وتضحياته، إلى جانب فريق ثالث لا يرى مانعاً من إطلاق هذا المسار طالما أنه بعيد عنه لا يُسائله ولا يحاسبه.
وقد أكّدت الأحداث اللاحقة أن ثمّة توترات مجتمعية كامنة بين العديد من الأطراف يمكن أن تنفجر في أية لحظة لتعصف بحالة الاستقرار الهشّ الذي تعيشه البلاد، ومع تكرار الاحتكاك تعود بعض التوترات إلى الواجهة بشدات متفاوتة؛ إلا أن ما يلفت النظر في هذه التوترات وجود فئة ترفض وبشدة الاعتراف بالجرائم التي حدثت خلال حكم الأسدَين أو بدورها الداعم لها، بل ترى مشاركتها فيها أمراً عادياً ومبرراً بحكم تراتبية السلطة ونفوذها، أو بحكم المصالح والضرر المتوقع، أو لأسباب أخرى يراها أصحابها منطقية ومبررة. وفي الوقت ذاته تطالب هذه الفئة الآخرين بإعطائها الأولوية والاستجابة لمطالبها ومراعاة شؤونها، سواء لخصوصيتها العرقية أو الإثنية أو الأيديولوجية، إذ تريد أن تحظى بأعلى درجات المواطنة والحقوق في الدولة الجديدة، ولو كان ذلك على حساب منح الآخرين حقوقاً أدنى تتطلب كتم أصواتهم وتجاهل مطالبهم ومنعهم من النقد أو إبداء الرأي أو إنصافهم.
ورغم كل ما قيل وسُطّر في مجال العدالة الانتقالية والسلم الأهلي فلا يزال الحديث عن مسؤوليات المجتمع وأدواره في هذا السياق محدوداً، لم يرقَ إلى حالة وعي مجتمعي توضح الإشكالية والأضرار الاجتماعية التي أنتجتها سنوات القهر السابقة، ولا تأثيرها العميق على مستقبل الحياة في سوريا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة.
تأتي هذه المقالة التحليلية في قسمها الأول إضاءة على مفهوم “الجرح الأخلاقي” الذي تولده الصراعات، وتأثيره في بنية المجتمع والعلاقات السائدة بين مكوناته، في محاولة لتفسير العديد من الظواهر التي برزت بقوة خلال العام الماضي، وذلك من خلال تقديم قراءة معمقة لكتاب يُعد أحد المراجع العملية التي تستخدم في عمليات بناء السلام وتمتين السِّلم الأهلي. ثم سنقوم في مقال لاحق بإسقاط ما ورد في هذا الكتاب على الحالة السورية في محاولة لتفسير الأسباب التي تستدعي مبادرات مجتمعية تعالج الخطأ الأخلاقي وتقوم بتصحيحه.
الجُرح الأخلاقي الذي تُخلّفه الحروب والصراعات:
يُعد كتاب مارغريت والكر Margaret Urban Walker “الإصلاح الأخلاقي: إعادة بناء العلاقات الأخلاقية بعد الخطأ” أحد أهم المراجع في موضوعات بناء السلام ومواضيع السلم الأهلي؛ فقد حظي بأكثر من 2000 استشهاد في دراسات فلسفية وسياسية وقانونية[1]، واستُخدم في تصميم برامج المصالحة والتعليم الأخلاقي في كل من جنوب إفريقيا وكندا ورواندا؛ إذ يقدم الكتاب تصوراً جديداً حول الضرر الأخلاقي الذي تُسبّبه الصراعات والحروب، ويضع مقاربات حول كيفية ترميم الروابط الاجتماعية بعدها، معتبراً أن جوهر عملية العدالة الانتقالية لا تُركّز على فكرة ملاحقة الجناة فقط، وإنما هي مشروع أخلاقي يسعى إلى إعادة ترميم العلاقات بين الناس، وجبر الضرر الأخلاقي قبل المادي لتصبح عملية الاعتراف أساساً للمصالحة الحقيقية.
يعرّف الكتاب الأخلاق بكونها: “أكثر من مجموعة مفاهيم مجردة، وإنما شبكة من العلاقات المجتمعية تُنظّم معظم السلوكيات الاجتماعية، وتجعلها قائمة على القيم الاجتماعية السائدة كالثقة والاحترام والمساعدة والالتزام، بما ينظم التعاملات اليومية داخل العائلة ومع الجار، والطبيب، والصديق، والحاكم”[2] .
كما يشرح بنية الخطأ الأخلاقي بتوسع؛ إذ يبدأ من افتراض توافق سلوك المجتمع مع منظومة القيم الحاكمة للفرد وأن يطابق قوله فعله، ويرى أن تورُّط الفرد بسلوك مخالف للقواعد الأخلاقية المعروفة كالخيانة أو الكذب أو الإيذاء يخرق توقعات الآخرين ويقوّض العلاقة الأخلاقية بين هذا الفرد والمتضررين، وقد يكسر هذه الروابط المجتمعية ويتسبّب بألم أخلاقي أعمق من مجرد الخسارة المادية أو الأذى الجسدي عندما يكون الضرر شديداً[3].
تشير المؤلفة “ووكر” إلى ما يُعرف باسم “الموت الأخلاقي” الذي يُلاحظ في الجرائم الكبرى كالتعذيب والإبادة، التي تفقد القدرة على التواصل الأخلاقي بين طرفي العلاقة، ففيها يفقد المجرم قدرته على التعاطف مع الضحية ويكيل لها أنماطاً قاسية من العذاب، فيصبح الضحية غير مرئي للمجرم وللمجتمع ويُجرد من كونه إنساناً. ويتعقّد الأمر عندما تتورط الدولة أو الجماعات بأنماط الجرائم الأخلاقية الجماعية التي تُدمِّر العقد الاجتماعي القائم على مفاهيم الاعتراف والعدالة والاحترام المتبادل الذي يجمع بين أفراد المجتمع، وفي هذه الحالة لا يكفي التعويض المادي للضحايا، ولا يقتصر الأمر على الجاني فحسب، وإنما يصبح الاعتراف بالظلم والضرر أمراً بالغ الأهمية لأنه يعالج الجانب المعنوي للأذى الأخلاقي، ويعيد تجديد الالتزام الأخلاقي، والتأكيد على النية الصادقة في بناء قيم اجتماعية جديدة تؤكد عدم العودة لهذا السلوك في حال تكررت الظروف[4].
تشدّد ووكر على خصوصية جرائم القمع السياسي وعدم كفاية مسارات العدالة المؤسسية وحدها، إذ إن الجروح الأخلاقية المعنوية الناتجة عن حالات التعذيب والإذلال والقتل تُجرِّد الضحية من هيئته كإنسان له كرامة، ولهذا لا يمكن شفاء هذا الأذى ما لم يتم إعادة الاعتراف بالضحية كصاحب كرامة وصوت من طرف الحكومة والمجتمع على حد سواء، والالتزام بألا تتكرر الجريمة في المستقبل، وإفساح المجال للضحايا للتعبير والاستماع واستعادة مكانتهم كمواطنين متساوين تُحترم معاناتهم، وهو ما يجعل هذا الاعتذار أهم من التعويض المالي[5].
كما تقدم ووكر تصورها لما أسمته “الشرّ الأخلاقي”، وترى أنه نظام أخلاقي مريض أنتج حالة غير طبيعية ومستمرة من الظلم، وهو ينشأ من أنظمة استبدادية تركز على الطاعة المطلقة، ومؤسسات تشرعن التمييز أو القمع، إلى جانب مجتمعات تصمت أمام الانتهاكات بحجة الخوف أو المصلحة، وثقافة تُعيد تبرير الظلم بخطابات “الوطن” أو “الضرورة”، وبهذا تصبح منظومة الشرّ شبكة من ” الفعل والسكوت، من الخوف والمصلحة، من القانون واللامبالاة”[6].
وفي حالة الجرائم الكبيرة تتورط مجموعات متنوعة في منظومة الشر الجماعي: فاعلون مباشرون نفذوا الجرائم وقاموا بخروقات عميقة للقيم الإنسانية، وصامتون متفرجون شاركوا بشكل غير مباشر بالجريمة من خلال صمتهم وعدم تبنيهم موقفاً، ومستفيدون تحالفوا مع الظلم وأهله دون أن يتورطوا فيه حفاظاً على مصالحهم، ومجموعة من المؤسسات والبنى التي شرعنت هذا الظلم وأعطته هوية طبيعية كالمنظومة الإعلامية والتعليمية والأمنية، فيتحول الشرّ الجماعي إلى حالة مجتمعية فقدت فيها القيم معناها العملي، وأصبح فيها الناس “أدوات” أو “متفرجين” داخل منظومة ظالمة[7].
تُفرِّق ووكر بين مَن يتحمّل الذنب ويخضع للحساب القانوني كالجناة المتورطين، ومَن يتحمل المسؤولية وواجب الإصلاح كالمنتفعين والمتجاهلين والساكتين، وذلك في محاولة لتحويل “الذنب” من شعور سلبي إلى مسؤولية جماعية فاعلة للإصلاح الأخلاقي، وترى أن اختزال العدالة بمعاقبة المجرم يترك البنية الأخلاقية المشوهة للمجتمع كما هي، ويسهم في احتمال تكرار الجريمة مستقبلاً، مشيرة إلى التجربة الألمانية كحالة مُبكِّرة لممارسة “المسؤولية الجماعية الأخلاقية”؛ إذ لم يكن كل الألمان نازيين، لكن الجميع شاركوا بدرجات مختلفة في صمتهم أو قبولهم للنظام، ولهذا كان من الضروري بعد الحرب إجراء إصلاح أخلاقي يشمل التعليم والذاكرة والثقافة والمحاكم؛ إذ لم يكن الهدف معاقبة المتورطين فقط، بل “تطهير الضمير العام” وإعادة بناء القيم[8].
الجروح الأخلاقية والحاجة إلى إعادة بناء الثقة:
تشدّد ووكر على أن تأثير الحرب والنزاعات يتجاوز تدمير الأبنية والمؤسسات والبنى التحتية ليقضم النسيج الأخلاقي للمجتمع، فتصبح الثقة أولى خسائر الحروب، إذ تتلاشى مع اندلاع العنف، وتنتج مجتمعات مغلقة يسودها الخوف والتوجس، وتُشدّد ووكر على أن جوهر عملية التعافي من الجروح الأخلاقية يبدأ من إعادة بناء الثقة التي تُعد من الروابط الأساسية لتحقيق السلم الأهلي والأمان المجتمعي، وإعادة التأكيد أن الآخرين سيلتزمون بسلوكيات وفق المنظومة الأخلاقية الجديدة[9].
تُلخِّص ووكر مفهوم الثقة المجتمعية بثلاثة أبعاد رئيسة تتمثل في “القدرة”: أي إيمان الفرد بأن الطرف المقابل قادر على الفعل الصحيح، و”النية”: أي إدراكه أن الطرف المقابل لديه نية حسنة تجاه الآخرين لا يريد إيذاءهم، و”التوقُّع”: أي توقُّع أن هذا المقابل يُشارك الآخرين القيم والمعايير الأخلاقية نفسها، وترى أن غياب أحد هذه الأبعاد الثلاثة كفيل بأن يدمّر أو يوهن علاقة الثقة بين الطرفين، وهو ما تقوم به الصراعات ودوائر العنف عادة؛ فهي تدمّر ثلاثة مستويات متداخلة من الثقة: الثقة الأفقية بين أفراد المجتمع والجماعات المحلية، والثقة العمودية بين المواطن والدولة، والثقة الرمزية التي تُركِّز على القيم الوطنية المشتركة وتعمل على تعميق إيمان الناس بأن الوطن ما زال إطاراً جامعاً.
إن انهيار الثقة في المجتمع يجعل عملية المصالحة والعدالة شبه مستحيلة؛ إذ يغدو القانون غير كافٍ للإنصاف، فالناس لا يثقون بالقاضي ولا بنزاهة الدولة، وتصبح الوعود مجرد كلام، والاعتذار خداعاً، والمصالحة دعاية سياسية، ويتعقّد الوضع مع تعقُّد طبيعة البيئة بعد الصراع والحاجة لبذل كثير من الجهد على مستويين: الاعتراف الذي يعيد للضحايا مكانتهم، وتحريك منظومة العدالة والمساءلة المؤسسية التي تمنع حالة الإفلات من العقاب، وتضمن عدم تكرار الانتهاكات[10].
تُركِّز ووكر على الشِّقّ المجتمعي لعملية إعادة بناء الثقة التي دمرتها الصراعات، وتقدّم تصوراً حول آلية ترميم مجتمعي تنظر لعملية بناء الثقة كـ «علاقة أخلاقية»، وإلى إعادة الاعتراف المجتمعي بالضحايا كمواطنين متساوين، والتأكيد على عدم ترك الظلم يطالهم مستقبلاً. ويتم ذلك وفق أربع مراحل أساسية تقوم بها الفئات التي لم تتورط بالانتهاكات، لكنها سكتت عنها أو استفادت منها، وهي[11]:
- الاعتراف: الإقرار بالأذى الذي طال الضحايا وإظهار فهم حقيقي لمدى الضرر الذي تسبَّب به.
- الاعتذار: الالتزام الحقيقي بعدم تكرار ما تورط به.
- التعويض: وهو القدرة على تبنّي سلوك مستمر يُظهر صدق النية.
- تجديد العلاقة: إعادة بنائها وفق سلوك مبني على الوضوح والمساءلة.
إن قيمة الاعتذار الصادق المعنوية تتجلى في اعتراف الجاني أو مَن سانده بشكل ما بأنه خرق الالتزامات الأخلاقية المتوقّعة منه، لكنه يريد العودة إلى المجتمع الأخلاقي الذي خرق بنوده، ومن جهة أخرى فإن الضحية عندما يتفاعل مع مسار إعادة الثقة ويقدم على قبول الاعتراف بالذنب ثم الاعتذار لا يكون قد نسي الخطأ؛ لكنه قدم رهاناً شجاعاً وأخلاقياً على قدرته على بناء عالم أخلاقي مشترك مع مَن تسبَّب له بالأذى.
تشير ووكر إلى أن استعادة الثقة ليست بالأمر السهل، لاسيما وأنها تواجه عقبات وعوائق جمّة، كأن يكون الندم شكلياً يقدّمه الجاني وداعموه لأسباب مصلحية أو سياسية وليست أخلاقية، أو أن يرفض المجتمع أو المجموعة أو الدولة المتورطة الاعتراف بالجريمة والماضي ويلجأ إلى حالة من الإنكار الجماعي، أو أن يفقد الضحايا في بعض الأحيان القدرة على تصديق النوايا الحسنة نتيجة تكرار الخيانة، كما قد تفتقد عملية استعادة الثقة البيئة القانونية والسياسية التي تُحوِّل الوعود الشخصية بالتعويض إلى مسار حقيقي، أو يُسبّب الاستقطاب الهوياتي وتضخم الانتماءات الفرعية حالة من التعنت والإنكار وزيادة الاستقطاب، خاصة مع غياب الرموز الجامعة والنخب التي تتلمس خطورة الوضع وإمكانية تفجر الخلافات مجدداً[12].
إن النجاح في إعادة إطلاق مسار جديد للثقة المجتمعية هو المؤشر الحقيقي على استقرار السلام، لا غياب السلاح فقط من وجهة نظر ووكر، وهو يحتاج إلى رؤية مشتركة تستند إلى عقد اجتماعي جديد أو مشروع وطني يتيح مساحات آمنة للحوار بين الضحايا والجناة والمستفيدين والصامتين، ويدفع للواجهة برموز أخلاقية جديدة تجسد قيم العدالة والتسامح ويعترفون بوجود مظلومية مشتركة لا تنافسية[13].
المسؤولية المجتمعية في إعادة تصحيح القيم الأخلاقية:
تتوسّع ووكر في الفصل الرابع بالحديث عن أدوار المجتمع وعن مفهوم “المساءلة العامة” كونها ممارسة مجتمعية وسياسية تهدف إلى الاعتراف بالمسؤولية الأخلاقية عن أخطاء ارتُكبت باسم جماعة أو مؤسسة، تتجاوز الجانب القانوني (المحاكمة أو العقوبة) لتشمل الجانب الأخلاقي، وتفترض أن تكون هذه المساءلة علنية وجماعية تمزج القول والفعل، وتضمن عدم التكرار، ليصبح الاعتراف هو إعادة تعريف ما هو خطأ وما هو صواب في المنظومة القيمية، والإقرار بأن ما جرى هو ليس مجرد خطأ إداري وسياسي؛ بل هو انتهاك للقيم الأخلاقية التي صاغت العقد الاجتماعي السابق[14].
تشير ووكر إلى الوظيفة الرمزية والمركزية للاعتذار والمساءلة العلنية؛ فهي تُعيد بناء المعنى الأخلاقي للمجتمع، وتؤكد بشكل جمعي أن ما حدث لا يمثل قيمه، وأنه ملتزم باستعادة القيم المنتهكة، فهي محاولة من هذا المجتمع المنكوب أن يعيد تعريف نفسه بعد أن شوّهته الجريمة، وفي هذه الحالة يصبح الاعتذار الأخلاقي الجماعي علاجاً للجرج الرمزي، ويعيد للضحايا مكانتهم في العالم الأخلاقي، ويُرمِّم الهوية الوطنية لأنه يُعيد تعريف معنى “نحن” في المجتمع المنقسم[15].
تتساءل ووكر في الفصل الخامس: “ما الذي يحتاجه الضحايا أكثر: العدالة؟ التعويض؟ أم شيء أعمق؟” لتجيب بأن الضحايا يحتاجون قبل أي شيء إلى الاعتراف بإنسانيتهم الأخلاقية وكونهم فاعلين أخلاقيين، بمعنى آخر: يحتاج الضحايا إلى اعتراف عام من الآخرين بأنهم لم يقترفوا خطأ يستوجب المعاناة التي ذاقوها، بل كانوا على صواب، وأن الأوان قد حان ليعترف الجناة وأعوانهم ومَن ساندوهم بأنهم هم مَن أخطؤوا ويتحملون مسؤولية الظلم الذي تسببّوا به بدرجات، ويؤكدون رغبتهم بتصحيح الخطأ وأن يكونوا جزءاً من عملية بناء منظومة أخلاقية مشتركة قائمة على القيم الجديدة[16].
تعتبر ووكر أن المصالحة ليست “تسامحاً عاطفياً”، بل اتفاقاً على إعادة بناء العالم الأخلاقي من خلال إعادة تصحيح معايير الخطأ والصواب والمفاهيم المغلوطة؛ فالمصالحة تُعطي الضحية الاعتراف بأنه فاعل أخلاقي، وتُعطي الجاني اعترافاً بأنه شخص قابل للتغيير، وهو الطريق الوحيد لتجنُّب دوامة الكراهية الدائمة[17].
إن حالة الاعتراف المتبادل ضرورة أساسية للتعافي الجماعي؛ فجرائم القتل والتعذيب والإبادة لا تدمّر الأفراد فقط، بل تقسم المجتمع إلى عالمين منفصلين أخلاقياً: عالم الجناة الذي يسوده الإنكار والتبرير، وعالم الضحايا الذي يسوده الألم والإذلال وآثار المعاناة. وتقوم عملية الاعتراف المتبادلة بالذنب وقبول الاعتذار بمدّ جسر بين الطرفين يُذكّر كلاً منهما بأنهم بشرٌ وأنهم قادرون على تحمّل المسؤولية والتواصل الأخلاقي رغم كل شيء، فيصبح الاعتراف المتبادل هو أعمق أشكال التعافي الأخلاقي، لا يهدف إلى العودة إلى ما قبل الجريمة؛ بل إلى بناء علاقة جديدة على وعي أعمق بالمسؤولية الإنسانية[18].
تُركِّز ووكر في فصلها الأخير على ارتباط فكرة “الإصلاح الأخلاقي” بمفهوم الذاكرة الجماعية، إذ إنها ترى أن المجتمع الذي ينسى أخطاءه يُخاطر بتكرارها، وأن العدالة لا تكتمل بالاعتراف فقط، بل بتحويل الماضي إلى ذاكرة أخلاقية حية تحفظ تجارب الضحايا وتحوّلها إلى قيم أخلاقية للأجيال القادمة، وأن صياغة هذه الذاكرة يستدعي ما أسمته “التعلّم الأخلاقي من الكارثة”، وذلك من خلال توسيع النظر إلى الانتهاكات ليس بكونها جرائم فقط، وإنما دروس أخلاقية يمكن أن تعيد تعريف القيم نفسها في المجتمع، وإعادة التفكير في القيم التي سمحت بالظلم، والحضّ على بناء ثقافة نقدية جديدة تسمح بتحويل التجربة المؤلمة إلى وعي أخلاقي عام، وإنشاء مسار قائم على مراجعات ذاتية أخلاقية واعتبارها هذه المراجعات مسؤولية مشتركة للمجتمع .[19]
تشدّد ووكر على أن الإصلاح الأخلاقي لا يتم داخل المحاكم أو النُّصُب التذكارية فقط، بل في الفضاء العام ضمن مسارات صياغة الذاكرة: كالحوار الوطني، والتعليم، والإعلام، والفن، وذلك من خلال التركيز على أربع قيم مركزية وهي: الصدق؛ أي رفض الإنكار، وتوثيق الجرائم، والمسؤولية عن تبعات الماضي، والاحترام الذي يتجلى بإعادة الاعتراف بالضحايا؛ وبهذه القيم يحدث الالتزام الجماعي بمنع تكرار الجريمة.
إن مسؤولية الإصلاح الأخلاقي وفقاً لووكر واجبة على الجميع؛ ليس لأن الجميع مذنبون، بل لأن الجميع يعيشون داخل هذا العالم، ولهذا فإن مسؤولية الأفراد تبدأ من مراجعات عميقة وشفافة للذات والاعتراف بالماضي، ومسؤولية المجتمع المدني تنطلق من توثيق الجريمة وتحليل أسبابها في محاولة لاستعادة الثقة، ومسؤولية الدولة تُركِّز على بناء المنظومة المؤسسية التي تعيد إصلاح القوانين وترمّم الشرعية الأخلاقية للنظام الجديد[20].
تختم ووكر الكتاب بتأكيد أن “الإصلاح الأخلاقي” لا يحدث بسرعة، بل هو مسار زمني طويل وتراكمي؛ لأن الثقة لا تُرمّم بتصريحات، بل بعقود من السلوك المجتمعي الصادق الذي تصبح فيه “العدالة” فعلاً تعليمياً مستمراً أكثر من كونها مجرد أحكام أو تعويضات، ويتحول التضامن الأخلاقي إلى رغبة جماعية في الخير العام وإلى بناء المنظومة الأخلاقية المستقبلية التي تعلمت من دروس الماضي.
لا يمكن تجاوز ما كتبته ووكر دون إسقاطه على الحالة السورية التي خلّفت أشكالاً متنوعة وعميقة من الجروح، حيث إن محتوى الكتاب يُقدّم العديد من التفسيرات المنطقية التي تجعل التعافي الأخلاقي من أهم الأولويات للعيش المشترك في سوريا، والذي يفترض أن تبادر به الفئات التي أدت وساهمت بتوسيع هذا الشرخ وهو ما سيتم تفصيله في مقال قادم.
Cambridge: Cambridge University Press, , pp. 137–141.
مديرة الوحدة المجتعية في مركز الحوار السوري، بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة دمشق، ماجستير في حماية اللاجئين والهجرة القسرية من جامعة لندن، باحثة مهتمة في قضايا المرأة والهجرة والمجتمع المدني





