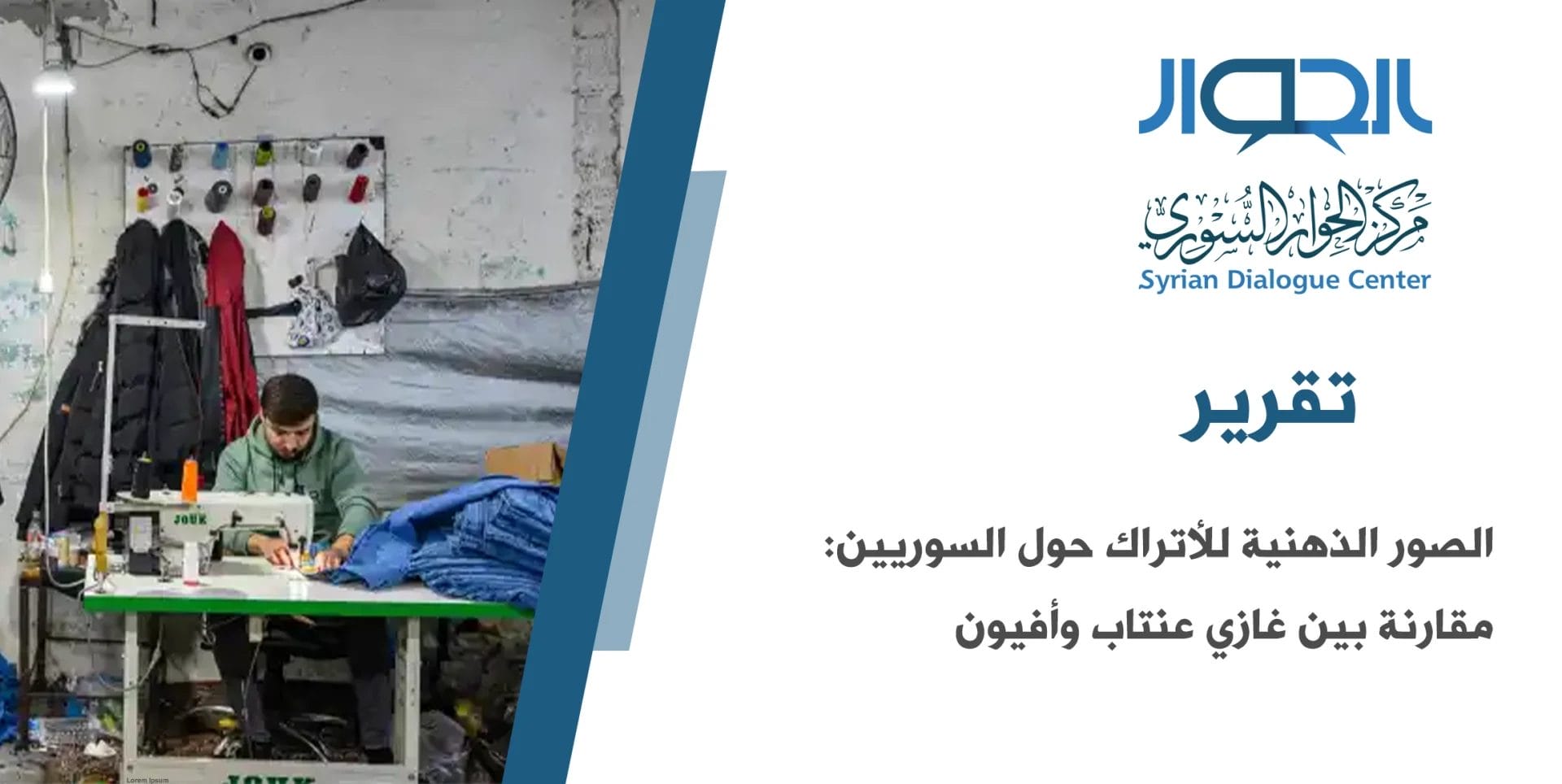
الصور الذهنية للأتراك حول السوريين: مقارنة بين غازي عنتاب وأفيون
ترجمة لدراسة نُشرت في مجلة كوجا تيبيه للعلوم الإنسانية في تركيا برعاية مركز الحوار السوري
ملخص:
تبحث هذه الدراسة في الصور الذهنية للأتراك تجاه اللاجئين السوريين من خلال مقارنة حالتين مختلفتين: مدينة غازي عنتاب التي تضم أعدادًا كبيرة من السوريين ويتسم فيها التفاعل اليومي بالوضوح، ومدينة أفيون قره حصار التي يقل فيها الوجود السوري إلى حد شبه معدوم. اعتمد الباحثان منهجًا نوعيًا قائمًا على مقابلات معمّقة مع عينة قصدية من السكان في المدينتين، لتحليل التصورات حول الأسرة السورية، والعلاقات الاجتماعية، وقواعد الحياة المشتركة، وأنماط الترفيه والعمل.
أظهرت النتائج أن التفاعل المباشر في غازي عنتاب أسهم في إنتاج مواقف أكثر تنوعًا، حيث تتداخل الانطباعات السلبية (مثل كثرة الأطفال، التحرك الجماعي، ضعف الالتزام بالقواعد غير المكتوبة، النظافة، “احتلال” المرافق العامة) مع انطباعات إيجابية أو محايدة مستمدة من تجارب شخصية ناجحة مع بعض الأسر أو الأفراد السوريين. برزت صورة المرأة السورية كمحور أساسي في تشكيل الانطباعات، سواء من حيث المظهر والأدوار الأسرية أو مسألة تعدد الزوجات، إلى جانب المخاوف من التأثير على التوازن الديموغرافي. كما ارتبط السوريون في المخيال الشعبي بثقافة النرجيلة والقهوة وأسلوب حياة يختلف في مواعيد العمل والراحة عن النمط التركي.
في المقابل، كشفت حالة أفيون عن هيمنة السردية العامة السلبية تجاه السوريين، رغم محدودية التفاعل المباشر. تبنّى السكان الصور النمطية المتداولة وكرروها كما هي: الإنجاب المفرط، الانغلاق الثقافي، ضعف تعلم اللغة التركية، التمركز في أحياء محددة، وغياب الانتماء. هذه التصورات غالبًا ما استندت إلى ما تبثه وسائل الإعلام والخطاب السياسي، لا إلى تجارب واقعية محلية.
خلصت الدراسة إلى أن الخطاب الوطني التركي المعادي للسوريين يتمتع بقوة انتشار تجعل تأثيره حاضرًا حتى في المناطق الخالية منهم، بينما يمكن للتجارب الميدانية المباشرة أن تخفف من حدته أو تعيد تشكيله، مما يبرز أهمية التفاعل الإيجابي كأداة لتفكيك الصور النمطية وتعزيز الفهم المتبادل بين المجتمعين.
مقدمة:
مرّت تركيا في السنوات الأخيرة التي سبقت تاريخ سقوط نظام الأسد البائد في 8/12/2024 بمرحلة أصبحت فيها المواقف الرافضة تجاه اللاجئين السوريين ظاهرة للعلن. وقد ركّزت الدراسات التي أُجريت حول هذا الموضوع بشكل أساسي على الانقسام السياسي في تركيا، وعلى وجه الخصوص على صعود “حزب الظفر”، إلى جانب التطرق أحيانًا إلى عدم توافق السوريين مع البنية الثقافية أو الاجتماعية القائمة في تركيا.
غير أن الخطابات التي تُطرح بهذا الصدد كثيرًا ما تفتقر إلى الرؤية التاريخية، وتُركّز بشكل كبير على تصاعد خطاب الكراهية في السنوات الأخيرة. في حين أن فهم جذور هذا الرفض الشعبي يتطلب العودة إلى عام 2012، حين بدأت موجة النزوح من سوريا. وبذلك يمكن القول إن التراكم الذي بدأ منذ سنوات طويلة وازداد تدريجيًا حتى بات من الصعب ضبطه قد انفجر خلال السنوات الأخيرة.
عموماً على الرغم من وجود شبه إجماع بين مختلف الدراسات إلى أن نسب عداء الأتراك تجاه السوريين وصلت إلى أرقام مرتفعة، فإنه لا توجد دراسات سعت لتفصيل صورة السوريين لدى الأتراك ومصادر تشكلها، وهذا ما ستستعى هذه الدراسة للوقوف عليه.
من النقاط الأساسية التي ستركز عليها دراستنا الميدانية هي: هل تؤدي مستويات التفاعل المختلفة إلى نشوء مواقف مختلفة تجاه السوريين؟
لذلك سيتم مقارنة المواقف في مدينة أخرى تكون فيها نسبة السوريين منخفضة جدًا، وبالتالي فإن التفاعل المباشر بين الطرفين يكون معدومًا أو محدودًا للغاية.
مناقشة الأدبيات:
رغم كثرة الدراسات التي أُجريت حول اللاجئين السوريين في تركيا، إلا أن عدد الدراسات التي تتناول تأثير هذا الوجود على السكان المحليين – أي المواطنين الأتراك – وردود أفعالهم تجاهه، لا يزال محدودًا للغاية.
فعلى سبيل المثال، في غازي عنتاب عام 2018، نُشر كتاب بحثي مبني على تحليل استبيانات شملت عددًا كبيرًا من المشاركين، غير أن هذه الاستبيانات اقتصرت على السوريين فقط (Gültekin وآخرون، 2018). وفي عام 2021، نشر نفس الفريق البحثي ثلاثة كتب حول ديناميات الهجرة في غازي عنتاب خلال عام 2020، حملت عناوين: “السوريون”، “سكان غازي عنتاب”، و”الاندماج الاجتماعي”. وفي كتاب “سكان غازي عنتاب”، تركزت الأسئلة المطروحة على الجوانب الديمغرافية والاجتماعية للسكان المحليين، بينما لم يُطرح إلا عدد محدود جدًا من الأسئلة المتعلقة بعلاقاتهم مع السوريين (Gültekin وآخرون، 2021، أ: ص 47-51).
أما في كتاب “الاندماج”، الذي نُشر ضمن نفس السلسلة، فقد تضمن أسئلة تقيس بشكل أكثر تفصيلًا مستوى وشكل العلاقات بين السوريين وسكان غازي عنتاب. وعلى الرغم من أن هذا الكتاب قدّم نتائج مهمة في كشف أنماط التفاعل، إلا أنه بقي ضعيفًا في معالجة الأبعاد التي تُمثّلها عملية “الاندماج” من حيث أشكال التشابه أو التمايز التي تُنتجها هذه العلاقات أو غيابها لدى الطرفين (Gültekin وآخرون، 2021، ب).
وتُعدّ من أبرز الأعمال التي صدرت في الأدبيات التركية حول الهجرة كتاب “السوريون في كل مكان – السكان المحليون والمهاجرون”، الذي يجمع نتائج دراسات ميدانية أُجريت في مدينة كيليس. ويتميّز هذا الكتاب بعمق فلسفي ونظري يمنحه أهمية خاصة. يتناول الكتاب مفاهيم “الضيف” أو “الزائر”، ويناقش منها مفهومي “الضيافة” و”رفض الضيافة” أو “العداء للضيف”. ووفقًا لتحليله، فإن السوريين في كيليس لا يُنظر إليهم كأصحاب بيت بل كـ”آخر”، وبالتالي فإن العلاقة معهم تُبنى على أساس الضيافة، وليس على أساس المساواة في المواطنة. (Kahraman، 2022: ص 29-30).
ويشير الكاتب بشكل لافت إلى أن صفة “الضيف” تفترض بالضرورة “الرحيل”، وأن الإقامة الطويلة تتسبب بتحول الضيافة إلى عداء. ويؤكد أن أصل الكلمتين hospitality وhostility في اللاتينية واحد، مما يعكس أن الانتقال من مشاعر الضيافة إلى مشاعر العداء لم يكن صعبًا في حالة كيليس وتركيا عمومًا (Kahraman، 2022: ص 42-43).
وفي نفس الكتاب، يكتب بيرم كوجا في مقاله أن تصاعد العداء تجاه اللاجئين في كيليس وتركيا عمومًا يستمد قوته من تصاعد الخطاب القومي، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي لعبه حزب الظفر القومي المعادي للمهاجرين (Koca، 2022: ص 47-74).
أما دويغو ألتين أولوك وتوغجه تونتش، فتتناولان في مقالهما هذا التحول من منظور نسائي، من خلال نظرة نساء كيليس. تركز الباحثتان على الأبعاد الجندرية لتصاعد العداء تجاه اللاجئين، وتتناولان تأثير انتقال ثقافة تعدد الزوجات من سوريا إلى كيليس، واستغلال معاناة النساء السوريات ضحايا الحرب، بالإضافة إلى تأثير الكثافة السورية على استخدام الأماكن العامة كالحدائق والشوارع. (Altınoluk؛ Tunç، 2022: ص 75-110).
تركز المقالات الواردة في هذا الكتاب على مشاعر البعد أو “الاغتراب” التي يشعر بها السكان المحليون تجاه السوريين، إلا أنها لا تسلط الضوء بشكل كافٍ على السياقات الاجتماعية التي قد تُبرر أو تُفسر هذا الشعور. فعلى سبيل المثال، لا يتم التطرق بوضوح إلى الفوارق الثقافية التي يصعب على البعض تقبّلها، أو إلى النتائج السلبية للعمل غير الرسمي الذي يدخل فيه السوريون غالبًا من دون قصد أو اضطرارًا، وتأثير ذلك على المنتج والعامل التركي على حد سواء. كذلك، لم يتم بحث كيف يمكن للثقافة الأسرية المختلفة والأدوار الجندرية داخل الأسر السورية أن تُشكّل تهديدًا للأدوار الجندرية القائمة في البيئة الاجتماعية والثقافية التركية.
كما لم تعط بعض العوامل مثل: العلاقات الاجتماعية، مستوى التفاعل، الطبقات الاجتماعية، الفرق بين الريف والمدينة، والمكانة الاجتماعية، حقها في تحليل المواقف تجاه اللاجئين السوريين.
وتُظهر دراستان لرسالتين للماجستير أُعدّتا مؤخرًا في هذا السياق مدى تعمق مشاعر “المسافة الاجتماعية” تجاه السوريين بين سكان غازي عنتاب، وكيف تحوّل السوريون إلى “رمز للخوف”. إحداها أُجريت على سكان محليين من حي “شهركوستو” بمدينة غازي عنتاب، وتُبرز أن مشاعر الخوف والابتعاد عن السوريين كانت واضحة في المقابلات الميدانية. فبعد أن كان الحي مأهولًا بشكل أساسي من قبل السكان المحليين، أصبحت الغالبية فيه اليوم من السوريين، ما دفع بالأتراك إلى الهجرة نحو أحياء أخرى (Bayram، 2024: ص 55).
أما الرسالة الثانية، فقد أُجريت على طلاب أتراك في جامعة غازي عنتاب، وركّزت على مواقفهم تجاه الطلاب السوريين، وكشفت أن مستوى العداء للأجانب وصل إلى 54.39، ما يشير إلى مستوى عالٍ من العداء تجاه الأجانب” (Yaşar، 2024: ص 60).
تشير هذه المعطيات إلى تشكُّل خطاب سلبي واسع النطاق في تركيا عمومًا، يقوم على تهميش “الأجانب” بوجه عام، و”السوريين” على وجه الخصوص. وتستند هذه السردية إلى مشاعر مثل الخوف، والاغتراب، وانعدام الحوار، غير أن أشكال ظهورها تختلف بحسب السياق.
كما ستُظهر هذه الدراسة الميدانية، أن مستوى التفاعل بين السوريين والأتراك، ونسبة اللاجئين إلى السكان المحليين في كل حي، ومستوى المعرفة المتبادلة بين الطرفين، جميعها عوامل تتفاعل مع الديناميات المحلية لتُنتج سرديات وسلوكيات مختلفة.
ومن هنا جاء اختيار مدينتي غازي عنتاب وأفيون قره حصار كمجالين للمقارنة. فهاتان المدينتان تختلفان من حيث الخصائص الاجتماعية لكل من السكان المحليين واللاجئين، وكذلك من حيث نسب وجود السوريين فيهما.
وبطبيعة الحال، فإن هذا الاختلاف في الديناميات المحلية يؤثر بشكل مباشر على كيفية إعادة إنتاج “السردية الوطنية عن السوريين” على المستوى المحلي.
فما أسباب هذه الظواهر؟
تُعدّ منطقة وسط-غرب الأناضول من المصادر البشرية الرئيسية للحس القومي التركي. ورغم أن سكان هذه المنطقة يتمتعون بحساسية دينية إسلامية، إلا أنهم يحملون أيضًا عداءً متجذرًا تجاه العرب، تغذّيه الموروثات التاريخية والبناء الخطابي القومي. ((Jung, 2005
بالإضافة إلى ذلك، فإن ديناميات التنمية في هذه المناطق محدودة جدًا، ما أدى إلى تكوين هوية مجتمعية متجانسة، ينظر أصحابها إلى التنوع والاختلاف بنوع من التحفظ أو الرفض (Erdoğan, 2018). فلطالما كان للقومية التركية “آخرين” في الماضي، لكن من المؤكد أن “الآخر” في تركيا اليوم أصبح هو السوري.
لذلك، من الطبيعي أن تكون المدن التي لم تختبر تفاعلًا مباشرًا مع السوريين، من أكثر البيئات تقبّلًا للسردية القومية المعادية للسوريين. بخلاف ذلك، في غازي عنتاب مثلًا نرى أن التجربة الشخصية والتفاعل المباشر يخلق ديناميات إدراكية مختلفة تعيق تمامًا ترسيخ الرواية السياسية العامة.
بغضّ النظر عمّا إذا كان الشخص قوميًّا تركيًّا أم لا، فإن تصوره عن السوريين يتشكل من تجربته الشخصية معهم، أو من تجارب قريبة سمع بها من محيطه. وحتى أولئك الذين يعبرون عن رغبتهم الحازمة في “رحيل السوريين” في غازي عنتاب، كثيرًا ما يبدؤون جملهم بكلمة “لكن”، ثم يتبعونها بتعابير إيجابية بناءً على تفاعل واقعي أو مشاهدات.
أما في أفيون، فلا توجد مثل هذه التجارب الواقعية، أو تكاد تكون نادرة للغاية. وربما، لو شهدت المدينة تدفقًا سكانيًا سوريًا كبيرًا، لتغيّر هذا التصور، لكن في ظل الواقع الحالي، لا يمكن إلا تفسير المواقف بناءً على الوضع القائم.
أهمية نتائج هذا البحث تكمن في أنها تكشف عن مواقف سكان مدينة لم يعيشوا تجربة التفاعل مع السوريين بشكل مباشر، لكن مع ذلك تبلورت لديهم مواقف معادية تحت تأثير السردية الوطنية السائدة تجاههم.
كما يمكن لهذه النتائج أن توضح كيف تُعيد الديناميات التقليدية في مدينة ما إنتاج سردية وطنية معادية، حتى دون الاحتكاك الفعلي مع “موضوع” تلك السردية – أي السوريين أنفسهم.
المنهجية:
تم تنفيذ الدراسة الميدانية في إطار هذا المشروع في مدينتين: غازي عنتاب التي تضم عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين، وأفيون التي تُعدّ مدينة يقل فيها وجود السوريين بشكل ملحوظ. وتهدف هذه الدراسة، إلى جانب قياس التوجهات العامة تجاه اللاجئين السوريين، إلى الكشف عمّا إذا كان حجم وجودهم ومستوى التفاعل بينهم وبين السكان المحليين يؤثران في تصورات السكان المحليين تجاههم.
وقد تم اختيار هاتين المدينتين نظرًا لما تتيحه من إمكانية إجراء مقارنة بين وجود اللاجئين ومستوى التفاعل معهم، ودور الخصائص المحلية للمدن في تشكيل المواقف تجاه اللاجئين. إذ إن غازي عنتاب وأفيون تختلفان اختلافًا كبيرًا من حيث الخصائص الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، مما يسمح بفهم الخلفية المحلية التي تساهم في تكوين المواقف تجاه السوريين في كل مدينة.
بحسب بيانات عام 2024، بلغ عدد السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة في غازي عنتاب 373,637 شخصًا، أي ما يقارب 15% من سكان المدينة. أما في أفيون قره حصار، فيبلغ عدد السوريين 8.342 فقط بنسبة 1.1% من إجمالي عدد سكان المحافظة 751,344 نسمة. ويُظهر هذا الفارق كم أن نسبة اللاجئين في أفيون قره حصار منخفضة للغاية[1].
بالنسبة إلى مدينة أفيون قره حصار، أو اختصارًا أفيون فهي مدينة تقع في وسط-غرب الأناضول، وتُعد من المدن التي تكاد نسبة اللاجئين السوريين فيها إلى إجمالي السكان أن تكون ضئيلة جدًا، وبالتالي فإن التفاعل بين السوريين والسكان المحليين يكاد يكون معدومًا.
وتُظهر المدينة مؤشرات منخفضة من حيث معدلات النمو السكاني، والكثافة السكانية، والحصة من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط الدخل الفردي، مقارنة بالمعدل العام في تركيا (Ayhan، 2020: ص 422–423). كما أن الفئة “المدينية” التي تملك قدرة على توجيه الحياة العامة في المدينة ضعيفة التأثير. لذلك، يمكن وصف أفيون بأنها مدينة نموذجية لمناطق وسط-غرب الأناضول ذات المستوى المتوسط في جميع المؤشرات.
وقد يكون من أسباب عدم تفضيل السوريين الاستقرار في هذه المدينة، إلى جانب الفوارق الثقافية الكبيرة، محدودية الحراك الاقتصادي والسياسي فيها. فمنذ عقود، كانت أفيون مدينة طاردة للهجرة وليست مستقبِلة لها (Ayhan، 2020: ص 423).
ومن وجهة نظر القادمين من الخارج، تُوصف مدينة أفيون بأنها: “تقليدية، محافظة، منغلقة، غير متقدمة، نظيفة، هادئة، ورخيصة” (Özdemir وKaraca، 2009: ص 131).
وقد تم اختيار مدينة أفيون في هذه الدراسة الميدانية لأنها تمثل نموذجًا للمدن المتوسطة في وسط-غرب الأناضول، والتي تُمارس فيها السياسة المحلية من خلال قضية السوريين، رغم غيابهم فعليًا عن المشهد الديموغرافي. فقد أصبحت قضية السوريين محورًا من محاور الاستقطاب السياسي المحلي، تمامًا كما هو الحال في مدينتي أوشاك وكوتاهيا، اللتين تتشابه بنياتهما الاجتماعية وديناميات تطورهما مع أفيون.
ورغم أن عدد السوريين في هذه المدن الثلاث يكاد يكون معدومًا، إلا أن الخطاب السياسي المعادي للسوريين لعب دورًا حاسمًا في نتائج الانتخابات المحلية، حيث فازت فيها المعارضة (حزب الشعب الجمهوري – CHP) برئاسة البلديات.
ومن اللافت للنظر أن الإدارات المحلية الجديدة في أفيون وأوشاك، وعلى الرغم من عدم وجود عددٍ يُذكر من السوريين في مدنهم، كانت أولى إجراءاتها فرض قيود على السوريين فيما يتعلق بالزواج وفتح المحال التجارية. أي أن أولى الإجراءات “الراديكالية” كانت تستهدف تنظيم حياة جماعة غير موجودة أصلاً.
أما بالنسبة لمدينة غازي عنتاب، فهي على العكس تماماً تمثل مدينة صناعية تقع على الحدود مع سوريا وضمت عدداً كبيراً من السوريين وصل في بعض الأحيان إلى ما يقارب نسبة 18% من السكان الأصليين (Mülteciler Derneği, 2022)، كما أن السوريين -ونظراً لأعدادهم الكبيرة- كانوا على احتكاك مع الأتراك في مختلف المجالات؛ سواء في العمل أو أماكن الترفيه أو المستشفيات أو المدارس أو الجامعات أو المساجد، إلخ.
اتُّبع في هذه الدراسة المنهج النوعي، حيث تم استخدام مجموعة من الأسئلة المفتوحة غير المهيكلة المعدّة مسبقًا، وأُجريت مقابلات معمّقة مع 25 مشاركًا في غازي عنتاب و15 مشاركًا في أفيون.
وقد عُرِّفت المقابلة غير المهيكلة على النحو الآتي:
“هي نوع من المقابلات يمتلك فيها الباحث اهتمامًا عامًا في موضوع معين، لكنه يسمح للحوار بأن يتطور بحرية ضمن هذا الإطار دون فرض هيكل ثابت. ويمكن أن تكون غير رسمية تمامًا” (Robson، 2015: ص 347).
وقد تم إجراء المقابلات وجهًا لوجه، وتم تسجيل معظمها صوتيًا، وفي الحالات التي رفض فيها المشاركون التسجيل، تم تدوين الملاحظات كتابيًا.
في أفيون، كانت جميع المقابلات فردية، بينما في غازي عنتاب، أجريت 4 مقابلات ضمن مجموعات تركيز، منها 3 مجموعات تتكوّن كل واحدة منها من شخصين، ومجموعتان تتكون كل واحدة منهما من 4 أشخاص. أما المقابلات الـ11 الأخرى في غازي عنتاب، فقد كانت فردية.
تم اختيار المشاركين في كلا المدينتين بشكل قصدي (عمدي) لضمان تمثيلهم الصحيح للتوزيع الديموغرافي والتوجهات الفكرية للمجتمع المحلي. وقد استُخدمت تقنية العينة القصدية لتحديد الأشخاص الذين يمكن الحصول منهم على بيانات غنية وذات معنى تُمثّل واقع كل مدينة بدقة.
وقد وُصفت هذه التقنية على النحو الآتي:
“تعتمد قوة المنهج القصدي في اختيار العينات على انتقاء أفراد يمتلكون معلومات غنية وملائمة لإجراء مقابلات معمقة. من خلال هذه العينات، يمكن للباحثين الحصول على رؤى مهمة حول القضايا المحورية المرتبطة بأهداف البحث. وغالبًا ما تُستخدم هذه العينات في المقابلات المعمقة أو عبر ملاحظات نوعية. ولا يوجد عدد محدد مسبقًا لحجم هذه العيّنات، إذ تعتمد أساسًا على مبدأ المرونة” (Layder، 2013: ص 87).
وقد تم تطبيق مجموعة الأسئلة المفتوحة على المشاركين، وبعد إجراء المقابلات المعمّقة، خضعت البيانات لتحليل ثنائي باستخدام برنامج MAQKUDA لتحليل البيانات النوعية. حيث تم أولًا تصنيف البيانات الخام حسب تكرار الكلمات، ثم أجري تصنيف ثانوي من خلال الرموز (الكودات) والرموز العليا المستخلصة من المقابلات، وتم تحويل نتائج التحليل إلى مخططات تحليلية.
أما التفسير والتحليل المفاهيمي، فقد بُنيا بالاستناد إلى هذه المخططات.
النتائج الميدانية: غازي عنتاب – أفيون
تم تصنيف بيانات البحث الميداني في كل من المدينتين (غازي عنتاب وأفيون) على شكل رموز (كودات)، ثم جُمعت هذه الرموز تحت رموز عُليا وفقًا لمستويات التحليل.
وقد تم توليد هذه الرموز والرموز العليا بالاستناد من جهة إلى الكلمات التي تم تكرارها بشكل بارز في المقابلات، ومن جهة أخرى إلى المفاهيم التي برزت أثناء مراجعة الأدبيات العلمية ذات الصلة.
وكان الهدف من تصنيف الكلمات إلى رموز، ومن ثم تحليلها، هو الانتقال من الرموز البسيطة إلى مفاهيم مجردة وبناء إطار نظري يساعد على تفسير الظواهر الملاحظة.
ولأغراض الخصوصية والحفاظ على سرية المشاركين، تم منح كل مشارك رمزًا خاصًا.
في غازي عنتاب، استُخدمت الرموز بالشكل الآتي: GK 1، GK 2، GK 3، حيث يشير G إلى غازي عنتاب، وK إلى “Katılımcı” (المشارك).
وبنفس الطريقة، في مدينة أفيون، تم استخدام رموز بالشكل: AK 1، AK 2، AK 3، حيث ترمز A إلى أفيون، وK إلى المشارك.
أولاً: تصورات الأتراك عن العلاقات الأسرية السورية:
أظهرت المقابلات الميدانية تمركزًا فكريًا ملحوظًا في إجابات المشاركين فيما يخص مواقفهم من السوريين، حيث يتجلى ذلك من خلال الكلمات والمفاهيم المرتبطة بـ”المرأة”. ويبدو أن صورة “الاختلاف” تجاه السوريين بُنيت إلى حد كبير من خلال المرأة السورية (ينظر الشكل رقم 1).

الشكل رقم (1) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بالأسرة السورية في مقابلات غازي عنتاب
وقد تكررت الإشارات إلى لباس المرأة السورية، وأدوارها داخل المنزل، وعلاقاتها مع زوجها وأطفالها، ومكانتها في سوق العمل (سواء بالمشاركة أو الغياب عنها)، إضافة إلى مدى تمكُّنها من اللغة ومستوى اندماجها.
على سبيل المثال، المشارِكة GK15، والتي تُبدي عمومًا موقفًا إيجابيًا تجاه اللاجئين، تقول: “كان هناك انزعاج واضح لدى سكان غازي عنتاب من مظهر النساء السوريات، حيث اعتبروا أنه لو كنا نحن في نفس ظروفهم، لما فكرنا في التبرج (وضع المكياج والتزين) أو التسلية، بينما كُنّ جميعًا متبرجات للغاية، وهذا بدا غريبًا جدًا للناس. وإضافة لذلك فإن بقاء النساء السوريات خارج المنزل لساعات متأخرة وجلوسهن الطويل في الحدائق كان من بين الأشياء التي أبدى الأتراك انزعاجهم منها. لم يُنظر إلى ذلك على أنه اختلاف ثقافي، بل كان أمرًا غير مقبول”.
نفس الإشارة إلى التبرج والعناية بالمظهر تكررت في أقوال GK21 وGK22، حيث أضافت الأخيرة أن إحدى النساء السوريات قالت لها: “أنتم النساء التركيات تهتممن كثيرًا بتنظيم بيوتكن، لكن لا تهتممن بأزواجكن. بالنسبة لنا، رضا الزوج والعائلة أولى من ترتيب البيت”.
وتشير العديد من النساء اللواتي تمت مقابلتهن إلى هذا الأمر بنوع من التذمّر، حيث يعتبرنه تهديدًا لمكانة المرأة التركية داخل الأسرة. كما أن اهتمام المرأة السورية بمظهرها ورضا زوجها، يُفسَّر أحيانًا على أنه يلفت أنظار الرجال الأتراك، مما يؤدي إلى إضعاف موقع المرأة التركية في حياتها الزوجية.
تُظهر هذه التكرارات اللغوية والمفاهيمية أن الصورة السلبية عن السوريين عند السكان المحليين تؤخذ في غالب الأحيان من خلال نظرة الأتراك إلى النساء السوريات.
أما على مستوى العائلة، فقد تكررت الإشارات إلى موضوعات مثل عدد أفراد الأسرة الكبير، والتجمعات العائلية، ونمط العيش الجماعي، واعتُبر ذلك تهديدًا لنموذج العائلة التركية.
أكثر المواضيع التي تم التطرق إليها هو تعدُّد الزوجات، والذي يُنظر إليه على أنه أضعف موقع المرأة التركية داخل الأسرة والمجتمع. إذ يُقال إن النساء السوريات، نظرًا للمعاناة التي تعرضن لها بسبب الحرب والنزوح، وأيضًا لاختلاف الثقافة، يلجأن للزواج من رجال أتراك كزوجات ثانيات، دون تكاليف مادية كبيرة، مما يؤدي إلى تراجع قيمة المرأة التركية في العلاقات الأسرية.
ورغم أن كلفة الزواج من امرأة سورية منخفضة، إلا أن الزواج بهن لا يخلو من أعباء إضافية، إذ إن الروابط العائلية القوية لدى السوريين تجعل من الطبيعي أن يزور أهل الزوجة السورية بيتها باستمرار، ما يخلق حالة من الاكتظاظ، كما عبّرت عن ذلك GK24 بقولها:
“الزواج من امرأة سورية لا يتطلب تكاليف كبيرة، أما الزواج من امرأة تركية فيتطلب مالًا وإجراءات كثيرة، ما يمنح المرأة التركية مكانة أقوى داخل الأسرة. أما المرأة السورية، فقلة التكاليف تضعف مكانتها بعد الزواج. لكنها أيضًا تُشكل عبئًا لأن عائلتها تبقى حاضرة بكثافة داخل الحياة الزوجية، كما أن تكرار زيارات عائلة المرأة السورية لبيت ابنتهم المتزوجة يسبب ازدحامًا دائمًا في البيت”.
أما GK13 فأكدت نفس الفكرة بقولها: “النساء السوريات يحرصن بشدة على كسب رضا الزوج، وعلى المحافظة عليه بأي ثمن”.
أوضح تجليات الصورة “الآخرية” المبنية عبر المرأة السورية هو التناقض الصارخ في المواقف تجاه الزواج بين الرجل التركي والمرأة السورية، مقارنة بالموقف تجاه الزواج بين الرجل السوري والمرأة التركية، حيث يتجلّى في هذا السياق رفض واسع ومباشر لهذا النوع من الزواج الأخير، رغم شيوع الأول.
فالمشاركات غير المتزوجات من النساء، مثل GK21 وGK22 وGK23، صرحن جميعًا أن الزواج من رجل سوري غير وارد على الإطلاق بالنسبة لهن. وفي مثال آخر، تشير GK19 إلى حالة في دورة لتعلم اللغات، حيث كان أحد الطلاب يتحدث التركية بطلاقة لدرجة أنه لم يُعرف على الفور أنه سوري، لكن عندما كشف عن هويته، بدأ زملاؤه يعاملونه ببرود، وكانت أشد ردود الفعل من الطالبات التركيات اللواتي كنّ صديقات له سابقًا، إذ بدأن يتجنبنه تمامًا.
وعندما سُئلت GK19 عن سبب هذا التحول، أجابت بأن الصورة الذهنية عن الرجال السوريين كـ”فارين من الحرب” قد تكون مؤثرة. لكن التفسير الأعمق يُشير إلى أن الصورة النمطية عن السوريين، كما تم تشكيلها بشكل جندري عبر المرأة السورية تم أيضًا تبنيها وإعادة إنتاجها من قِبل النساء التركيات أنفسهن، وهنّ في الغالب من يشكّلن حاملات ومكونات هذا التصور السلبي.
وفيما يتعلق بـالأطفال، تركّزت التصورات في الغالب على معدل الولادات المرتفع لدى السوريين، وما يُفترض أنه تهديد للتوازن السكاني. فعلى سبيل المثال، ذكرت GK14، وهي مديرة في مؤسسة حكومية، أن العدد الكبير من الأطفال بين السوريين نتيجة الحرب والنزوح قد يشكل تهديدًا لتركيا.
كما طُرحت قضايا مثل عدد الأطفال في الأسر السورية، ومدى اندماجهم مع الأطفال الأتراك في الشوارع والمدارس، ومستوى إتقانهم للغة التركية ضمن هذا السياق.
لكن البيانات المتعلقة بالأطفال جاءت متباينة. فالمشارك K4، وهو مدرس لغة تركية في مدرسة بحي فقير، ذكر أنه لا توجد مشاكل في الاندماج بين الأطفال السوريين والأتراك في مدرسته، وأن الأطفال السوريين يتحدثون التركية بطلاقة. وقال: “أنا أعمل في الزراعة والتدريس في ريف غازي عنتاب، وأتعامل كثيرًا مع اللاجئين. معظم طلابي السوريين وُلدوا هنا، وهم أصدقاء مقربون من الطلاب الأتراك، ولا توجد تفرقة في المدرسة أو في ساحتها. لم نعد نرى ذلك الفصل الذي كنا نشهده في بداية مشواري المهني. لا يوجد تكتلات. أحد أهم الأسباب هو أن الجيل الجديد من السوريين يتحدث التركية بطلاقة، حتى أننا لا نستطيع تمييزهم من أسمائهم فقط. بعض الأطفال يتحدثون التركية بطلاقة كأنهم تلقوا تعليمًا عاليًا بها. ورغم أن أهلهم يتحدثون العربية في المنزل، إلا أنني لم ألحظ أي ضغوط عليهم لمنعهم من التحدث بالتركية. في الواقع، الأطفال أنفسهم يعملون كمترجمين لذويهم عندما يأتون إلى المدرسة”.
في المقابل، أشار مشاركون آخرون – مثل GK19 وGK21 وGK22، وجميعهم من أحياء فقيرة – إلى انعدام التفاعل بين أطفال السوريين والأتراك في الشارع، مؤكدين أن الأطفال لا يلعبون مع بعضهم البعض.
بينما يرى آخرون أن الأطفال هم الفئة الأكثر نجاحًا في التفاعل والتكيُّف وتعلم اللغة. أما GK7، وهي من سكان حي “بيريلي كايا” الذي يشهد اختلاطًا بين السوريين والأتراك، فترى أن مستوى التفاعل بين الأطفال محدود، وقالت:
“أعتقد أن التفاعل بين السوريين والأتراك في حي بيريلي كايا ضعيف. الأطفال لا يلعبون مع بعضهم، ولا توجد علاقات جوار قوية. ولو كانت موجودة، لرأينا أثرها في تحسن اللغة مثلًا، هناك بعض الأطفال يتحدثون التركية بشكل جيد لكن عمومًا النساء والأطفال في هذا الحي يتحدثون التركية بمستوى متدنٍ جدًا”.
وعليه، ورغم وجود مؤشرات إيجابية في بعض الحالات، فإن التكرار العالي للإشارات إلى “المسافة الاجتماعية” بين الأطفال السوريين والأتراك يستدعي أخذ هذا الموضوع بجديّة، خاصة باعتباره مؤشرًا مبكرًا على نمط العلاقات المستقبلية بين المجتمعين.
في حالة أفيون، تشير المقابلات إلى قلة تكرار الكلمات المرتبطة بمفاهيم الأسرة والنساء والعائلة، فهي تعكس أن المشاركين لا يملكون تصورات راسخة أو تجارب كافية حول هذه القضايا. (ينظر الشكل رقم 2)

الشكل رقم (2) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بالأسرة السورية في مقابلات أفيون
ورغم ذلك، ظهرت في بعض الحالات بيانات مشابهة لتلك التي وُثّقت في غازي عنتاب. فعلى سبيل المثال، قالت إحدى المشاركات من أفيون، وهي AK1:
“النساء فعلاً أنيقات للغاية. أنا بالكاد أفتح عيني في الصباح، وهنّ ينهضن بكامل مكياجهن!”
ومع ذلك، فإن تكرار استخدام رمز “الأطفال” يشير إلى استمرار الصورة النمطية المتداولة في تركيا عن السوريين بأنهم “ينجبون كثيرًا”.
أما رمز “المرأة”، فيعكس تصورات بأن المرأة السورية ليست ذات مكانة مركزية في العائلة أو المجتمع. في حين تشير الرموز الأقل تكرارًا، مثل تعدد الزوجات والزواج كزوجة ثانية، إلى أن الصور النمطية حول المكانة الثانوية للمرأة السورية بدأت تُعاد إنتاجها محليًا في أفيون.
كذلك يشير ارتفاع تكرار مفردة “الأطفال” إلى التصورات التركية عن ارتفاع معدّل الإنجاب لدى السوريين، والذي ينظر له بسلبية عموماً.
على سبيل المثال، قالت AK2:
“معدل إنجابهم مرتفع جدًا، ولهذا صاروا في كل مكان. لدي أخ من هاتاي يقول: لم أعد أرى من يشبهني في الأماكن التي أذهب إليها. نحن الأتراك لا ننجب الكثير من الأطفال – طفلين أو ثلاثة بالكاد. أما هم، فللأسف، لديهم الكثير من الأطفال وأعدادهم تكبر بسرعة. لقد بدأوا يخرجون من وضع الأقلية، وهذا أمر مقلق. لأنهم، حينما يشعرون أنهم لم يعودوا أقلية، يبدأون بالمطالبة بالحقوق”.
كما قالت AK4:
“لا أرى أي تأثير إيجابي. إنهم لا يتوقفون عن الإنجاب. يسعون للتكاثر. ليس لديهم همّ لأنهم لا يحصلون على المال من هنا، بل هناك قوى خارجية تدفع لهم من أجل إبقائهم هنا. لهذا يختارون الإنجاب كوسيلة للبقاء”.
من جهتها، عبّرت AK10 عن قلة خبرتها بتعاملها مع أطفال سوريين من خلال وصفها التالي:
“كانوا مؤدّبين ومحترمين للغاية، حتى في تصرفاتهم حين يقتربون مني… كان لدي طلاب سوريون من الذكور أيضًا. لا زال أحدهم يتابعني على إنستغرام. كانوا أطفالًا طيبين، مجتهدين، مؤدبين وذوي خلق. كنت أقول لطلابي الأتراك: انظروا، هذا الطفل أفضل منكم. وكان عندي طفل أفغاني، ذكي للغاية، تعلم التركية بسرعة وبشكل ممتاز.”
يُلاحظ هنا أن نية الباحث في السؤال كانت موجهة لفهم أوضاع الأطفال داخل الأسر السورية، لكن المجيبة انحرفت بالإجابة نحو تجاربها مع شباب سوريين في الجامعة أو السكن، ما يدل على فقر الخبرة المباشرة مع العائلات السورية في أفيون.
يتضح من هذه العبارات أن السرديات المرتبطة بالتهديد الديموغرافي والتكاثر المفرط تشكل جوهر التصور السلبي في أفيون. وهي لا تنطلق من معايشة مباشرة، بل تتغذى من خطابات وطنية أوسع (الخطاب الوطني العام) يتم إسقاطها محليًا، رغم غياب المقومات العددية أو الواقعية التي تدعمها.
ثانياً: تصورات الأتراك عن العلاقات الاجتماعية السورية:
تتناول الرموز ضمن هذا المحور كيف تتشكّل صورة السوريين في مخيلة سكان غازي عنتاب فيما يتعلق بحركتهم في الحياة الاجتماعية، وكيفية تصرفهم عند مواجهة المشكلات، سواء كأفراد أو كمجموعات، وما انعكاسات هذه التصرفات على السكان المحليين. (ينظر الشكل رقم 3)

الشكل رقم (3) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بالسلوكيات الفردية والجماعية في مقابلات غازي عنتاب
من خلال تصنيف وتكرار المفردات المستخدمة في المقابلات، تبيّن أن أكثر الكلمات تكرارًا كانت “الازدحام” أو “الكثافة”. وهذا المفهوم يشير من جهة إلى الكثافة العددية للسوريين ضمن سكان المدينة، ومن جهة أخرى إلى حالة الازدحام في الأماكن العامة كالشوارع، ووسائل النقل، والحدائق، والمستشفيات، والمدارس، والتي تسبب شعورًا بعدم الارتياح لدى السكان الأتراك.
على سبيل المثال، قالت GK5: “كان ذلك دائمًا يزعجني؛ أن يأتي خمسة أشخاص مع مريض واحد في المستشفى ويحتلوا المكان بينما يبقى مرضى آخرون واقفين.. ثم في المطاعم والمراكز التجارية، في كل مكان… كنت أراهم وأشعر برد فعل سلبي أولًا، ثم أحاول أن أضبط نفسي بدافع من تعاليم ديني التي تدعو إلى احتضان الجميع، لكن أكثر ما كان يزعجني هو قلة احترامهم لمكانتهم كضيوف. الضيف يجب أن يعرف حدوده”.
في هذا السياق، تظهر كلمة “الفوضى” كمفهوم ملازم للازدحام، حيث ترتبط الكثافة العددية بغياب التنظيم والالتزام بالقواعد، الأمر الذي يثير القلق بين السكان المحليين، ويؤدي إلى ربط ذلك بـالجريمة أو التصرفات الجماعية المهددة. وكلمة “الفوضى” هي كلمة توحي بمعنى سلبي، وعندما تأتي عند الحديث عن السوريين تلصق فيهم صورة نمطية سلبية.
أما استخدام كلمة “جماعي” أو “جماعات” فيجب أيضاً عدّها كلمة ذات طابع سلبي، وهي تتجاوز المعاني السابقة وتعكس تصورًا بأن السوريين لا يتصرفون كأفراد، بل كمجموعات. يُشار إلى أنهم يتحركون ويعيشون ضمن تشكيلات جماعية في كل مناحي الحياة: في المشاجرات، في المستشفيات، في الحدائق، في الأسواق.
وفي هذا السياق، قالت GK15:
“يمكنهم جمع أنفسهم بسرعة. في المشاجرات، يمكن أن تتحول قضية بسيطة إلى شجار كبير جدًا خلال دقائق. شاهدت مشاجرات تحولت في لحظات إلى تجمعات من 50 أو 60 شخصًا، وكلهم من السوريين. لو كانت المشاجرة بين أتراك، فلن يتعدى الأمر شخصين أو ثلاثة، ولن يكبر الشجار إلى هذا الحد في لحظات. ما يحدث مع السوريين هو شجار بين مجموعتين وليس بين شخصين. يمكن أن ينتشر الخبر عبر واتساب، وخلال دقائق يتجمع العشرات، وهذا أمر مقلق ومخيف. هذا السلوك الجماعي يزعج الناس هنا. لأننا – نحن أهل عنتاب – لا نتصرف بهذه الطريقة. أنا شخصيًا لا يمكن أن أتصرف بهذه الطريقة أبدًا”.
ويبدو أن هذه الصورة النمطية عن السوريين كمجموعات صاخبة وخطيرة تحمل نوعًا من المصداقية في نظر بعض المشاركين لسببين رئيسين؛ الأول: الأصل الاجتماعي والجغرافي: فغالبية السوريين الذين هاجروا إلى غازي عنتاب ينحدرون من مناطق ريفية وعشائرية في سوريا، حيث الثقافة الجماعية والحياة ضمن بنى القرابة هي السائدة. ووفقًا لـ GK17، فإن نحو 70–80% من السوريين في غازي عنتاب ينتمون إلى هذه الخلفيات العشائرية. والثاني هو: ظاهرة الغيتو (Getto): كحال كثير من مجتمعات اللاجئين في العالم، يلجأ السوريون إلى العيش ضمن تجمعات متقاربة لتوفير نوع من الحماية في بيئة غير آمنة. وهذا يؤدي إلى تشجيع الحركة والتصرف الجماعي بدلًا من الفردي.
كلا العاملين يُسهمان في إنتاج صورة جماعية عن السوريين في المخيال المحلي، ويعززان شعورًا بالتهديد لدى السكان الأتراك، لا سيما في سياق المقارنة بثقافتهم الحضرية التي تُمجّد السلوك الفردي والمنضبط.
يجب النظر إلى غياب استخدام مصطلح “الفرد” في هذا السياق على أنه مرتبط بانعدام الفردانية في صورة السوريين المتداولة محليًا. فهناك علاقة عكسية بين الفردانية وبين السلوك الجماعي؛ فكلما ضعف تصوّر الفرد السوري ككائن مستقل، زادت الصورة النمطية عنه كجزء من جماعة متحركة جماعيًا.
ومع ذلك، فإن هذه الصورة لا تنطبق على النخبة من السوريين، إذ تُستثنى عادة من هذه التصورات. على سبيل المثال، تذكر GK6 – التي تعيش بجوار عائلة سورية تنتمي إلى شريحة ميسورة – أن علاقتها بهم كانت طيبة:
“علاقتي بجيراني بسيطة. المرأة تعيش في تركيا منذ سنوات، منذ عام 2013، لكنها لا تتحدث التركية حتى الآن. أبناؤها يتقنون اللغة، لكن الوالدين لا يفهمانها. بعض أولادهم يعيشون في أنطاكيا، والبعض في عنتاب. علاقتنا طيبة، يطرقون بابي ويسألون عني، وإذا حضروا إلى محلي – الذي يقع مقابل بيتهم – يُحضِرون معهم طعامًا”.
ذات مرة، جاءت الأم مع ابنتها، وكانت البنت تترجم للأم. أخبروني أنهم يتعرضون للإزعاج من سكان البناية، إذ يدّعون أنهم كانوا يطبخون في الحمام مثلاً، وهناك رجل مُسنّ يضايقهم باستمرار. قال إنهم أربعون شخصًا يعيشون في البيت، لكنني دخلت البيت بنفسي ولم أرَ ذلك. رأيت الجد والجدة، وابنًا وابنة فقط. صحيح أن هناك حركة كثيرة في البيت، وزيارات من الأبناء والأحفاد، لكن الأمر لا يتعدى ذلك. لديهم ثقافة ترك الأحذية خارج الباب، واشتروا خزانة للأحذية يضعونها في الممر. زرتهم أيضًا بعد الزلزال لأطمئن على الأم. هم أناس مرتبون جدًا. أسكن في حي (فوزي تشاكماك)، وهم من ذوي الدخل المرتفع، ومتعلمون، وكلهم خريجو جامعات. رأيت صالون بيتهم، وكان مرتبًا للغاية”.
أما GK20، وهو مهندس معماري، فقد تحدث عن تجربة عمله مع معماري سوري معروف من حلب:
“جاء إلينا أحد أبرز المعماريين في حلب، مع مساعده. كان أول مكتب يعملان فيه هو مكتبنا – أنا ووالدي. كنا مشغولين حينها، لكنه كان معماريًا مميزًا، صمم مباني شهيرة في حلب. جاء إلى عائلتنا كما لو كانوا عائلة ملكية: يتحدثون الفرنسية والإنجليزية، وأحضروا معهم حتى خادمتهم الإندونيسية. لم يكن معهم شيء حين غادروا حلب، وكانوا بحاجة إلى عمل. عرضنا عليه وظيفة، وقلنا له إننا لا نستطيع أن نقدم له ما كان يحصل عليه في حلب، لكننا عرضنا عليه راتبًا يعادل ضعف المتوسط المحلي. عملنا معهم سنوات، وصرنا كعائلة واحدة. ساعدنا أولاده في الحصول على منحة للدراسة في مدرسة إنجليزية. ثم حصل على عرض في المغرب لبناء قصر ملكي، براتب عالٍ، فانتقل هناك. أولاده بدأوا دراسة طب الأسنان في إسطنبول، وأمه كانت تركية الأصل من إسطنبول، وكان يجب أن تكون في موقع أعلى من زوجة الابن، كما يقول التقليد”.
ومن الملاحظ أن السرديات السلبية لا تُطبّق غالبًا على السوريين من النخبة، بل تظهر تجاه الفئات الفقيرة أو الأقل اندماجًا.
في أفيون، تجتمع الرموز التي تعبّر عن التصورات المبنية على التجربة والسردية في آنٍ واحد. (ينظر الشكل رقم 4)

الشكل رقم (4) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بالسلوكيات الفردية والجماعية في مقابلات أفيون
كلمة “جماعي” تعكس تجربة مباشرة؛ فهي تُستخدم لوصف رؤية مجموعة من الأشخاص تتحرك سويًا في الأماكن العامة كالشوارع، الحدائق، المستشفيات، وغيرها. لكن قلة تكرار هذا المفهوم تشير إلى ندرة هذه التجربة في أفيون، حيث لا توجد مشاهد متكررة لحركة جماعية للسوريين في الفضاء العام.
أما تكرار رمز “الازدحام” فهو لا يُستند إلى تجربة فعلية، بل إلى خطاب سائد أو تصور سردي. إذ إنه وبحسب الواقع، لا توجد كثافة عددية للسوريين في أفيون.
ويؤكد هذا المعنى ما قالته AK3:
“يلفتون الانتباه من خلال ملابسهم الداكنة، وطريقتهم في الحديث، ونبرة الصوت العالية. في بعض الحدائق، خاصة في المناطق التي يسكنون فيها، كانت هناك فترات شهدت ازدحامًا مكثفًا، ما دفع الناس إلى التردد في اصطحاب أطفالهم إلى تلك الأماكن”.
وهذا يدل على أن التصور المنتشر في أفيون حول السوريين هو في الغالب انعكاس للسردية الوطنية العامة، وليس مبنيًا على احتكاك مباشر واسع.
وينطبق الأمر ذاته على مصطلحات مثل “الشجار” و”الفوضى”، فهي تصورات مستعارة من الخطاب الإعلامي أو الاجتماعي السائد، وليست مبنية على تجارب واقعية في أفيون، لأن عدد السوريين هناك محدود، ولا يتيح فرصة لظهور مشاهد عنف جماعي تلفت انتباه السكان المحليين.
أما مصطلح “الاحتلال”، فقد استُخدم لقياس درجة الشعور السلبي تجاه الوجود السوري، لكنه لم يكن متكررًا بشكل لافت. ومع ذلك، فقد ورد بشكل صريح في بعض المداخلات[2].
ثالثاً: تصورات الأتراك عن التفاعل المجتمعي بين السوريين:
رغم أن مصطلح “الضيف” لم يُستخدم على نطاق واسع، إلا أن من استخدموه كانوا في الغالب من العائلات الثرية والعريقة في مدينة غازي عنتاب، والذين يتمتعون بدرجة عالية من الوعي والانخراط في الشأن العام. ويبدو أن هذا التوصيف نابع من موقعهم كمكون رئيسي في تشكيل الرأي العام المحلي. (ينظر الشكل رقم 5)

الشكل رقم (5) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بالتفاعل المجتمعي بين السوريين في مقابلات غازي عنتاب
على سبيل المثال، تقول GK5، وهي من عائلة محلية معروفة:
“عندما نتحدث عن السوريين، فكّر بالأمر كما لو أن رب الأسرة قد جلب ضيفًا إلى البيت، وبقي هذا الضيف لفترة طويلة، وأحضر معه زوجته وأطفاله، وكل من ينتمي إليه. ولا يمكن لبقية أفراد الأسرة الاعتراض على وجوده. أهل غازي عنتاب لا يملكون خيار رفض الضيف. لا بد من قبوله، والسعي لتنظيم علاقة مشتركة تضمن أجواء أكثر راحة”.
على الرغم من وجود آراء مختلفة في شرائح أخرى حول كون السوريين أصبحوا جزءًا من المدينة أو يجب إعادتهم إلى بلادهم، فإن مواقف هذه الفئة المؤثرة غالبًا ما تكون حاسمة ولها تأثير طويل الأمد في تشكيل السياسات والمزاج العام. ((Zaller, 1992
أما مصطلح “التحوّل إلى مجمعات منفصلة” (Gettolaşma) فقد ورد بشكل أكثر تكرارًا، ويعبّر عن إحساس منتشر لدى سكان غازي عنتاب بوجود تهديد بنيوي في المدينة ناتج عن السوريين.
فقد قال GK1:
“في بعض المناطق التجارية، هناك ظاهرة “غيتو” بين السوريين، فهم نادرًا ما يشترون من متاجر غير متاجرهم الخاصة”.
أما GK20 فقد أشار إلى أبعاد عمرانية وتعليمية لهذه الظاهرة، فقال:
“افتُتحت مدارس خاصة لأبناء السوريين، وكان معظمها في الأحياء الطرفية، ثم صدر قرار دمج الأطفال السوريين في المدارس التركية. مدينة غازي عنتاب هي أصلًا من المدن ذات أسعار العقارات المرتفعة سواء للبيع أو الإيجار، لكن بعض المالكين استغلوا الوضع وأصبحوا يؤجرون بيوتًا كانت تُؤجر بـ 1000 ليرة، بسعر 2000 أو 3000 ليرة للسوريين. هذه الأسباب دفعت السوريين إلى الانتقال إلى الأحياء الطرفية، مما أدى إلى ظهور “غيتوهات” جديدة. ثم جاء التحدي الأكبر في المدارس، حيث كان من الصعب على مدارس الدولة أن توازن بين الطلاب الأتراك الذين بالكاد يحصلون على تعليم جيد، وطلاب سوريين غير متمكنين من اللغة أو مندمجين بشكل كافٍ”.
وهكذا، فقد تشكّل في أذهان كثير من سكان غازي عنتاب تصوّر بأن السوريين ينشئون اقتصادات مغلقة داخلية (لا يشترون من الأتراك، بل يتعاملون مع بعضهم فقط)، ويتفاعلون اجتماعيًا فيما بينهم فقط، ويُظهرون مقاومة ضد تعلّم اللغة التركية، ويميلون للانعزال المكاني عبر تركّزهم في أحياء معيّنة. كل ذلك عزز الصورة الذهنية عن وجود “غيتوهات سورية” في المدينة، اعتُبرت من قِبل السكان المحليين مصدرًا للقلق والتوتر الاجتماعي والاقتصادي.
في أفيون، يُلاحظ أن مصطلح “التسوّق”– والذي يعكس خبرة مباشرة – يُستخدم بنسبة منخفضة، مما يدل على محدودية التفاعل العملي بين السكان المحليين والسوريين. (ينظر الشكل رقم 6)

الشكل رقم (6) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بالتفاعل المجتمعي بين السوريين في مقابلات أفيون
ومع ذلك، فإن مصطلحات مثل “التحوّل إلى مجمعات منفصلة” (Gettolaşma)، و”اللغة”، و”التواصل” – التي تُعدّ من الركائز الأساسية للسردية الوطنية العامة حول السوريين في تركيا – قد ظهرت بكثافة عالية في بيانات المشاركين من أفيون.
لكن من اللافت أن بعض التصريحات، رغم ظاهرها الإيجابي، تُعبّر عن فهم مشوَّش أو غير دقيق للواقع.
على سبيل المثال، تقول AK10:
“الأطفال يتعلمون اللغة التركية بشكل ممتاز. حتى إنهم يترجمون لأمهاتهم عندما نريد قول شيء. الأم تنادي الطفل، والطفل يترجم بشكل رائع. لقد تعلموا التركية بشكل جيد، وتمكّنا من غرس ثقافتنا فيهم بشكل جيد. هؤلاء الأطفال لو تُركوا لنا، فسيكبرون وكأنهم أتراك. هذا مكسب كبير برأيي”.
ورغم هذا التصور الإيجابي، تعود نفس المشاركة وتعبّر عن إحباط من عدم تعلّم بعض السوريين للغة التركية، فتقول:
“بعضهم لا يعرف كلمة واحدة بالتركية، رغم أنهم يعيشون هنا منذ 5 إلى 10 سنوات. وهذا أمر أستغربه جدًا؛ كيف يعقل أن يعيش أحدهم هنا كل هذه السنوات ولا يتحدث التركية؟ لا أستطيع حتى التواصل معهم”.
أما AK5، فقد ربط بين الاندماج السكاني والتحوّلات العددية والديموغرافية، فقال:
“في البداية، كان السوريون أقلية وكانوا أكثر اندماجًا، لكن مع الوقت، ومع تزايد عددهم، بدأوا يتصرفون وكأنهم الأغلبية وأصبحوا يتصرفون وفق عاداتهم وتقاليدهم دون الحاجة للاندماج مع الثقافة التركية.
وفي السياق ذاته، أشارت AK13 إلى أن التمركز المكاني للسوريين في أحياء مُعيّنة ناتج عن عوامل بنيوية في سوق العقارات، فقالت:
“أعتقد أن بعض السوريين يتمركزون في أحياء معيّنة في أفيون. هذا ليس دائمًا خيارًا ذاتيًا، بل بسبب رفض بعض أصحاب العقارات تأجير منازلهم للسوريين. وبالتالي، يتجمع السوريون في مناطق محددة حيث يتم قبولهم كمستأجرين. ونتيجة لذلك، تظهر متاجر ومطاعم تبيع ما يستهلكه السوريون. هذا التمركز يثير انزعاج بعض السكان، لكن السبب الحقيقي هو نظام العقارات نفسه”.
يتضح من ذلك أن سكان أفيون، رغم ندرة التفاعل الفعلي مع السوريين، قد تبنّوا سردية وطنية عامة تجاههم، تتحدث عن: التمركز الجغرافي أو ما يُعرف بـ”التحوّل إلى غيتو”، وضعف تعلم اللغة التركية، والانغلاق الثقافي والاجتماعي.
ولذلك يمكن القول إن بيئة أفيون تُشكّل حالة نموذجية لقياس مدى تأثير السردية الوطنية التركية حول السوريين في المناطق ذات التفاعل المحدود، فهي مدينة لا تعرف السوريين من خلال تجربة مباشرة، بل من خلال خطاب عام تُعيد إنتاجه بشكل تلقائي، مما يجعلها “متلقّيًا خالصًا” لهذا السرد.
رابعاً: تصورات الأتراك عن قواعد الحياة الاجتماعية لدى السوريين:
من أبرز النقاط التي أشار إليها سكان غازي عنتاب – من خلفيات اجتماعية مختلفة – في حديثهم عن اللاجئين السوريين، هي أن السوريين لا يلتزمون بالقواعد التي تجعل الحياة المشتركة ممكنة في الفضاء العام أو المشترك، سواء كان ذلك في الشارع، الحديقة، العمارة، المستشفى، أو وسائل النقل. (ينظر الشكل رقم 7)

الشكل رقم (7) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بالالتزام بقواعد الحياة الاجتماعية في مقابلات غازي عنتاب
وقد تمحورت الانتقادات حول عدم احترام السوريين لما يُعرف بـ”قواعد السلوك المجتمعي”، وهي قواعد لا تفرضها القوانين رسميًا لكنها ذات أهمية كبيرة في الثقافة التركية. ومن بين هذه القواعد:
- الحفاظ على نظافة الشارع والحديقة.
- وضع الأحذية خارج باب الشقة في العمارات.
- احترام قواعد المرور، ونظام الجلوس في الحدائق.
- الالتزام بالدور في المستشفيات، الحافلات، وأجهزة الصراف الآلي.
- التصرف بسرعة في الأماكن العامة كأماكن سحب النقود، دون التسبب بتأخير الآخرين.
وقد سبق أن ذكرت شهادة GK5 حول عدم التزام السوريين بنظام الطابور في المستشفيات. أما GK20، فقد قدّم تجربة شخصية شديدة الدلالة، قائلاً:
“في الطابق الثالث من المبنى الذي نقيم فيه، اشترت عائلة سورية شقة. حوّلوا غرفة الجلوس إلى مطبخ، وربطوا أنبوب تصريف المطبخ مع أنبوب تصريف مياه الأمطار. أما غرفة النوم – التي تقع فوق مكان وقوف سياراتنا – فقد جعلوها مطبخًا أيضًا، وكانوا يرمون زيت القلي مباشرة من النافذة على سياراتنا. لا أعرفهم ولا أريد التعرف عليهم. بسبب ما فعلوه، انسد خزان الصرف الصحي في البناية، وتسرّب الماء القذر إلى شقتي. اضطررنا إلى تنظيف 30 سم من مياه الصرف، والروائح الكريهة كانت لا تُحتمل. كيف لي أن أعيش في عمارة مع أناس يرمون زيت القلي من الطابق الثالث؟ إن استمر الوضع هكذا، سأفضّل مغادرة البناية”.
وأورد مشارك آخر كيف أن إحدى العائلات السورية قامت بتبديل وظائف الغرف داخل الشقة، فحوّلوا المطبخ إلى غرفة نوم وغرفة النوم إلى مطبخ، مما أضرّ براحة الجيران وسبب توترًا داخل المبنى.
أما مصطلح “الرقابة” (denetim)، فقد استُخدم في اتجاهين:
أولًا: في سياق الدعوة إلى فرض رقابة أكثر صرامة على المخالفات السلوكية في الفضاء العام، كرمْي القمامة أو الإخلال بنظافة الأحياء.
ثانيًا: في السياق الاقتصادي، حيث عبّر بعض المشاركين عن استيائهم من العمل غير الرسمي، والتهرب من الضرائب، وعدم المساواة في شروط المنافسة بين السوريين والأتراك.
وفعلًا كان هناك الكثير من السوريين الذين وقعوا بالخطأ في تصرفات غير قانونية في التجارة إما بسبب قدومهم من نظام ضريبي مختلف، أو بسبب تعقيد المعاملات في المؤسسات الحكومية التركية.
وأشار GK24، وهو رجل أعمال، إلى أن السوريين – خاصة القادمين من حلب – يجدون صعوبة في التأقلم مع النظام الضريبي التركي، موضحًا:
“في حلب، نظام الضرائب مختلف تمامًا. مقدار الضريبة يُحدد من قبل الموظف المسؤول، ولا توجد تفاصيل إجرائية مثل النظام التركي. لذلك عندما جاء السوريون إلى غازي عنتاب، واجهوا صعوبة في التكيف مع هذا النظام التفصيلي”.
لكن، رغم هذه التبريرات، فإن غضب السكان المحليين لم يتراجع، وظهر واضحًا في طلباتهم المتكررة من الجهات الحكومية لتكثيف الرقابة على الشركات السورية غير المسجلة ومحاسبتها.
مرة أخرى، تُظهر المصطلحات الواردة في بيانات مدينة أفيون أن التصورات السائدة حول السوريين هناك ليست نتاجًا لتجارب مباشرة، بل هي انعكاس واضح للسردية الوطنية العامة في تركيا حول اللاجئين السوريين. (ينظر الشكل رقم 8)

الشكل رقم (8) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بالالتزام بقواعد الحياة الاجتماعية في مقابلات أفيون
ويُشير تكرار هذه الرموز إلى مدى قوة الخطاب العام حول السوريين في تشكيل المواقف المحلية، حتى في غياب التفاعل الشخصي أو الاحتكاك الفعلي معهم.
وعليه، فإن التجربة الشخصية تُشكّل عاملًا كابحًا لقوة السردية، بحيث تعمل كـ”عدسة مفلترة” تضعف تأثير الخطاب العام. أما في غياب هذه التجربة – كما هو الحال في أفيون – فإن السردية يُعاد إنتاجها محليًا كما هي، وتؤثر بشكل مباشر على المزاج السياسي المحلي.
وقد انعكس هذا الوضع في نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة في أفيون، والتي تأثرت جزئيًا بالمواقف من قضية اللاجئين السوريين.
وفي هذا السياق، تُعبر كلمات AK8 عن حالة الانزعاج العام من السوريين، حيث قالت:
“عندما يدخلون في الحياة الاجتماعية، فإن سلوكهم يكون غير طبيعي على الإطلاق. يلفتون النظر بطريقة مبالغ فيها. ربما لهذا السبب تُطرح كل هذه الأبحاث والنقاشات حولهم. يخرقون القواعد، يقومون بأفعال تُفسد بنية المجتمع، نظرات الرجال للنساء… هناك الكثير من الأسباب”.
أما AK4 فقد تحدّثت عن الالتزام في سوق العمل، مشيرة إلى التناقض في التصورات:
“أنا أعمل بجد لأنني بحاجة إلى المال لأعيش. سمعت أنهم يعملون بجد أيضًا، لكن هل هم جديرون بالثقة؟ لا أستطيع الحكم. أما بخصوص الالتزام بساعات العمل، فأعتقد أنهم يلتزمون أكثر من الأتراك. لدي معرفة بذلك، لأن كثيرًا من السوريين والأفغان يُوظَّفون لأن الأتراك لا يُرضيهم العمل”.
أما AK9، فقد أبرزت كيف يمكن لموضوع الالتزام بالقواعد أن يتحول إلى خطاب تمييز وتفوق قومي، إذ قالت:
“يبدو أنهم يملكون الأولوية علينا. تذهب إلى الحديقة، يريدون أن يكونوا أول من يستخدم كل شيء. في وسائل النقل، لا ينهضون من المقاعد، ولا يحترمون أحدًا. أكثر ما يزعجني هو أنهم يتحدثون بالعربية أو أيًا كانت لغتهم”.
وتُشير هذه التصريحات إلى تصور ضمني بأن الأولوية في الاستفادة من الحقوق المدنية يجب أن تكون للمواطنين الأتراك، وأنه ينبغي على السوريين قبول موقع “ثانوي” في المجتمع.
خامساً: تصوّرات الأتراك عن الحياة المشتركة مع السوريين:
كانت المرافق العامة المشتركة من أبرز الموضوعات التي ركّز عليها المشاركون عند حديثهم عن اللاجئين السوريين، وتحديدًا كرمز أساسي لتصاعد المشاعر السلبية تجاههم. (ينظر الشكل رقم 9)

الشكل رقم (9) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بحياة المدينة المشتركة في مقابلات غازي عنتاب
من بين أكثر المصطلحات تداولًا في المقابلات الميدانية كانت النظافة والنفايات، وخاصة في الشوارع، والحدائق، والمباني السكنية، حيث تكررت شكاوى حول أن مطاعم السوريين لا تراعي شروط النظافة، وأنهم يرمون النفايات على الأرض أو يتركونها بجانب الحاوية بدلًا من وضعها داخلها، كما تم التذمر من روائح الطعام “الغريبة” الناجمة عن استخدامهم المفرط للتوابل.
قال GK1:
“كنت آكل في مطعم صغير في منطقة “سارغولوك”، فجاءت عاملة النظافة وسألتها لماذا النفايات مرمية بجانب الحاوية؟ فقالت: السوريون هم من يفعلون ذلك. سألتها: هل أنت متأكدة؟ قالت: والله، هم من يرمونها. قلت لها إنه ربما الأتراك من أبناء الريف هم من فعلوا ذلك، فقالت: أبناء الريف من الأتراك ليسوا قادرين أصلًا على السكن في هذه الأحياء. ثم روت لي حادثة تشاجرت فيها مع امرأة سورية عندما رمت كيس القمامة بجانب الحاوية، وعندما اعترضت عليها قالت لها: “عملك هو التنظيف، فلتنظفيه أنت”.
“هذا النوع من السلوك – أن تترك النفايات بجانب الحاوية – ينشر الأمراض ويؤثر على صحة أطفالنا… يجب وضع كاميرات بجانب حاويات القمامة في أحياء الطبقة الراقية التي يسكنها سوريون ميسورون، من أجل أن نرى من يضع القمامة بجانب الحاوية بدلًا من داخلها، ولتُتخذ إجراءات ضد من يفعل ذلك. في عيد الفطر الماضي، انتشرت مشاهد مماثلة في شارع إنونو”.
كما ذكر GK2، وهو تقني في شركة مقاولات، أن العمال السوريين في مواقع البناء يتركون بقايا الطعام دون تنظيف، ويستخدمون دورات مياه بشكل سيئ. وأضاف:
“يتناولون الإفطار ويتركون كل شيء خلفهم دون تنظيف. لاحظنا أيضًا أنهم يستخدمون زوايا البناء كدورات مياه، وهذا يسبب لنا مشاكل كبيرة”.
ووفقًا للبيانات، فإن مصطلحَي “النظافة” و”النفايات” من أكثر المواضيع التي أُثيرت عند سؤال السكان عن سبب امتناعهم عن تناول الطعام في مطاعم يديرها سوريون.
أما مصطلحات مثل “الشارع”، “الاستخدام”، “الانتشار”، “الكثرة”، و”التدخل”، فقد اجتمعت تحت تصور مشترك هو أن السوريين يحتلون المساحات العامة المشتركة، وقد ارتفعت حدة هذا التصوّر بعد نشر فيديو بعنوان “الغزو الصامت” عام 2023 على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي حصد ملايين المشاهدات.
رغم أن السوريين لا يرتكبون مخالفات أو جرائم بشكل مباشر في معظم الأحيان، إلا أن مجرد “ظهورهم الكثيف” وانتشار متاجرهم ومطاعمهم واستخدامهم المفرط للحدائق العامة يُؤطَّر في الذهنية الجمعية لسكان غازي عنتاب على أنه “استيلاء” على الأماكن التي كانت تُعدّ جزءًا من الهوية المحلية.
قالت GK13:
“لم نعد نستطع استخدام حدائقنا، بينما السوريون باتوا يستخدمونها بشكل مكثف، وخربوها. في مناطق مثل “بيريلي كايا” وفي كثير من أحياء غازي عنتاب، أصبحت كثافة السوريين ملفتة، وهناك نوع من الغيتوهات الواضحة”.
وأكدت GK20 أنها لا تملك علاقات مباشرة مع السوريين، لكنها أضافت أنه في حال وصولهم إلى أماكن سكنها أو عملها، فإنها ستغادر إلى مناطق “أكثر أمانًا” وخالية من السوريين.
أما GK22، والتي تعيش في حي شعبي مختلط، فقد أشارت إلى أن وجود مجموعات من الرجال والنساء السوريين في الشوارع وأمام المنازل خلق نوعًا من “الانسحاب الاجتماعي” للأتراك، الذين باتوا يتجنّبون قضاء أوقاتهم في تلك الأماكن.
بحسب تعبير سكان غازي عنتاب المحليين، فإن وجود مجموعات كبيرة من الناس يتحدثون بلغة مختلفة وبصوت مرتفع، ويحملون رموزًا ثقافية واجتماعية مغايرة، في الشوارع وسائر الأماكن العامة، يثير القلق والانزعاج.
ومن المهم التأكيد مرة أخرى أن هذه المخاوف لا يمكن اعتبارها مجحفة بالكامل، لا سيما إذا ما نظرنا إلى الخصائص الاجتماعية للمجموعات السورية اللاجئة. فالمشكلة لا تعود فقط إلى الاختلافات الثقافية في استخدام الفضاء العام، بل تتعلّق أيضًا بـنقص الخبرة الحضرية لدى معظم السوريين القادمين من مناطق ريفية في سوريا، مما أدى إلى سلوكيات قد تتعارض مع أنماط الحياة الحضرية لسكان المدينة.
وقد أظهرت تجارب إيجابية ذكرها بعض المشاركين مثل GK20 وGK2 وGK4 عند تفاعلهم مع سوريين من خلفيات حضرية، أن الصورة السلبية تتركّز أساسًا على القادمين من الأرياف.
وفي هذا السياق، أشار GK17، الذي يعيش في حي شعبي ويملك مركزًا لجمع النفايات الصلبة، إلى أن نحو 70% من السوريين المقيمين في غازي عنتاب ينتمون إلى خلفيات عشائرية، وهو ما يوضح الطابع الريفي-العشائري الغالب على اللاجئين في المدينة، ويُفسّر بعض التوترات في السلوك الاجتماعي.
في مدينة أفيون، ظهرت المصطلحات التي تحمل صورًا سلبية تجاه اللاجئين السوريين بشكل مماثل لما هو موجود في غازي عنتاب، رغم اختلاف الديناميكيات الاجتماعية والتجارب اليومية مع السوريين بين المدينتين. (ينظر الشكل رقم 10)

الشكل رقم (10) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بحياة المدينة المشتركة في مقابلات أفيون
يشير هذا التشابه اللافت إلى قوة السردية الوطنية التركية الموحدة حول السوريين، والتي تتجاوز الفوارق المحلية وتعكس تأثير الخطاب العام المنتشر على المستوى الوطني.
وقد جاءت تصريحات AK6 حول استخدام السوريين للحدائق العامة مثالًا واضحًا على انعدام التجربة المباشرة، ووجود غموض في التعبير يعود إلى تصورات مسبقة أكثر من كونه تجربة واقعية:
“أعتقد أنهم لا يشعرون بالانتماء إلى هنا، ولا يتصرفون كما لو كانت هذه بلادهم، ولذلك أراهم يتعاملون بفظاظة. لا أعتقد أنهم حساسون تجاه المرافق العامة مثل المواطن التركي، لأنهم لا يشعرون أنها ملكهم. في رأيي، لا يملكون الحق في استخدام الحديقة، لكنهم يستخدمونها. كيف دخلوا إلى بلدنا؟ لقد دخلوا بشكل غير شرعي. صحيح أن هناك حربًا ودمارًا، ويجب أن نساعد، لكن ليس أن نستقبلهم جميعًا. لماذا أغلقت الدول الأخرى حدودها ونحن فتحناها؟ أنا أحمّل بلدي المسؤولية”.
تعكس هذه التصريحات عدة رموز: نزع الشرعية، غياب الانتماء، الغزو، استخدام غير مشروع للمساحات العامة، وهي رموز تُشكّل فروعًا ضمن البنية العامة لسردية “السوري الغريب”، التي غالبًا ما تتكرر حتى لدى من لم يحتكوا فعليًا مع السوريين. ويمكن افتراض أنه لو طُرح نفس السؤال في مدن أخرى كـغيرسون أو كارامان أو أي مدينة تركية، فإن الردود ستكون مشابهة إلى حد بعيد.
لكن، كما نوقش في أجزاء سابقة من البحث، فإن هذه الرموز ليست بالضرورة مفصولة تمامًا عن الواقع. بل ترتبط أيضًا بعدة عناصر موضوعية مثل الاختلاف الثقافي، الطابع الريفي لكثير من السوريين، والكثافة السكانية العالية.
فقد علّقت AK1 على الامتيازات في المرافق العامة قائلة:
“السوريون يحصلون على فرص أفضل منا، في المركز الصحي، يدخلون قبلي، في البنك، يحصلون على الدور أولًا، في المستشفى، كذلك، لديهم نوع من الأولوية، فقط لأنهم “لاجئون”[3].
في السياق ذاته، تناولت AK9الأمر من زاوية الصحة العامة:
“من حيث التأثير السكاني، الوضع سلبي، كوني أعمل في المجال الصحي، لاحظت انتشار أمراض لم تكن موجودة سابقًا، كما ظهرت برامج تطعيم جديدة. هذه الهجرة الضخمة لها آثار صحية وسكانية. السوريون يميلون إلى الإنجاب بكثرة مقارنة بالأتراك الذين لديهم طفلان في الغالب، بينما لدى السوريين أربعة أو خمسة أو ستة أطفال. استمرار هذا الاتجاه سيُحدث خللًا ديموغرافيًا ويُثير مشكلات كبيرة في المستقبل”.
وفي حديث AK2، جاء التركيز على ربط السوريين بالجريمة:
“لا يمكن الوثوق بهم. لدي أصدقاء يعملون في مواقع بناء يعمل فيها سوريون أيضًا. في إحدى الليالي، جاءت سيارة وسرقت جميع المواد الموجودة”.
أما مصطلحات مثل النظافة، القذارة، النفايات، فهي انعكاس لنظرة نمطية تجاه السوريين. ولكن من اللافت أن الأتراك غالبًا ما ينظرون بنفس الطريقة الدونية إلى القادمين من الريف داخل تركيا أنفسهم، ما يعني أن بعض الصور السلبية لا تتعلق فقط بـ”سوريين” بل بـ”الفئات المهمشة” عمومًا.
وقالت AK13 مؤيدة قرارات بلدية أفيون بحرمان السوريين من بعض حقوق المدينة:
“أرى أن هذه القرارات كانت صائبة. فهم لا يُشكّلون قوة اقتصادية من أموالهم، بل يعيشون من الأموال القادمة من الخارج. وللأسف، شعبنا التركي لا يريد العمل، بينما السوريون يقولون: نعمل مقابل ثلاث ليرات! ممتاز!”.
سادساً: آراء الأتراك عن أنماط الحياة وأشكال الترفيه عند السوريين:
في غازي عنتاب، قد تكون النقطة الأكثر استراتيجية في مواقف المواطنين الأتراك تجاه السوريين، هي ما يتعلّق بالثقافة، وأنماط الحياة اليومية، وطرق قضاء أوقات الفراغ، وخاصة عادات الترفيه. فهنا نحن أمام تصادم نمطين مختلفين من الثقافات وأنماط العيش. (ينظر الشكل رقم 11)

الشكل رقم (11) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بالترفيه ونمط الحياة في مقابلات غازي عنتاب
ويكشف تكرار الحديث عن “الثقافة” في المقابلات أن السوريين يُنظر إليهم من قبل السكان المحليين على أنهم مختلفون وغير مشابهين. يقول GK14:
“العرب ليسوا من الشعوب التي يمكن استيعابها بسهولة، لأن لديهم ثقافة قديمة. الرسول صلى الله عليه وسلم منهم، ولغتهم لغة القرآن. السوريون ينظرون إلى الأتراك نظرة دونية، ويعتبرون أنفسهم من الدرجة الأولى”.
ويُظهر هذا التصريح أن خطابات السلطة السياسية والنخبة المقربة منها حول “الثقافة المشتركة” و”التاريخ المشترك” لم تعد تلقى صدى لدى عامة الشعب. فرغم أن غازي عنتاب وحلب تتشاركان خلفية تاريخية وثقافية، إلا أن قرنًا من بناء الدولة القومية في كل من تركيا وسوريا خلق تباعدًا كبيرًا في أنماط الحياة والعادات اليومية.
وتتكرر كلمات مثل: الراحة، النرجيلة، المتعة، القهوة – في وصف السوريين – لتكوين صورة جماعية مفادها أن:
السوريين شعب يحب الراحة والتسلية، ويقضون وقتًا طويلًا في المقاهي والنرجيلة، ويضعون الترفيه في قلب نمط حياتهم.
يقول مسؤول في مركز التعليم الشعبي GK21:
“إذا قلت لي عرّف لي السوريين مما أراه، أقول لك: نرجيلة، قهوة، تيك توك. هذا أكثر ما أراه عندهم. ربما بسبب ثقافتهم. عندنا حب الشاي، أما هم فغالبًا لا يشربون الشاي، بل يفضلون القهوة المرة التي تشبه الإسبريسو، ويحبون معكرونة النودلز. تقريبًا كل من عرفتهم من السوريين مدمنو نرجيلة، رجالًا ونساءً. يحبون تصوير الفيديوهات ونشرها. منهم من يصوّر، ومنهم من يكتفي بالمشاهدة”.
يبدو أن الثقافة السورية في العمل وأسلوب قضاء وقت الفراغ غير مألوفة للسكان الأتراك. ففي حين يبدأ الأتراك عملهم في الصباح وينتهون مع المساء، ويفضلون قضاء وقت فراغهم في المنزل مع العائلة، فإن السوريين – بحسب الروايات – يميلون إلى البدء المتأخر للعمل، وقد يتوقفون تمامًا في رمضان أو يوم الجمعة أو الأعياد، مما يُولّد انطباعًا بأنهم “لا يعملون”، رغم أنهم في الواقع يعملون في أوقات مختلفة.
وفي تجربة ميدانية طُبّقت في أنقرة، قال صاحب مصنع GK3:
“اقترحنا تشغيل السوريين في المناوبة المسائية (4 مساءً – 12 ليلًا)، بينما يعمل الأتراك في الصباح. ونجحت التجربة بنسبة 85%. السوريون لا يمانعون العمل ليلًا، لأن ثقافتهم مناسبة لذلك، بعكس الأتراك الذين يفضّلون أن يكونوا مع أسرهم مساءً. وهكذا تحقق توازنٌ بين الطرفين، وبدأ الموظفون الأتراك يشكرون السوريين لأنهم أراحوهم من المناوبات الليلية!”
ويضيف: “السوري يقول: أرجع للبيت الساعة 12 ليلًا، أشرب نرجيلة وأستمتع، وأنام للساعة 10 صباحًا. ما المشكلة؟ العمل يبدأ الساعة 4!”
الصورة النمطية عن السوريين بأنهم يميلون للراحة، ويحبون التسلية، تتجسد خصوصًا في رمزين اثنين: النرجيلة والقهوة.
قال أحد المشاركين:
“نرجيلة، قهوة، تيك توك… هذه أكثر الأشياء التي أراها عند السوريين”.
وكون تحضير النرجيلة وشربها يحتاج إلى وقت طويل، ومع جلوسهم في المقاهي واحتسائهم القهوة خلال ذلك، فقد كوّن الأتراك صورة عن السوري بأنه “شخص يجلس كثيرًا ولا يعمل”.
ورغم أن هذا الانطباع غالبًا سلبي، إلا أن البعض من الأتراك تبنوا لاحقًا هذا النمط من الحياة، خاصة من تأثر بثقافة المقاهي والنرجيلة.
على سبيل المثال، يقول GK11:
“حتى لو قامت القيامة، فهم لا يبالون، حياتهم كلها متعة. يعشقون الراحة، خصوصًا بعد أكل الكباب يجلسون براحة ويشربون الشاي، والنرجيلة بالنسبة لهم شيء لا يمكن الاستغناء عنها. نحن تعرّفنا على ثقافة النرجيلة من خلالهم. حتى من لم يكن يدخن، صار يذهب فقط ليشمّ النكهات المختلفة. لديهم نكهات التفاح والبرتقال وكل الألوان، ويجيدون التحضير، مما يجعل الأمر جذابًا. أنا شخصيًا بدأت أحب النرجيلة بسببهم. هذه الراحة وهذا الترف انعكس علينا”.
أما GK13 فيقول:
” بدلا من أن يندمجوا في ثقافتنا بدأنا نحن بالاندماج في ثقافتهم، وانتشرت المقاهي التي تقدم النرجيلة في كل مكان، جلبوا عادات الترف معهم، وهذه الأمور ليست من عاداتنا”.
ورغم أن تكرار مصطلح “الزمن” كان منخفضًا نسبيًا، إلا أنه مع الكلمات ذات المعنى القريب كـ”الوقت” و”الساعة”، يعكس مزاجًا متكررًا ساد المقابلات. وكما تم التطرق إليه سابقًا، تم التأكيد كثيرًا على الاختلاف في مواعيد العمل والراحة بين السوريين والأتراك.
على سبيل المثال، أشار GK2، الذي يعمل مسؤولًا في ورشات بناء إلى أن:
“السوريين لا يلتزمون بموعد بدء العمل، لكنهم ملتزمون جدًا بموعد الانصراف، ولا يبقون دقيقة إضافية. بينما العمال الأتراك قد يواصلون العمل بعد انتهاء الوقت إذا تطلّب الأمر”.
أما الزوجان GK9 وGK10، اللذان يديران مركزًا صحيًا وورشة صناعة أحذية، فيقولان:
” أثّر السوريون في مركزنا الصحي على العاملين الأتراك بثقافة نوم القيلولة والراحة. كانوا يطالبون بأماكن للنوم في أوقات الاستراحة، وأصبح حتى العامل التركي لا يأتي في الوقت بل في التاسعة والنصف، لكن يخرج بالضبط عند السادسة دون دقيقة تأخير. هذه العدوى الثقافية انتشرت”.
وفي ورشة الأحذية لديهم، يضيفون:
“كانوا يعملون فعليًا 6 ساعات من أصل 9، وبطيؤون في الإنجاز. حتى الطباخ لدينا يقول: إذا بدأ السوري العمل في 11 صباحًا، فهو يعود في الثانية بعد الظهر، رغم أن الدوام يبدأ في التاسعة. لكنهم لا يبدؤون حينها”.
يضيف المتحدثان:
“ربما هذا ليس خاطئًا لديهم، لكنه لا يناسب نظمنا. هنا هناك قواعد، وإذا لم تلتزم بها لا يُعتبر أنك تعمل. من الطبيعي أن نتوقع منهم بعض التكيّف معنا”.
ويذكر GK14، الذي زار حلب قبل 2011 لأغراض رسمية، تجربته مع عميد إحدى الكليات:
“كان لديهم مشكلة في الالتزام بالمواعيد. أذكر أني تناولت طعام الغداء مع عمداء الكليات في جامعة حلب، واستغرقت الجلسة ثلاث ساعات ونصف، مع نرجيلة وقهوة. لم أستطع تقبل ذلك. النرجيلة أراها وسيلة لنقل العدوى، وأحيانًا تُستخدم لتعاطي المخدرات”.
ويقول رجل أعمال آخر GK3:
“عندنا مشكلة مع رجال الأعمال السوريين بخصوص الالتزام بالموعد. نطلب المنتج، يصل بجودة ممتازة، نفس اللون، نفس الخام، كما اتفقنا. لكن نادرًا ما يصل في الوقت المحدد. لا يُغيّرون السعر، لا يقولون ارتفعت الأسعار بل يلتزمون، وهذا أمر نادر ومميز. لكنهم دائمًا يتأخرون”. ويتابع: “لذلك نحن نثق بجودة المنتج والأسعار، لكن مشكلتنا معهم دائمًا هي في التوقيت، وهذا أمر أساسي في الحياة التجارية”.

الشكل رقم (12) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بالترفيه ونمط الحياة في مقابلات أفيون
النتائج هنا مثيرة للاهتمام. عادةً ما يكون لرموز مثل المتعة والترفيه والراحة والطعام محتوى إيجابي. ولها دلالات إيجابية في العقل البشري. ومع ذلك، فإن تحول هذه الرموز إلى رموز سلبية بين السوريين يرتبط بالعيش المشترك والتعرف على بعضهم البعض وتجربتهم. يمكن تفسير حقيقة أن هذه الرموز التي تُرى بتواتر كبير في غازي عنتاب، لا تُرى في أفيون بانخفاض مستوى العلاقات والتفاعل.
في الواقع، نادرًا ما تم استخدام هذه الرموز، ذات المحتوى الإيجابي، للسوريين في أفيون. ويرجع ذلك إلى قلة الإلمام بثقافة الترفيه السورية بسبب قلة التفاعل. علاوة على ذلك، قد يشير هذا النقص في الاستخدام إلى أن هذه الرموز لم تصبح ركيزة من ركائز السردية عن السوريين التي تتشكل في جميع أنحاء تركيا. الثقافة والحياة هما الركيزتان الأساسيتان اللتان يقوم عليهما السرد السوري العام. يمكن ملاحظة التركيز على الاختلافات بين المجتمعين في هاتين المنطقتين في جميع أنحاء تركيا. ولذلك، فإن تكرار هذين الرمزين، وأهميتهما بالنسبة لأهالي أفيون، الذين لم يتفاعلوا مع السوريين أو يختبروا حياتهم في سياق هذين الرمزين، يمكن فهمه في سياق التجلي المحلي للسردية القائمة عن السوريين.
سابعاً: تصورات الأتراك عن أشكال العلاقة الاقتصادية السورية:
أشار بعض المشاركين في عنتاب، كاستثناء، إلى أنهم يشترون من متاجر يديرها سوريون، إلا أن غالبية المشاركين – سواء من سكان الأحياء الفقيرة أو من السكان المحليين الأثرياء في غازي عنتاب – صرّحوا بأنهم لا يتعاملون تجاريًا مع السوريين، ولا يشاركونهم في مشاريع أو شراكات اقتصادية. (ينظر الشكل رقم 13)

الشكل رقم (13) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بالتسوق في مقابلات غازي عنتاب
فعلى سبيل المثال، ذكر المشارك GK3، الذي يعمل كصاحب عمل، أنه أقام علاقات تجارية مع مؤسسات سورية. ومع ذلك، لم يُسجَّل مثل هذا النوع من العلاقة بين باقي المشاركين المنتمين إلى نفس الطبقة الاجتماعية.
وقد أشار معظم المشاركين إلى أنهم لم يشتروا يومًا من محل تجاري يملكه سوري، ولا تناولوا الطعام في مطعم سوري.
على سبيل المثال، قال المشاركون من الأحياء الفقيرة GK19 وGK20 وGK22، والذين يعيشون في نفس الشوارع مع السوريين، إنهم لا يأكلون في مطاعم السوريين، ولا يتناولون طعام جيرانهم السوريين بسبب مخاوف تتعلق بـالتوابل والنظافة.
ويُعدّ هذا الضعف في التفاعل الاقتصادي أحد المؤشرات الأساسية التي تظهر في هذه الرموز الفكرية والمفاهيم التي عبّر عنها المشاركون.
مع ذلك، هناك بعض الاستثناءات، حيث يوجد عدد غير قليل من السوريين الذين يتسوقون من متاجر الأتراك.
فعلى سبيل المثال، ذكرت GK19، التي كانت تملك محلًا لبيع الملابس في حي “كايا أونو”، أن السوريين في الحي كانوا يشترون منها بشكل متكرر.
كما أشار GK11، الذي يدير كشكًا في أحد المتنزهات، إلى أن السوريين يساهمون اقتصاديًا بطريقة غير تقليدية، وقال: “السوريون يشعرون بالراحة هنا، ولا يرتاحون قبل أن ينفقوا كل ما في جيوبهم. لقد رأيت هذا بنفسي. لا يحملون هم المعيشة والتدبير للغد. أحد الزبائن، وهو ميكانيكي، جاءني وقال إنه سينفق كل أمواله اليوم. هم يشترون كثيرًا من الكولا والبسكويت والشوكولاتة والشاي، لكنهم لا يسألون عن الأسعار، ولا يطلبون تخفيضًا مثل الأتراك. عندما يريد التركي شراء شواية مثلًا وسعرها 250 ليرة، يسأل إن كان يمكن أن تُخفض إلى 200. أما السوري فلا يساوم، يشتري فورًا. ومن هذه الناحية، كان لهم تأثير اقتصادي إيجابي علينا”.
وفي السياق نفسه، قالت GK15، التي تعيش في حي ثري، إنها تذهب أحيانًا إلى حي فقير مثل “ساجاكلي”، وتتسوق من محلات السوريين بسبب أسعارهم المنخفضة، وأشارت إلى أن التجار الأتراك يبالغون في تحقيق الأرباح مقارنةً بالسوريين.
ومع ذلك، صرّح العديد من المشاركين – من بينهم GK5، GK1، GK20، GK14، GK24، GK6، GK9، GK10، GK19، GK25 – بأنهم لم يسبق لهم أبدًا أن اشتروا من متجر يملكه سوري.
أشار GK14 إلى أن السوريين يعملون بنظام الدفع النقدي المباشر في تعاملاتهم التجارية، وعلّل ذلك بأنهم لا يُعتبرون موضع ثقة في التعاملات المالية المؤجلة، مما يجعل الدفع الفوري شرطًا أساسيًا في أي معاملة معهم.
في أفيون، تُظهر الرموز العليا والفرعية في هذا المحور غياب التفاعل الاقتصادي بين السوريين والسكان المحليين. (ينظر الشكل رقم 14)

الشكل رقم (14) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بالتسوق في مقابلات أفيون
فالمؤشرات التي ترمز إلى أن السوريين أصبحوا جزءًا من البنية الاقتصادية المستقرة – مثل: امتلاكهم لمحال تجارية، أو دخولهم في شراكات، أو نشاطهم في الأسواق المحلية –غير موجودة في أفيون، بخلاف ما يمكن رصده في مدن مثل غازي عنتاب.
وهذا يُعبّر عن غياب العلاقة العملية اليومية بين الطرفين، مما ينعكس أيضًا على سطحية إجابات المشاركين عند سؤالهم عن البُعد الاقتصادي للعلاقة مع السوريين.
فعلى سبيل المثال، قالت AK10: “يمكننا القول إن هناك تأثيرًا اقتصاديًا إيجابيًا. في النهاية، هم يتسوقون، يفتحون محلات خاصة بهم، يعملون في مجالات مختلفة، ويكافحون. لذلك لا يمكن إنكار أن لهم إسهامًا اقتصاديًا في هذا الجانب”.
لكن هذا التقييم جاء بشكل عام وتجريدي، لا يستند إلى تجربة مباشرة أو تعامل واقعي.
أما AK7، فأورد مثالًا أكثر تحديدًا، وقال:
“كان هناك متجر في منطقة المجيدية. لم يُغلق إلا قبل 3–5 أسابيع. كان يعمل فيه عادة شخص سوري. السوريون لم يكونوا يذهبون كثيرًا إلى ذلك المتجر. كانوا يأتون إلى المتجر الذي أعمل فيه. وعندما سألتهم عن السبب، قالوا إن العامل هناك كان يعاملهم بطريقة سيئة. كان سوريًا مثلهم، لكنهم اشتكوا من سلوكه السيئ تجاه الزبائن. يبدو أن هناك بين السوريين أنفسهم أيضًا نوعًا من التنافس السلبي أو عدم تقبل بعضهم لبعض”.
ويُظهر هذا المثال النادر أن حتى ما يُذكر عن التفاعل الاقتصادي في أفيون غالبًا ما يتعلق بوقائع فردية محدودة، لا تعكس حالة من الاندماج الاقتصادي البنيوي أو الواسع.
بالتالي، فإن غياب الرموز الاقتصادية النشطة مثل المتاجر السورية أو الشراكات التجارية، يؤكد أن السوريين في أفيون لم يتحولوا إلى شريحة اقتصادية مستوطنة. وأن التفاعل الاقتصادي بينهم وبين السكان المحليين محدود جدًا، مما يفسر سطحية التقييمات العامة في إجابات المشاركين.
ثامناً: تصورات الأتراك عن العلاقات الاقتصادية:
يُعد الاقتصاد من أبرز المجالات التي يمكن من خلالها تتبُّع ديناميات الاندماج الاجتماعي أو المسافة الاجتماعية بين السوريين والمجتمع المحلي. وأظهرت المقابلات أن أكثر الكلمات تكرارًا في هذا المحور كانت “العمل غير الرسمي” أو “العمل دون تسجيل”. (ينظر الشكل رقم 15)

الشكل رقم (15) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بالاقتصاد وسوق العمل في مقابلات غازي عنتاب
يُعتبر العمل غير الرسمي أحد أبرز مواضع الاعتراض في غازي عنتاب، سواء لدى العمال الأتراك أو حتى أصحاب الأعمال الأتراك.
يشرح GK1 مدى تأثير هذا الواقع قائلًا:
“العمل غير الرسمي يمنح الشركات السورية ميزة كبيرة. حاليًا، تكلفة تسجيل عامل واحد بالحد الأدنى للأجور تبلغ نحو 7,500 ليرة تركية شهريًا. عندما لا تقوم بتسجيل العامل توفّر هذا المبلغ. فإذا كان لديك عشرة عمال غير مسجلين، فإنك توفر 75,000 ليرة شهريًا. في الماضي كانت الشركات التركية توظف سوريين بشكل غير رسمي. اليوم، حتى الشركات السورية توظف السوريين بغير تسجيل، وبدأوا هم أنفسهم بإعادة إنتاج نظام الاستغلال داخل مجتمعهم. في رأيي، يجب أن تقوم الجهات المختصة مثل المالية، والأمن، والضمان الاجتماعي بشن حملات تفتيش كبيرة. يمكن بسهولة ضبط 10,000 عامل غير مسجل في غازي عنتاب”.
أما من وجهة نظر العمال الأتراك، فإن دخول السوريين إلى سوق العمل غير الرسمي تسبب في ارتفاع نسب البطالة، وانخفاض الأجور، وتدهور ظروف العمل.
يقول GK6، الذي يمتلك تجربة طويلة في سوق العمل:
“قلنا منذ البداية إن دخول السوريين إلى عنتاب خلق قوة عمل رخيصة. من جهة، ساعد في تلبية احتياجات سوق العمل، لكن من جهة أخرى خلق نظاماً أقرب إلى العبودية. كنت أقول إن هذا الوضع سيؤدي إلى تقييد حقوق العمال الأتراك، وهذا ما حصل. اليوم، الجميع يعمل بأقل من الحد الأدنى للأجور. منذ 18 عامًا وأنا في سوق العمل، وكان حتى أصغر أصحاب العمل يوزعون مكافآت سنوية مرتين في السنة. الآن، لا أحد يوزع مكافآت. ويقول صاحب العمل للعامل التركي: إن لم ترضَ، فهناك سوري مستعد للعمل. وهذا الأمر قضى على مفهوم الولاء في بيئة العمل، والذي هو ضروري تمامًا كما هو الحال في الزواج”.
إلى جانب مفهوم “العمل غير الرسمي”، ارتبط رمز “المساعدة الاجتماعية” ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم العمل غير الرسمي والبطالة. فالمساعدات التي تُمنح من قبل المؤسسات المختلفة – غالبًا بشرط عدم وجود دخل رسمي – تُعد من العوامل المشجعة على العمل غير المسجل أو حتى على الاعتماد الكلي على الإعانات رغم تدني مستوى المعيشة.
وقد لخّص GK20، وهو معماري ومسؤول في منظمة إغاثية، هذه الإشكالية بقوله:
“إذا أوقفت المساعدات الممنوحة لكل طفل، وقطعت المساعدات الاجتماعية كليًا، فسيُجبر السوريون على العمل كما نعمل نحن، لتأمين أبسط ضروريات الحياة. أنا لا أتحدث عن التعليم، بل عن الحد الأدنى من مقومات البقاء. عندها لن يجرؤ أحد على إنجاب المزيد من الأطفال. منذ 10 سنوات ونحن نوزع سلالاً غذائية في أحد الأحياء التاريخية. في السابق، كانت نسبة السوريين لا تتجاوز 10% من المستفيدين. اليوم، أصبحت الفئة الكبرى، ومعظمهم أطفال وأمهات. بعض الأطفال السوريين، بلون شعرهم الأشقر وعيونهم الملونة، يمكن تمييزهم بسهولة. لقد أصبحنا نرى أطفالًا صغارًا جدًا يأتون بأنفسهم للحصول على المساعدة. السبب في ذلك هو نظام المساعدات الذي أدى إلى هذه النتيجة”.
من جهة أخرى، فإن اقتصار المساعدات الاجتماعية على السوريين دون غيرهم – رغم أن بعض الأتراك يشاركونهم نفس ظروف الفقر – أدى إلى موجة من الامتعاض والتوتر في الأحياء الفقيرة المشتركة.
لذلك، فإن مصطلح “المساعدة الاجتماعية” يُعتبر في صميم موقف السكان المحليين السلبي تجاه السوريين، ليس فقط بوصفه مسألة مالية، بل لأنه أصبح يُرى كسبب مباشر لتدهور العدالة الاجتماعية.
ورغم أن بعض المشاركين أشاروا إلى مساهمات السوريين في الاقتصاد المحلي، إلا أن التركيز الأكبر كان على دورهم في تعميق الأزمة الاقتصادية، سواء من خلال العمل غير الرسمي أو المساعدات المقدمة لهم.
وفي هذا السياق، قال GK14:
“رؤية السوريين يصطفون أمام مكاتب البريد (PTT) لأخذ رواتبهم أمر مهين. كما أنهم يحصلون على مواعيد طبية أسرع من الأتراك، ولا يدفعون ثمن العلاج أو الدواء”.
تشير العبارات السابقة إلى تصورات مسبقة لدى الأتراك عن السوريين تخالف الكثير مما ذهبت إليه الدراسات والتقارير التي تشير إلى عكس هذه التصورات، من حيث أن الشريحة الأكبر من السوريين تعمل لساعات أطول من الساعات المحددة في القانون، وبأجور أقل من تلك التي يتقاضاها أقرانهم الأتراك، ولا يعتمدون على المساعدات في تلبية احتياجاتهم إلا بالنذر اليسير (السعد وآخرون، 2024)
وهكذا، فإن مصطلح “الاقتصاد” لا يُعتبر سلبيًا بحد ذاته، لكنه في معظم الأحيان ظهر في سياق جُمَل تحمل مضامين سلبية تتعلق بتأثير الوجود السوري على معيشة الأتراك، وحقوقهم، واستقرارهم المالي.
استُخدم مصطلح “العامل” في هذا المحور ضمن مضامين إيجابية وسلبية في آنٍ معًا. فمن جهة، أشار بعض المشاركين – خاصةً ممن هم في موقع صاحب العمل – إلى الدور الإيجابي للعمال السوريين في سد النقص في اليد العاملة، خصوصًا في القطاعات الشاقة كالبناء والزراعة.
ومن جهة أخرى، اعتُبر السوريون مسؤولين عن ارتفاع معدلات البطالة بين العمال الأتراك، أو على الأقل عن تراجع الأجور وسوء ظروف العمل. (السعد وآخرون، 2024)
كما تم توظيف مصطلح “الأجور” للإشارة إلى أن السوريين يعملون غالبًا بأجور منخفضة ودون تسجيل رسمي، ما يؤدي إلى إجبار العمال الأتراك على القبول بوظائف أقل أجرًا.
في المقابل، أشارت بعض المداخلات إلى أن السوريين، من خلال نشاطهم التصديري، يُدخلون العملة الصعبة إلى مدينة غازي عنتاب، وهو ما يُعدّ مساهمة إيجابية في الاقتصاد المحلي.
فقد قال GK14 في هذا السياق:
“السوريون يتحدثون لغتين، ويُعدّون قوة عاملة رخيصة. بفضل معرفتهم باللغات، باتوا يُصدرون المنتجات إلى أعماق إفريقيا. هم يدخلون القطاعات التي تعتمد على اليد العاملة مثل البناء والزراعة. ربما يكون لوجودهم تأثير سلبي في الأجل القصير والمتوسط، لكن في الأجل الطويل سيكون له تأثير إيجابي”.
أما رجل الأعمال GK3 فقد قال:
“السوريون يسعون عمومًا إلى ممارسة التجارة بطريقة سليمة، دون مديونية. يتجنبون البنوك والخدمات المالية، ويفضلون التمويل الذاتي. معظمهم يعمل بنظام الدفع النقدي دون تقسيط، وهذا يمثل ميزة لمن يتعامل معهم في تركيا، لأن السوق التركية تعتمد على القروض والتقسيط، مما يجعل التكاليف أعلى. أما السوريون فيشترون ويدفعون مباشرة، مما يخفض الكلفة الإجمالية. وبما أنهم يعيشون في بلد أجنبي، فإنهم يحرصون على الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على سمعتهم التجارية. لدينا حاليًا عاملون سوريون، ومورّدون سوريون، وماكينات نسيج سورية، ومصانع للمواد الخام، كما أن لدينا عملاء سوريين يشترون منتجاتنا”.
في أفيون، تعبّر المصطلحات الواردة في هذا القسم عن تأثير المشكلات الاقتصادية العامة في تركيا على التصورات المحلية، كما تُبرز حساسية سكان مدينة ذات ديناميات اقتصادية محدودة تجاه القضايا الاقتصادية المرتبطة بالسوريين. (ينظر الشكل رقم 16)

الشكل رقم (16) يبين تكرار المصطلحات المتعلقة بالاقتصاد وسوق العمل في مقابلات أفيون
على سبيل المثال، قالت AK10:
“نعم، لهم مساهمات في الحياة المدنية والحياة الاجتماعية في المدينة. هناك نساء سوريات يعملن في الخياطة، ويكسبن المال. لم أسمع يومًا أن هناك ضررًا من امرأة سورية. لم أسمع أبدًا شيئًا سلبيًا عنها”.
ومن المهم التذكير هنا أن السوريين في أفيون لا يشكّلون كتلة بشرية لها تأثير ملموس على اقتصاد المدينة، ومع ذلك، فإن الخطاب الاقتصادي حولهم سلبي وقوي جدًا وسائد، ما يشير إلى أن الحديث عن “الاقتصاد” في أفيون لا يستند إلى تجربة فعلية، بل إلى خطاب وطني عام جرى إسقاطه محليًا.
وتُظهر مصطلحات مثل “العمل غير المسجّل”، “المساعدات”، و”الاقتصاد” أن التصور السائد هو أن السوريين “يعملون دون تسجيل رسمي” و”يعيشون على المساعدات الاجتماعية”، وهو ما أصبح جزءًا من سردية وطنية تم تبنيها محليًا.
قالت AK8:
“بدلًا من توظيف عامل تركي بأجر الحد الأدنى وبشكل مسجل، يتم تشغيل سوري بنصف الأجر ولساعات طويلة. أعرف ذلك، فقد عمل أحد السوريين مع أخي لفترة من الزمن، وكان نشيطًا جدًا. كان أخي يقول إنه يعمل أكثر من الأتراك. المشكلة أنه اضطر إلى القبول بنصف الأجر، وهذا أمر غير عادل. ما أقوله مبني على ما سمعته وشاهدته عن قرب، إذ يعملون بأجور أقل ولساعات أطول”.
وفي السياق نفسه، قالت AK5:
“للأسف، يتم تفضيل السوريين لأنهم يقبلون العمل بأجور أقل من الأتراك. وهذا يؤدي إلى صعوبة أكبر في حصول الأتراك على وظائف، وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة”.
هذا النمط من التصريحات يعكس أن هذه التصورات في أفيون لا تستند إلى تجربة مباشرة، بل تمثل انعكاسًا محليًا لخطاب وطني أوسع حول السوريين والاقتصاد.
أما ضعف تكرار المصطلحات المرتبطة بـ”أرباب العمل” أو “أصحاب الشركات”، فيُفسّر أيضًا بندرة التجارب الفعلية مع سوريين يمارسون نشاطًا اقتصاديًا ناجحًا، إذ لا يوجد في أفيون حضور فعلي لرواد أعمال سوريين، وبالتالي تغيب الصور الإيجابية النمطية المرتبطة بالنجاح الاقتصادي.
ويجب تفسير المصطلحات مثل “الأجور”، “المال”، و”العامل” في ضوء إسقاط السرديات الوطنية على المستوى المحلي. فالمواقف السائدة في أفيون حول انخفاض الأجور أو ارتفاع البطالة بسبب السوريين لا تعكس واقعًا اقتصاديًا محليًا فعليًا، بل تُعيد إنتاج تصورات عامة موجودة على مستوى البلاد.
النتائج والتوصيات – التقييم
أظهرت هذه الدراسة الميدانية، التي أُجريت حول تصورات ومواقف السكان الأتراك تجاه السوريين في مدينتين تركيتين تختلفان بشكل كبير من حيث الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية نتائج مهمة. فقد تمت مقارنة غازي عنتاب، المدينة القريبة من الحدود السورية والتي تضم عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين وتتميز باقتصاد قائم على الصناعة والتجارة، مع أفيون قره حصار المدينة ذات الديناميات التنموية المحدودة، والتي يقوم اقتصادها أساساً على الزراعة والسياحة، وتضم نسبة صغيرة جداً من السوريين مقارنة بعدد السكان.
وقد ركّزت المقارنة بين المدينتين على عدة متغيرات أساسية، أهمها: مدى تأثير مستوى التفاعل بين السكان المحليين واللاجئين على التصورات والمواقف تجاه السوريين، ومدى تشكُّل “سردية وطنية” حول اللاجئين السوريين في تركيا، وطبيعة تأثير هذه السردية على المواقف المحلية سواء في المدن التي اختبرت فعلياً العلاقة مع السوريين، أو تلك التي لم تختبرها.
وأظهرت نتائج الدراسة أن التشابه في بعض المواقف السلبية بين المدينتين – رغم اختلاف تجربتهما مع اللاجئين – يشير إلى وجود سردية سلبية عامة على المستوى الوطني تجاه السوريين. ويمكن القول إن هذه السردية تقوم أساساً على عاملين رئيسيين: الثقافة ونمط الحياة. كما أن العدد الكبير للسوريين في تركيا يشكّل عنصراً إضافياً يثير القلق في نظر بعض السكان المحليين.
وتبرز عناصر هذه السردية السلبية في مواضيع مثل: النظافة، استخدام الفضاءات العامة، دور المرأة في الأسرة والمجتمع، مفهوم الوقت، نمط العمل، المشاكل اللغوية، سلوك التجار، العادات الغذائية، عدد الأطفال وطريقة تربيتهم، الملبس والمظهر.. وجميعها تندرج ضمن اختلاف نمط الحياة والثقافة.
ورغم أن هذه السردية لا تخلو من ارتباط ببعض الوقائع، إلا أن القول بوجود “ثقافة وتاريخ مشتركين” كما يُردد في الخطاب الرسمي لا يجد ما يدعمه عملياً في الواقع. فعلى سبيل المثال، بدء ساعات العمل في حلب بعد منتصف النهار، أو اختلاف نظام الضرائب السوري عن النظام التركي، لا تعدو أن تكون أمثلة بسيطة يمكن توسيعها. كما أن حقيقة أن غالبية السوريين المقيمين في تركيا قدموا من مناطق ريفية في سوريا، جعلتهم أقل ألفة مع ثقافة المدن التركية، الأمر الذي أدى إلى ظهور مشكلات أكبر في التكيُّف والاندماج، وانعكاس هذه المشكلات على أعين السكان المحليين بشكل أوضح وأشد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تصوّر السوريين كـ”آخر” في المجتمع التركي لا يرتبط فقط بما يصدر عن السوريين أنفسهم من ممارسات، بل يتشكل في كثير من الأحيان نتيجة عمليات إدراكية داخل المجتمع التركي ذاته. فكل مجتمع أثناء سعيه لتعريف هويته يقوم بتشكيل “هوية مضادة” تُسقِط عليها سلبياته الداخلية ((Bölükbaşı, 2022. وفي السنوات الأخيرة، أصبحت هذه الهوية المضادة – في الحالة التركية – متمثّلة بالسوريين، إذ تُنسَب إليهم مشكلات مثل قلة النظافة في الأماكن العامة، وسوء استخدام الحدائق، وارتفاع معدلات الجريمة، والتحرش بالنساء، وهي مشكلات توجد أصلاً داخل المجتمع التركي نفسه، لكنها تُسقَط على “الآخر” بهدف تبرئة الذات.
وعندما تتزامن هذه الآلية النفسية والاجتماعية مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، تظهر الحاجة إلى “كبش فداء”، وغالباً ما يكون هذا الكبش من المهاجرين أو الأقليات – كما هي الحال في معظم دول العالم. وفي تركيا اليوم، يتجسّد هذا الدور في السوريين.
ومن الجدير بالذكر أن الخطاب السياسي والاستقطاب الأكاديمي أسهما بشكل واضح في تكريس هذه السردية العامة والمتماسكة تجاه السوريين. كما أن السياسات الحكومية المعتمدة بين عامي 2012 و2016 لعبت دوراً محورياً في مفاقمة الوضع؛ إذ إن دخول هذا العدد الكبير من السوريين دون آليات رقابة فعالة، ومن دون تسجيل منتظم أو استعداد بنيوي، جعل من غير المنطقي افتراض أن المجتمع التركي لن يُبدي ردة فعل سلبية. وقد نبهت بعض الأصوات من البداية إلى مخاطر هذه السياسة.
أما اللامبالاة النسبية التي بدت في المجتمع التركي خلال المراحل الأولى من الأزمة، فلم تكن نتاج رضا، بل كانت تعبيراً عن عدم تبلور ردة الفعل بعد. كما أن تبني خطاب “الضيوف” الذي بُني عليه قانون الحماية المؤقتة، افترض مسبقاً أن السوريين لن يستقروا في تركيا بشكل دائم، وأنهم سيعودون إلى بلادهم لاحقاً. لكن بعد عام 2018، ومع بدء تشكّل أنماط استقرار واضحة للسوريين، وتزايد مشكلات الاندماج الناتجة عن سياسات التكيّف الاجتماعي، وظهور الفروقات الثقافية ونمط الحياة، تصاعدت ردات الفعل لدى السكان المحليين وبدأت تظهر علناً. وعندما التقت ردات الفعل هذه بالخطاب السياسي الاستقطابي، كانت النتيجة ولادة سردية وطنية متماسكة ذات طابع سلبي حول السوريين.
وفي مدينة غازي عنتاب، ساهم الطابع الاجتماعي والسياسي المتنوع، إلى جانب الخلفية الصناعية والتجارية، والكثافة السكانية العالية للسوريين، في تشكيل صور متعددة ومتباينة عنهم. ولهذا، يصعب الادعاء بوجود سردية متجانسة أو موقف موحد تجاه السوريين داخل المدينة، رغم تأثرها بالخطاب الوطني العام. وقد أظهرت المقابلات أن هناك شريحة لا بأس بها تتبنى صورة إيجابية عن السوريين، وأخرى تتخذ موقفاً حيادياً، إلى جانب غالبية تحمل تصوراً سلبياً. لكن من المهم الإشارة إلى أن دوافع السلبية تختلف بين الطبقات الاجتماعية؛ فالسكان من الشرائح الدُنيا يعبرون عن غضبهم من منطلق المنافسة الاقتصادية، بينما تتشكل مواقف الأسر الميسورة و”الأعيان” المحليين انطلاقاً من مخاوف تتعلق بالهوية الثقافية والاجتماعية.
إلا أن القاسم المشترك بين الفئات ذات التصورات السلبية تجاه السوريين يتمثّل في محدودية نقاط التماس والتفاعل بين السوريين والأتراك. ففي الأحياء الفقيرة كما في الأحياء الثرية، نادراً ما توجد علاقة مباشرة بين الطرفين، وأحياناً تكون معدومة تماماً. ففي الأحياء الفقيرة، وعلى الرغم من تقاسم السوريين والأتراك للشارع نفسه، إلا أنهم لا يمارسون علاقات الجيرة التقليدية؛ لا زيارات متبادلة، ولا مشاركة في المناسبات أو الأطعمة. وبالمثل، فإن جزءاً كبيراً من العائلات العريقة والثريّة في غازي عنتاب – رغم وجود السوريين في المدينة منذ سنوات – لم تُنشئ أي علاقة تُذكر معهم، ولم تعش في الأحياء ذاتها. وغالباً ما ترى هذه الفئة الثقافات الوافدة، خصوصاً عندما تكون كثيفة عدداً ومختلفة نمطاً، تهديداً مباشراً على هوية المدينة وخصوصيتها. وهذا الإحساس بالتهديد – كما أُشير سابقاً – لا يخلو من مبررات، وإن كان تجاوزه ممكناً، فإن الخطوة الأولى لذلك تتمثل في تهدئة مخاوف هذه الشريحة المؤثرة من سكان المدينة.
من جهة أخرى، لا يقتصر نسيج غازي عنتاب الاقتصادي على العائلات التقليدية فقط، إذ إن عدداً كبيراً من الصناعيين والتجار في المدينة هم من الوافدين من مدن أخرى في جنوب شرق وشرق الأناضول. وتحديداً، فإن مواقف بعض رجال الأعمال القادمين من ولايات مثل أورفا وماردين – وهي ولايات تتميّز بتشابه ديمغرافي وثقافي مع السوريين – تختلف عن مواقف العائلات المحلية في غازي عنتاب. كما أن رجال الأعمال المنضوين ضمن جمعية “موسياد” (MÜSİAD)، الذين يشكّلون شريحة مؤثرة في اقتصاد المدينة، يُظهر بعضهم – رغم بعض التحفّظات – تصورات إيجابية نسبياً تجاه السوريين.
ويمكن القول، في خلاصة المشهد الخاص بمدينة غازي عنتاب، إن السردية الوطنية السلبية تجاه السوريين موجودة وفاعلة، إلا أن التكوين الاجتماعي والسياسي المتنوع للمدينة حال دون تشكّل صورة نمطية موحّدة عن السوريين. ففي غازي عنتاب، لا نواجه سردية واحدة بل سرديات متعددة تعبّر عن واقع اجتماعي مركّب.
أما بالنسبة لأفيون قره حصار، فإن محدودية ديناميات التطور الاجتماعي والاقتصادي فيها، إلى جانب العدد القليل جداً من السوريين، تجعل منها حالة ذات دلالة خاصة. فرغم قلة عدد السوريين، إلا أن مسألة وجودهم أصبحت محوراً للاستقطاب السياسي المحلي. ويمكن القول إن أفيون تمثّل نموذجاً لمدينة من وسط وغرب الأناضول ذات قدرات تنموية محدودة، تنظر إلى السوريين كـ”كبش فداء” للأزمة الاقتصادية التي تعيشها. ويُظهر تحليل الحالة أن الخطاب السلبي تجاه السوريين فيها ليس ناتجاً عن تجربة مباشرة أو احتكاك فعلي، بل عن تبني السردية الوطنية العامة كما هي، دون تصفية أو تعديل محلي. إذ لا توجد في المدينة آليات تواصل أو تفاعل تسمح بإعادة تشكيل هذه السردية أو تفكيكها. ولهذا، فإن بيانات أفيون تقدّم لنا صورة “نقية” للسردية الوطنية السائدة عن السوريين، قبل أن تلامسها التجربة الشخصية أو التفاعل اليومي.
التوصيات:
– رغم سنوات طويلة من العيش المشترك في نفس المدينة، ما تزال المسافة الاجتماعية بين السوريين والأتراك عميقة جدًا. ولتقليل هذه المسافة الاجتماعية بين المجتمعين، يجب تطوير قنوات الحوار. ينبغي إنشاء مجالات لتعزيز الحوار مثل الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، والألعاب المشتركة للأطفال، وفعاليات الطهي، والنزهات الجماعية.
– أحد العوامل الأساسية التي تشكّل وعي الأتراك هو عمل السوريين خارج نطاق القانون. وهذا الوضع يخلق أيضًا حالة من المنافسة غير العادلة بالنسبة للأتراك. لذا، يجب منع العمل غير المسجّل من قبل السوريين سواء على مستوى المؤسسات أو العمال بشكل حاسم. وينبغي تقديم تدريبات للسوريين حول أنظمة الضرائب والتأمين والإجراءات اللازمة لفتح أماكن العمل وثقافة ريادة الأعمال في تركيا. كما ينبغي على منظمات المجتمع المدني السورية واتحادات رجال الأعمال السوريين أن تلعب دورًا نشطًا في هذا الصدد.
– كانت المساعدات الاجتماعية التي قدمتها المؤسسات الدولية للسوريين مهمة في البداية للتخفيف من معاناة الحرب والنزوح. ولكن اليوم، أصبحت هذه المساعدات أحد الأسباب في تفشي العمل غير المسجل، وتحولت إلى وضع يسبب الامتعاض لدى المواطنين الأتراك. فالأتراك الذين يعيشون في نفس الأحياء ويواجهون نفس الصعوبات لا يستفيدون من هذه المساعدات، مما أدى إلى ظهور حالة من التذمر. لذا، يجب إما توزيع هذه المساعدات بشكل عادل على الأتراك والسوريين الذين يعيشون في نفس الظروف، أو إنهاء هذه المساعدات بالكامل[4].
– إن وضع الحماية المؤقتة يحمل بعض العوائق بالنسبة للسوريين، لكن تصنيفهم كأجانب بموجب هذا الوضع يجعلهم يستفيدون من الحقوق الممنوحة للأجانب داخل البلاد. ومع اقتراب عدد السوريين من 5 ملايين، فإن استفادتهم من هذه الحقوق لا تمر مرور الكرام عند الأتراك. فالتسهيلات في فتح أماكن العمل، والاستفادة من خدمات التعليم العالي والصحة، كلها أمور تثير ردود فعل من قبل الأتراك.
– يجب على المواطنين الأتراك أن يتخلوا عن بعض أحكامهم المسبقة تجاه السوريين. وفي المقابل، يُظهر السوريون مقاومة تجاه بعض عاداتهم الثقافية والاجتماعية. لذلك، ينبغي مراجعة تلك العادات والسلوكيات التي لا تنسجم بوضوح مع البنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع التركي، مثل التدخين في الأماكن المغلقة أو الحديث بصوت مرتفع والتبرج ..إلخ، والتخلي عنها إن لزم الأمر.
– بحسب المواطنين الأتراك، فإن إتقان اللغة التركية يُعد من الشروط الأساسية للعيش في هذا المجتمع. لذا يجب التغلب على المقاومة التي تُلاحظ لدى فئات معينة من السوريين، وخاصة كبار السن والنساء، في تعلم اللغة التركية. وينبغي أن يكون تعلم التركية أولوية لجميع السوريين المقيمين في تركيا، دون أن يعني ذلك التخلي عن اللغة العربية. كما يجب إعداد الأعمال الثقافية والفنية والأدبية السورية بلغة ثانية هي اللغة التركية، وإعطاء الأولوية لاستخدام التركية في المنشورات والمحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
– من أسباب انعزال المجتمع السوري في تركيا هو اقتصار تواصله على نفسه، واعتماده على الشراء من التجار السوريين فقط. إن توجه السوريين للشراء من التجار الأتراك يمكن أن يُسهم بشكل كبير في تخفيف حدة التوتر لدى الجيران الأتراك. وينطبق الأمر ذاته على الأتراك، إذ إن شراءهم من التجار السوريين يُساعد في تخفيف شعور التهميش والعزلة لدى السوريين، ويُقلل من ميلهم للانغلاق.
– إن تحوّل السوريين إلى كتلة سكانية ذات كثافة بارزة في بعض الأحياء أو المدن يُثير ردود فعل لدى المواطنين الأتراك. وقد لا يكون هناك حل فوري لهذا الوضع، إذ إن تركز السوريين في مناطق معيّنة يرتبط بسياسات الهجرة المطبقة منذ عام 2012. ولكن من الممكن تقليل هذا التوتر عبر إعادة توزيع الوجود السكاني السوري على مختلف المدن التركية، بحيث لا تتركز الكثافة السكانية في مدن أو أحياء بعينها. هذا من شأنه أن يُخفف الضغط المحلي، ويُقلل من المشاعر السلبية تجاه السوريين في تلك المناطق.
المراجع باللغة العربية:
- حسام السعد، كندة حواصلي، محمد نذير سالم، ياسين جمول، حياة تحت المجهر: السوريون في تركيا وحديث المجتمع والاقتصاد، مركز الحوار السوري، 2024.
المراجع باللغة الأجنبية:
- Altınoluk, D., Tunç, T.B. (2022) “Bu Kent Kimin?: Yerli Kadınların Göç Anlatısı” Suriyeliler Her Yerde! Yerliler ve Göçmenler, sf. 75-110. İletişim Yayınları, İstanbul.
- Ayhan, F. (2020) “Afyonkarahisar’ın Nüfus Coğrafyası Özellikleri” Journal of Awareness. Sf. 401-426, Cilt / Volume 5, Sayı / Issue 3, 2020
- Barış M, Sert G, Önder O. Ethical challenges in accessing and providing healthcare for Syrian refugees in Türkiye. Bioethics. 2025 Jan;39(1):49-57. doi: 10.1111/bioe.13233
- Bayram, E.E. (2024) Bir Göç Kentinin Yerlisi Olmak: Gaziantep’te Şehreküstülüler Örneği, Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Bölükbaşı, Y. Z. (2023). “Milliyetçilik-Göç İlişkisi Üzerine Teorik Bir Perspektif”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, 18(1), 44 – 65.
- Erdoğan, M. M. (2018), Syrians Barometer, UNHCR
- Gültekin, N. Ve diğ. (2018) Gaziantep’teki Suriyeliler, Gaziantep Üniversitesi Yayınları, Gaziantep.
- Gültekin, N. Ve diğ. (2021) Gaziantep Monitörü- Gaziantepliler, Sabev Yayınları, İstanbul.
- Gültekin, N. Ve diğ. (2021) Gaziantep Monitörü- Uyum, Sabev Yayınları, İstanbul.
- Gültekin, N. Ve Diğ. (2022) Gaziantep Odaklı Sosyal Uyum Araştırma Raporu- Gaziantep Monitörü 2022, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yayını, Gaziantep.
- Jung, D. (2005), Turkey and the Arab World: Historical Narratives and New Political Realities, Mediterranean Politics, Vol. 10, No. 1, 1–17, March 2005
- Kahraman, H. (2022) “Onlar Bizden Daha Çok Hakka Sahip: Kilis’te Bir Pharmakos” Suriyeliler Her Yerde! Yerliler ve Göçmenler, sf. 19-46. İletişim Yayınları, İstanbul.
- Karaosmanoğlu, Y. K. (1967) Zoraki Diplomat, İletişim Yayınları, İstanbul.
- Koca, B. (2022) “Kendi Şehrimizde Yabancı Hale Geldik: Kilis’te Suriyeliler Karşısında Yerliler” Suriyeliler Her Yerde! Yerliler ve Göçmenler, sf. 47-74. İletişim Yayınları, İstanbul.
- Koyuncu, A. (2014) Kentin Yeni Misafirleri- Suriyeliler, Çizgi Yayınları, Konya.
- Layder, D. (2013) Sosyolojik Araştırma Pratiği- Teori ve Sosyal Araştırmanın İlişkilendirilmesi, Çev. S. Ünal. Heretik Yayınları, Ankara.
- Mülteciler Derneği (2022), Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Aralık 2022.
- Özçellik, E. (2022) Göçmenlerin Yerleşik Kimlik İnşası: Gaziantep’te Suriyeli Esnaflaşması, Gaziantep Üniversitesi SBE, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Özdemir, Ş.; Karaca, Y. (2009) “Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma” Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi sf. 113-134. (C.X I,S II, 2009)
- Robson, C. (2015) Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Gerçek Dünya Araştırması, Çev. Ş. Çınkır, N. Demirkasımoğlu. Anı Yayıncılık, Ankara.
- Tanyol, C. “Eylen Köyü” https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4823
- Yaşar, C. (2024) Suriyeli Göçü Bağlamında Üniversite Gençliğinde Zenofobi: Gaziantep Üniversitesi Örneği, Gaziantep Üniversitesi Göç Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
- Zaller, J. R. (1992), The Nature and Origins of Mass Opinion, University of California, Cambridge University Press.





