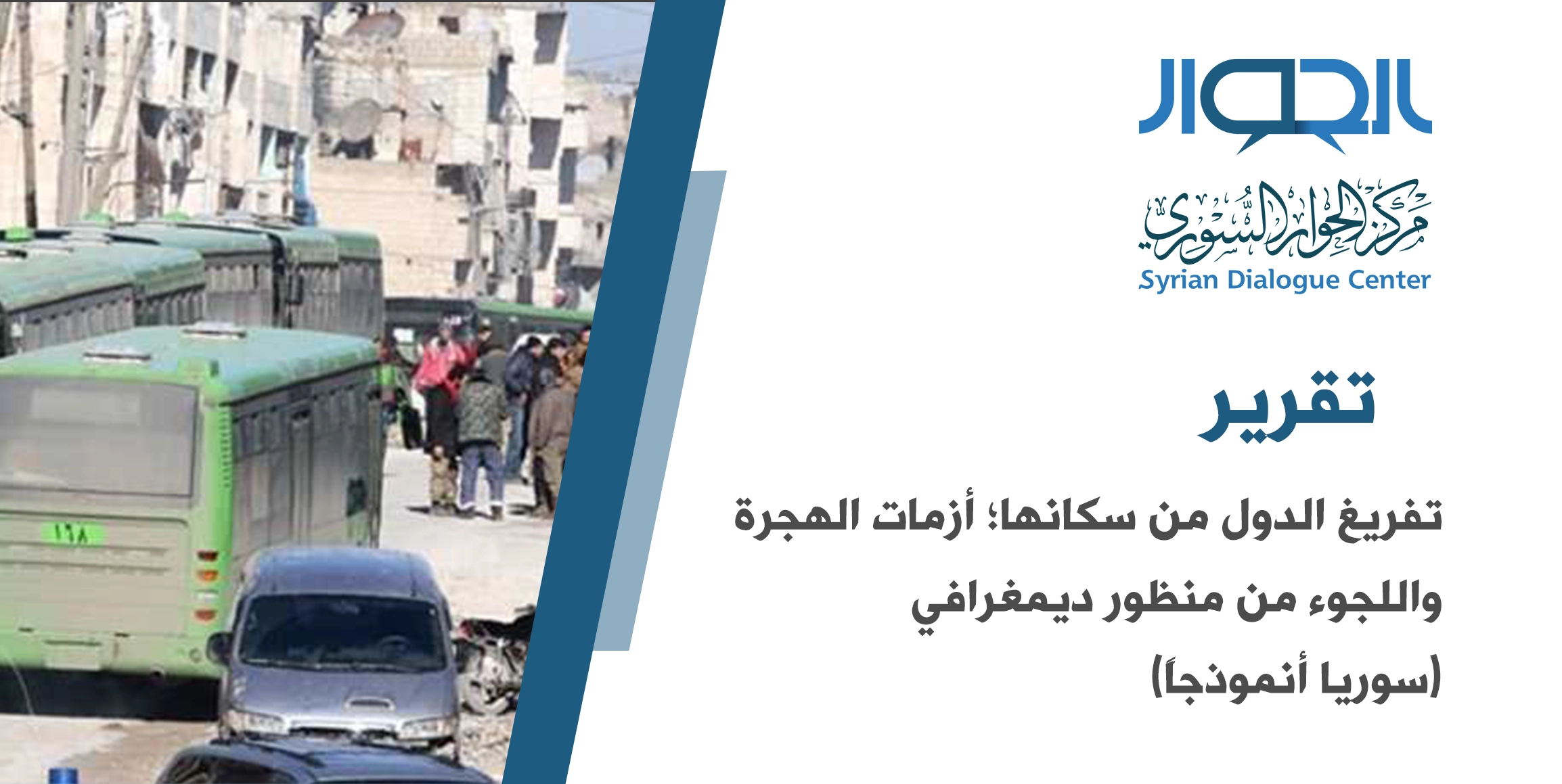
تفريغ الدول من سكانها؛ أزمات الهجرة واللجوء من منظور ديمغرافي (سوريا أنموذجاً)
تقرير من إعداد الوحدة المجتمعية في مركز الحوار السوري ونُشِرَ في التقرير الإستراتيجي
تُعد الهجرة من أقدم الظواهر التي شهدتها المجتمعات عبر العصور؛ بدأت مع ظهور الإنسان، واستمرت ولم تتوقف، وأدّت إلى امتزاج الأعراق والثقافات وتجدُّد الحضارات، وقد تنوعت الأسباب الدافعة للهجرة عامة بين أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، متخذةً أحد نمطَين: نمط الهجرة الطوعية، ونمط الهجرة القسرية.
وقد بدأ الحديث عن الهجرة يأخذ منحى سياسياً مع نشوء الدول القومية؛ إذ قسّم العالم إلى دول وأقاليم، ونُصبت الحدود، وتمايزت الأنظمة السياسية المتنوعة، فحرصت الحكومات على ضبط حدودها والتحكم بأعداد سكانها، وأنشأ بعضها قوانين صارمة نظّمت فيها دخول الأجانب، وجعلت من عملية الهجرة إليها أمراً أكثر صعوبة وتعقيداً؛ فتحولت الهجرة إلى مشكلة وتهديد لأمن بعض الدول أحياناً، أو إلى وسيلة لاستقطاب الكفاءات والعقول التي تبحث عن حياة أفضل وإغرائها بالاستقرار أحياناً أخرى.
غالباً ما تُناقش الهجرة من منظور الدول المستضيفة أو الجاذبة للمهاجرين نتيجة نظامها التعليمي أو الاقتصادي أو السياسي القوي الذي يمكّن الأفراد ويعترف بحقوقهم ويستوعبهم في المسارات المناسبة، في حين يكون التركيز أقل على الدول المصدِّرة للمهاجرين بأنواعهم، وعلى الآثار السلبية التي تخلّفها موجات الهجرة على تلك الدول والأسباب الدافعة لها وتطوير الحلول لمواجهتها، ويغدو الأمر أكثر أهمية حين تصبح الهجرات قسرية تقع ضمن مخططات حكومات معينة لتحقيق أهداف سياسية أو ديمغرافية، كما هي الحال في سوريا.
ولكن قبل الحديث عن واقع الهجرة السورية التي تُعد الأكبر من نوعها منذ الحرب العالمية الأولى والأكثر وضوحاً في تأثيرها الديمغرافي؛ لابد من تسليط الضوء بداية على أهم العوامل المسببة للهجرة داخلياً وخارجياً، خاصة حالات الهجرة الجماعية.
أولاً: العوامل المسبِّبة للهجرة والنزوح واللجوء
تشير الدراسات التخصصية في مواضيع الهجرة والنزوح القسري إلى ثلاثة عوامل تشكل الدوافع الرئيسة الأكثر حضوراً وتسبباً في موجات الهجرة القسرية المعاصرة (الإزاحة)، سواءٌ كانت موجات هجرة داخلية كالنزوح الداخلي، أو موجات هجرة خارجية كاللجوء والهجرة الدراسية أو الاقتصادية، ومن أبرز تلك العوامل[1]:
- الصراعات المسلحة
- الدول الهشّة (تأثير السلطوية والاستبداد).
- تغيُّر المناخ.
1- 1-الصراعات المسلحة
تُعد الحروب والنزاعات المسلحة السبب الرئيسي للنزوح الداخلي والخارجي على مستوى العالم؛ لأنها تتسبب بفرار المزيد من الناس إلى أماكن أخرى داخل البلاد فيُطلق عليهم “النازحون داخلياً”، أو تتسبب بفرارهم خارج البلاد ويُشار إليهم عادةً بأنهم “لاجئون أو طالبو لجوء”.
وقد تراجعت معدلات النزاع والمعارك العسكرية بين الدول؛ إلا أن معدلات النزاعات الداخلية المسلحة ارتفعت وازدادت حالات الصراع التي كانت فيها الحكومة طرفاً في الصراع ضد أحد الجهات المسلحة داخل حدود الدولة[2]، وعلى الرغم من أن أشكال النزاعات الحديثة لم تتسبب بمعدلات وفيات مرتفعة[3]؛ إلا أنها خلّفت أعداداً كبيرة من النازحين والمهجرين قسرياً[4] واللاجئين، وشكّل هؤلاء أزمات إنسانية جادّة ومشاكل أمنية وتنموية امتدّ أثرها خارج رقعة الصراع.

الشكل 1: الصراعات في العالم بين عام 1946-2020، مترجم[5]
العلاقة بين الصراع والنزوح معقدة ومتنوعة؛ فقرار الناس بالفرار وتحديد المكان والزمان قد يكون مدفوعاً بالعديد من العوامل، منها: شدة الصراع، أو العنف ونوعه، وظروف الناس الشخصية، ومكان وجودهم والمناطق المحيطة. وقد يكون النزوح الناجم عن النزاع رد فعل على العنف أو التهديد بالعنف، أو يمكن أن يكون مدفوعاً بعوامل الصراع، مثل جيوش الدولة أو الجماعات المسلحة ما دون الدولة؛ إلا أن الصراع بكل أنواعه وحالاته يخلّف أزمة إنسانية معقدة طويلة الأمد تتعدى حدود الدولة الجغرافية.
وغالباً ما يعيش النازحون داخلياً في مخيمات أو مع عائلات مضيفة، وفي المناطق الحضرية بالقرب من مصدر رزقهم، أو في منازل منفصلة يستأجرونها لأنفسهم، وتُعد سوريا الدولة الثانية عالمياً بعد الكونغو في حجم النازحين داخلياً ضمن مخيمات والذين فاق عددهم 1.8 مليون نازح داخلي، والدولة الأولى عالمياً المصدِّرة للاجئين الذين يُزيد عدد المسجلين منهم بصفة لاجئين عن 6 مليون نسمة.
1- 2-الدول الهشّة (الحكومات المتسلِّطة والمستبدِّة)
يعكس مصطلح “هشاشة الدولة” صورة الدول التي لا تستطيع تلبية شروط الحكم الأساسية لدعم حقوق الإنسان وتهيئة البيئة المناسبة للتنمية، ومؤشر “الدول الهشّة” هو أحد المؤشرات التي تحاول تحديد جودة الحكم في البلدان حول العالم؛ حيث يؤثر نمط الحكم الهشّ الجامد الذي لا يملك مساحات للتغيير ويمارس الاضطهاد المنظم على الشعب، ويُعد أحد الأسباب التي تجبر الناس على الفرار؛ لأن نموذج الحكم المستبد يخلق ظروف العنف المعمم، وحالة من الحرمان من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة ومجموعة من العوامل التي تدفع الناس للبحث عن بديل أفضل للحياة.
لطالما صُنفت سوريا ضمن الدول الأكثر هشاشة وفق المقاييس العالمية منذ سنوات[6]، كما أنها تُدرّس في بعض الجامعات الغربية نموذجاً للدولة الاستبدادية السلطوية التي خلّفت أكبر موجات النزوح بعد الحرب العالمية الأولى؛ إذ إن سياسات الحكومية الفاشلة سبب في زيادة موجات الهجرة الداخلية والخارجية، وأحد الأسباب وراء اندلاع الاحتجاجات الشعبية عام 2011، والتي قُوبلت بالقمع الشديد وأدّت في النهاية إلى حرب شارك فيها عدد من الأطراف الإقليمية والدولية.
1- 3-الأزمة المناخية
لطالما كان التغير المناخي عاملاً مسبباً للهجرات؛ فعلى مرّ العصور تحرَّك البشر في مجموعات بحثاً عن مصادر جديدة للغذاء أو هرباً من الكوارث الطبيعية، وفي القرن الحادي والعشرين كان نزوح السكان نتيجة لتغير المناخ التحدي العالمي البارز، خاصة في حالة التغيرات المناخية البطيئة كالجفاف والتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر وملوحة التربة وغيرها؛ حيث يشير الخبراء إلى وجود علاقة تبادلية بين تغيُّر المناخ وحركات النزوح، فالتغير المناخي يؤثر في سبل عيش الناس، ويزيد من ضعفهم، ويزيد من تعرضهم للنزوح، كما تؤثر موجات النزوح أيضاً في تسريع عملية التغير المناخي واستهلاك الموارد.
ثانياً: العوامل المسبِّبة لحالة النزوح والهجرة واللجوء في سوريا
بالنظر إلى العوامل السابقة التي تسببت في موجات اللجوء والنزوح الداخلي الجماعي نلاحظ اجتماع عدة أسباب أساسية كانت وراء أكبر عملية هجرة داخلية وخارجية شهدتها سوريا والمنطقة في العقود الأخيرة؛ فقد كان وجود سوريا لسنوات طويلة في قمة الدول الأكثر هشاشة أحد العوامل المنذرة بإمكانية حدوث مشاكل جدية، خاصة مع نموذج الحكم المستبد الذي رزح السوريون تحت سلطته مع مجيء حزب البعث، وهشاشة جهود التنمية والتعامل مع الأزمات بأنواعها، والتضييق الواسع في حقوق الإنسان، والقبضة الأمنية وحالة الطوارئ التي استمرت لعقود دون أي مؤشر بانفراج قريب.
شهدت سوريا موجات هجرة داخلية غيّرت تركيبتها السكانية قبل عام 2011؛ فقد انخفضت نسبة سكان الريف من 63% عام 1960 إلى 44% عام 2010، وذلك نتيجة فشل سياسات التنمية في المناطق الريفية وتدهور شروط المعيشة، وانتساب الريفيين -خاصة في المناطق الساحلية- إلى القوات المسلحة، وفشل الحكومات المتعاقبة في التصدي لموجات الجفاف[7].
وقد كانت هذه العوامل السابقة مؤثرة جداً في اندلاع الثورة السورية عام 2011، والتي امتدت من درعا لتشمل معظم المناطق السورية؛ إلا أن ردَّ نظام الأسد على هذه الاحتجاجات الشعبية، ورفضَه التجاوب مع مطالبها أو تقديم أية إصلاحات، ولجوءَه للحل العسكري والاستعانة بالحلفاء الخارجيين كان السبب الرئيس في تحول الاحتجاجات إلى حالة من الصراع المسلح الداخلي الذي استمر حتى عام 2020، ثم تراجعت وتيرة العمليات العسكرية وأصبح ميداناً لتصفية الحسابات وتحقيق المكاسب السياسية بين الدول.
اجتمع في سوريا سببان أساسيان للهجرة الجماعية: نموذج الحكم الهشّ والصراع العسكري؛ فقد تسبب نموذج السلطة الاستبدادي في سوريا بدفع الاحتجاجات السلمية لتتحول إلى شكل من أشكال الصراع العسكري، وهو ما تسبب بظهور عوامل إضافية كانت دوافع قوية وراء هجرة السوريين خارج سوريا لاجئين، أو نزوحهم الداخلي إلى مناطق أخرى.
ومن أبرز هذه العوامل:
2- 1- العوامل الأمنية:
يُعد العامل الأمني من أبرز العوامل التي دفعت السوريين لاتخاذ قرارات سريعة بمغادرة أماكنهم بحثاً عن الأمن، سواءٌ داخل بلادهم أو خارجها؛ فقد ازدادت الملاحقات الأمنية مع اندلاع الثورة السورية، وارتفعت أعداد المعتقلين المدنيين لأسباب مختلفة، وعمل نظام الأسد على تجنيد المخبرين وتشجيعهم على كتابة التقارير من أجل الوصول إلى الناشطين وقيادات الحراك السلمي، وقام بتصفية معظم هؤلاء الناشطين في المعتقلات، وظلَّ البقية في حكم المختفين قسرياً.
حتى الآن لا يتوفر رقم دقيق يوثق حجم الاعتقالات التي قام بها النظام السوري بعد عام 2011، سواءٌ أولئك الذين أُطلق سراحهم أم الذين ما يزالون في حكم المفقودين[8]، وتشير الأرقام الموثقة لدى بعض الجهات الحقوقية إلى أن عدد المعتقلين الموثقين والذين ما يزالون في معتقلات نظام الأسد حالياً يزيد عن 135 ألف معتقل، بينهم نساء وأطفال اعتُقلوا لأسباب سياسية، إما لاشتراكهم في الاحتجاجات السلمية وإما لقرابتهم ببعض المطلوبين. ولا تزال عمليات الاعتقال مستمرة حتى الآن، وتطال بعض الذين وقّعوا على اتفاقيات مصالحة مع نظام الأسد، واللاجئين السوريين الذين تمت إعادتهم قسرياً من لبنان إلى سوريا. والذين خدعتهم دعوات العفو والعودة للوطن التي روّج لها نظام الأسد؛ فرجعوا واختفوا في المعتقلات، مع الإشارة إلى أن مراسيم العفو التي أصدرها نظام الأسد خلال السنوات الماضية استهدفت المتورطين بجرائم وجُنح، ولم تشمل المعتقلين على خلفيات سياسية[9].
إنّ ما أراده نظام الأسد من عمليات الملاحقات الأمنية والانتهاكات الممنهجة التي طالت المعتقلين، والشهادات والرواية التي نُقلت على لسان ناجين ووثّقت أشكالاً متنوعة من الانتهاكات وعمليات التعذيب والإعدامات الجماعية[10] هو إرسال رسالة واضحة تؤكد أن مصير غالبية المعتقلين هو الموت المحتم، وأن احتمال النجاة أو الإفراج أو الحصول على محاكمة ضئيل جداً[11]ـ وهو ما دفع الكثير من الناشطين المدنيين والشباب إلى مغادرة البلاد، أو الانتقال للعيش في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية، خوفاً من الوقوع في أيدي الفروع الأمنية لنظام الأسد.
ومن جهة أخرى كانت عمليات التجنيد الإجباري ضمن قوات جيش نظام الأسد الوجه الآخر لملاحقة الشباب وزجّهم في الصفوف الأولى على الجبهات لمحاربة شركائهم في الوطن، وهو ما تسبب في انشقاق العديد من العسكريين من الجيش[12] وفرار المطلوبين للتجنيد وللخدمة الاحتياطية[13]، وقد كان يتوجب على المنشقين أو الفارّين من التجنيد مغادرة مناطق سيطرة نظام الأسد؛ لأن بقاءهم يعرّضهم للاعتقال والمحاكمات العسكرية أو حتى الإعدامات الميدانية.
لم تكن لعملية التجنيد أو الخدمة الاحتياطية مدة واضحة، بل كان التسريح من صفوف الجيش يعتمد على مزاجية المسؤولين والوساطات، ولا ينتهي قبل انقضاء 3- 4 أضعاف مدة التجنيد الاعتيادية، ورغم تراجع وتيرة العمليات العسكرية إلا أن التجنيد الإجباري ما يزال أهم الدوافع وراء عمليات النزوح الداخلي أو الهجرة، لا سيما للقاطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد؛ فقد دفعت الشباب – حتى الموالين للأسد – للفرار حتى لا يخسروا سنوات حياتهم الذهبية في صفوف جيش الأسد سيئ الصيت[14].
أما على صعيد المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد فقد كان العامل الأمني حاضراً أيضاً ودافعاً للنزوح أو للهجرة، وإن كان مختلفاً عن مناطق سيطرة نظام الأسد؛ فقد تحولت هذه المناطق إلى ما يشبه السجن الجماعي، وتعرضت لحصار وقصف ممنهج وطويل بهدف إجبار هذه المناطق على الاستسلام أو التهجير القسري[15].
لقد أدى التدخل العسكري الروسي عام 2015 إلى تغيير مسار العمليات العسكرية لصالح نظام الأسد، واستخدمت خلال العمليات العسكرية مختلف أنواع الأسلحة كالقنابل العنقودية والارتجاجية، إضافة إلى البراميل والخراطيم المتفجرة، والأسلحة الحارقة والصواريخ المسمارية، والأسلحة الكيماوية بأنواعها، واستهدفت بها تجمعات المدنيين والأسواق والمستشفيات والمدارس ومراكز الدفاع المدني، بهدف إيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية لإجبار قوات المعارضة على تقديم تنازلات، كما جرّبت روسيا أكثر من 320 نوع سلاح مختلف خلال عملياتها في سوريا[16].
وتسببت وتيرة المعارك العسكرية المرتفعة والاستهداف المباشر وحالات الحصار التي فُرضت على المدنيين بإجبار المحاصرين على النزوح داخلياً عدة مرات بحثاً عن مناطق بعيدة عن خط الاشتباك، أو على محاولة الهرب من مناطق الحصار عبر طرق التهريب بحثاً عن مكان آمن أو عن علاج لبعض الإصابات الشديدة، بالإضافة إلى دمار هائل في مناطق الاشتباك.
لقد انتهج نظام الأسد وحلفاؤه سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على الجيوب المعارضة الصغيرة تحت عنوان “الجوع أو الركوع”، من خلال استنزاف الموارد وحرمان المدنيين من الأساسيات اللازمة لحياتهم والتنصل من أية مسؤوليات من أجل إنهاء وجودهم؛ إما بإجبارهم على التهجير القسري باتجاه المناطق الخارجة عن سيطرته في محافظة إدلب وريف حلب[17]، وإما الموافقة على توقيع اتفاقيات مصالحة كما في محافظة درعا وبعض بلدات الغوطة الغربية، ثم التهرب من بنودها لاحقاً والقضاء على كل الشخصيات المعارضة المهمة، سواءٌ من خلال الاعتقال التعسفي أو عمليات الاغتيال.
2- 2- العوامل الخارجية:
أكدت تقارير مبكرة لوزارة الخزانة الأمريكية في أيار 2011 نشاط إيران في سوريا، خاصة “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني الذي أسهم في قمع المظاهرات السلمية، ثم قام الحرس الثوري بعملية تجنيد واستقدام لمقاتلين أجانب ومن بعض الجنسيات العربية للمشاركة في الأعمال القتالية لسنوات تحت ذريعة حماية المراقد، وقُدّرت أعداد المقاتلين الذين جنّدتهم إيران من خارج سوريا بما يقارب 150 ألف مقاتل حتى أواخر عام 2017، قاموا بتعويض النقص العددي في صفوف قوات جيش نظام الأسد[18].
لقد كان استقدام نظام الأسد المقاتلين الأجانب من دول مختلفة كإيران والعراق ولبنان واليمن وباكستان وغيرها مؤشراً على تدويل الصراع وتحوله لخدمة أجندات خارجية؛ لاسيما وأنه ترافق مع إعطاء سلطات واسعة لهؤلاء المقاتلين الأجانب الذين حصلوا على رواتب، واستوطنوا بعض المنازل والأحياء على حساب المقاتلين والضباط السوريين.
وتُعد اتفاقية المدن الأربع “كفريا، الفوعة، الزبداني، مضايا” المثال الأبرز لعملية التغيير الديمغرافي الذي تم برعاية إيرانية وتنفيذ المليشيات الموالية لها وبإشراف الأمم المتحدة ووساطة قطرية[19]؛ فقد نتج عن الاتفاقية نقل أهالي قريتَي كفريا والفوعة “الشيعيتَين” المقدَّر عددهم بـ30 ألف نسمة إلى مناطق القصير الحدودية، وذلك بعد إفراغ مدينتَي الزبداني ومضايا من سكانهما وترحيلهم إلى مناطق الشمال السوري[20].
ومن الملاحظ أن بعض المليشيات غير المحلية استقرت وتركزت في مناطق سيطرت عليها عسكرياً، ومنعت سكانها الأصليين من العودة، كما فعلت مليشيا “حزب الله” اللبناني بالمناطق المتاخمة للحدود السورية اللبنانية، واستخدمت هذه الأراضي في زراعة الحشيش، وفي بعض مناطق ريف دمشق، كما تواردت العديد من الأخبار التي تؤكد قيام نظام الأسد بمنح أعداد كبيرة من المقاتلين الشيعة والعراقيين والأفغان والإيرانيين واللبنانيين الجنسية السورية، وتتراوح التقديرات أن أعداد المجنسين تعدّت المليون شخص على أقل تقدير؛ في محاولةٍ لتثبيت وجود هذه الفئة في سوريا ومكافأتهم على قتالهم إلى جانب نظام الأسد[21].
تزامن استقدام المليشيات الإيرانية أو التابعة لها بزيادة التغلغل الثقافي الإيراني في سوريا في محاولة لتثبيت الواقع الديمغرافي الجديد وإظهاره وكأنه جزء من الثقافة المحلية، ونشطت عمليات التشييع مجدداً تحت ستار الأنشطة الثقافية والإنسانية، التي استغلت حاجة الناس للمساعدة والعمل، فسعت إلى تجنيد الشباب والمراهقين في المليشيات التابعة لها[22]، وإلى استغلال النساء جنسياً تحت ستار زواج المتعة الذي انتشر بشكل واضح في العديد من المناطق، خاصة حلب وريف دمشق[23].
لقد اتبع الحرس الثوري والمليشيات الإيرانية التابعة له عمليات تغيير ديمغرافي ممنهجة، وذلك من خلال استقدام وفود من زوّار المقامات والمراقد وتوطينهم في سوريا، وتشييد المقامات والحسينيات والحوزات الدينية الجديدة والاستيلاء على بعض الأوقاف السنّيّة، وتغيير معالم المناطق والأحياء والمساجد لأسماء شيعية وإزالة كل ما له علاقة بأسماء الصحابة، بالإضافة إلى شراء العقارات بشكل غير مباشر من السكان عبر وسطاء، وإعادة توطين عائلات شيعية عراقية في بعض المناطق الاستراتيجية، وإعطاء وعود صريحة من “حزب الله” لعناصره بأن تكون لهم حصة في المنطقة بعد إعادة الإعمار، فضلاً عن إقامة المربعات الأمنية ومنع السكان الأصليين من العودة[24].
كل ذلك أدى إلى تغيير هوية المكان وهوية أفراده، وإلى تمركز المليشيات الشيعية والمراكز المدنية التابعة لها في أحياء جديدة؛ وهذا ما جعل السكان الأصليين يشعرون بالغربة في أرضهم، ويتحيّنون الفرصة لمغادرة مناطقهم، لاسيما مع تحوُّل تلك المقرّات إلى مراكز تُقام فيها أنشطة غير مشروعة، كتهريب السلاح والذخائر وتصنيع المخدرات، يمكن استهدافها عبر الغارات “الإسرائيلية” بشكل دوري.
2- 3- العوامل الاقتصادية
تراجعت وتيرة العمليات العسكرية بشكل واضح في نهاية عام 2018 بعد استرجاع نظام الأسد بمساعدة حلفائه غالبية المناطق الخارجة عن سيطرته، وتوقع الناس تحسُّن الأوضاع الاقتصادية بعد أن حقق نظام الأسد ما أسماه “الحسم العسكري”؛ إلا أن جمود العمليات العسكرية ترافق مع انهيار اقتصادي حادّ وأزمات اقتصادية خانقة، وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة وتأثيرات الصراع العسكري، وسيطرة حلفاء الأسد – إيران وروسيا – على الثروات والاستثمارات السورية بعقود طويلة الأمد، فضلاً عن خسارة نظام الأسد منابع النفط التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من أمريكا.
لقد شهدت البلاد أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تراجع الخدمات الرئيسة، خاصة بعد جائحة كورونا والتضخم الاقتصادي العالمي والحرب الروسية الأوكرانية، فخسرت الليرة السورية منذ عام 2019 أكثر من 750% من قيمتها، وأصبح أكثر من 90% من السوريين يعيشون منذ عام 2020 تحت خط الفقر، في حين يعاني 12.4 مليون فرد سوري من انعدام الأمن الغذائي؛ الأمر الذي زاد إقبال مَن بقي من السوريين -ذكوراً وإناثاً – على الهجرة رغبة في الحصول على حياة أفضل[25].
أصبحت الإمارات ومصر وإقليم كردستان العراق الوجهات الأكثر حضوراً في هجرة السوريين، إضافة إلى الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، والمحافظات الشرقية السورية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”؛ إذ تشير إحدى الدراسات إلى تسهيل نظام الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين عملية الهجرة رغبة منهم بالسيطرة على ما تبقى من ثروات السوريين، وإجراء تغيير ديموغرافي من خلال هجرة المكوّن السّنّيّ والضغط على الدول الأوروبية والعربية[26].
ثالثاً: انعكاسات التغيير الديمغرافي الحاصل في سوريا محلياً
تسببت تحرُّكات السوريين خلال العقد الماضي داخل سوريا وخارجها – نتيجة للظروف والأسباب السابقة – بتغيرات واضحة في البنية الديمغرافية ونوعها وشكلها، مما كان له انعكاسات سلبية وتأثيرات في حاضر سوريا ومستقبلها، ويمكن إجمال هذه الانعكاسات بما يلي:
3- 1- سوريا المفيدة؛ إعادة التوزيع وفقاً للولاء السياسي:
أعلن بشار الأسد عام 2016 عمّا أطلق عليه اسم “سوريا المفيدة”، وضمّت هذه المنطقة كلّاً من محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس، بما يعادل 40% من مساحة كامل سوريا؛ حيث يُلاحظ أن هذه المناطق تستأثر بالإطلالة على المتوسط، وينحصر فيها انتشار العلويين والشيعة، كما تضم 46% من مجموع سكان سوريا[27].
وبالنظر إلى خط ومسار العمليات العسكرية وعمليات التهجير نجد أنها هدفت إلى إعادة تشكيل هذه المنطقة وإخلائها من المعارضين أو حتى ممن يُشتبه بولائهم[28]، وترويع مَن تبقى منهم أو قبِل بتوقيع المصالحات، وذلك من خلال الاعتقالات العشوائية وعمليات الاغتيال والتجنيد الإجباري؛ وبهذا كان معيار الولاء السياسي حاضراً بقوة في إعادة تشكيل خريطة سوريا الجديدة، بما يضمن التخلص من الأصوات المعارضة أو تلك التي تطالب بتغيير حقيقي وإبعادها عن المدن والمحافظات الاستراتيجية.
3- 2- الهندسة الديمغرافية؛ إعادة توزيع الأقليات:
استهدف نظام الأسد تهجير السنّة بشكل رئيسي؛ إذ كانت جميع العمليات العسكرية في مناطق تمركزهم، في حين بقيت مناطق تمركز الطائفة العلوية -التي تنتمي إليها عائلة الأسد والمسؤولون المقربون منه- شبه آمنة، خاصة طرطوس ومدينة اللاذقية، ولم تكن عملية إعادة الهندسة الديمغرافية عشوائية، وإنما صاحبتْها عمليات تهجير ممنهجة طالت سكان عدد من قرى محافظة حماة، وأحلّت محلَّهم عائلات من الطائفة العلوية، كما أدى الاستهداف لقرى جبلَي التركمان والأكراد إلى نزوح 95%من سكانهما، وهي مناطق تقطع خطوط الاشتباك مع المعارضة السورية[29].
لم يكن نظام الأسد وحده مَن استثمر الصراع لإعادة الهندسة الديمغرافية؛ فقد قامت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تشكيل المنطقة كمنطقة ذات أغلبية كردية، من خلال عملية تهجير ممنهج طالت بعض القرى العربية في المنطقة بعمليات اعتقال وملاحقة وقتل على الهوية[30]. وترى مواقع موالية لـ”قسد” وبعض الجهات الأوربية أن عملية غصن زيتون التي شنّتها فصائل المعارضة السورية بالتعاون مع الجيش التركي لطرد القوات الانفصالية وتحرير عفرين فيها إزاحة للمكوّن الكردي من المنطقة[31].، حيث تمركزت فيها مجموعات كبيرة من المهجَّرين من الغوطة المحسوبين على المكوّن العربي[32].
3- 3- إعادة توزين بعض الأقليات؛ زيادة مضطردة في أعداد الشيعة:
مع البُعد الطائفي الواضح الذي تسبب به التدخل الإيراني والمليشيات الشيعية التي استقدمتها للقتال، ثم قيام نظام الأسد بتجنيس هؤلاء المقاتلين الشيعة مكافأة لهم على دعمهم، خاصة بعد تصريحه الشهير “سوريا لمن يدافع عنها، وليس لمن يحمل جوازها”[33] لُوحظ ارتفاع واضح في نسبة المكوّن الشيعي في سوريا مقارنة ببقية المكونات العرقية والدينية التي أخذت أعدادها بالتناقص[34].
تغيب الإحصائيات الرسمية المحدَّثة حول واقع التوزع الديمغرافي الجديد الذي خلّفته سنوات الصراع؛ إلا أن إحدى الدراسات المتاحة أشارت إلى أن عدد سكان محافظات “سوريا المفيدة” قد انخفض بين عامي 2011-2016 بنسبة 22%، وأن هذا الانخفاض ليس مجرد انخفاض عددي، بل كان يحمل تغيرات واضحة في المكونات الطائفية لسكان هذه المناطق؛ فقد انخفضت نسبة السّنّة بمقدار 17%، وارتفع عدد السكان الشيعة بنسبة 12%، بينما ارتفعت نسبة العلويين 3%، وبقيت نسب بقية الطوائف عند النسب السابقة نفسها وإن قلت أعداد أفرادها[35].
ويُظهر الجدول التالي انخفاضاً واضحاً في عدد السكان السّنّة في مناطق سيطرة نظام الأسد، خاصة في محافظتَي حمص وريف دمشق بشكل كبير اللتَين شهدتا عمليات عسكرية وحملات اعتقالات مستمرة، كما تراجعت نسبة المكوّن السّنّيّ بدرجة أقل في بقية المحافظات التي لم تشهد عمليات عسكرية. وفي الوقت نفسه تشير النتائج إلى ارتفاع واضح وملموس يصل إلى أكثر من 10 أضعاف في نسبة الشيعة، حيث ظهرت الزيادة في أعداد الشيعة في المحافظات ذاتها (حمص وريف دمشق) بدرجة أوضح، ثم دمشق وطرطوس. في حين انخفضت نسبة العلويين بشكل طفيف، إلا أن هذا الانخفاض خادع؛ فرغم خسارة العديد من الشباب العلوي خلال المعارك إلا أن نسبتهم ثابتة في تلك المناطق مقارنة ببقية الطوائف التي شهدت تراجعاً واضحاً[36].
| محافظات سوريا المفيدة | التغيُّر في نِسب بعض المكوّنات في منطقة “سوريا المفيدة”[37] | ||||||||
| سنّة | علوية | شيعة | |||||||
| 2011 | 2016 | التغير | 2011 | 2016 | التغير | 2011 | 2016 | التغير | |
| دمشق | 90% | 81% | -9% | 5% | 4% | -1% | 1% | 12% | 11% |
| ريف دمشق | 87% | 54% | -33% | 4% | 7% | 3% | 1% | 24% | 23% |
| حمص | 64% | 21% | -43% | 25% | 37% | 12% | 2% | 28% | 26% |
| حماة | 67% | 61% | -6% | 17% | 19% | 2% | 1% | 1% | |
| اللاذقية | 37% | 26% | -11% | 58% | 63% | 5% | 2% | 5% | 3% |
| طرطوس | 18% | 13% | -5% | 69% | 67% | -2% | 5% | 5% | |
| الكلي | 69% | 52% | -17% | 21% | 24% | 3% | 1% | 13% | 12% |
وبالنظر إلى الارتفاع الواضح في نسبة الطائفة الشيعية حتى عام 2016 يبدو واضحاً أن هذا الارتفاع يعود إلى إحلال عناصر شيعية خارجية محلّ المكون السوري النازح أو المهجَّر؛ فمن غير المنطقي أن تثمر جهود التشييع في هذه السنوات العصيبة التي كانت العمليات العسكرية محورها الرئيسي هذه الزيادة السريعة، ولذا فإن التفسير الوحيد لهذا الارتفاع هو تجنيس المقاتلين الشيعة الذين قدموا إلى سوريا، ومنحهم حق الاستقرار في مناطق النازحين والمهجَّرين.
لقد حقّق نظام الأسد خطوات متقدمة في تنفيذ خطته الاستراتيجية، مستخدماً “سوريا المفيدة” هدفاً مرحلياً تكتيكياً؛ ابتداءً بالتركيز على المدن الكبرى، ثم استثمار الحصار والعمليات العسكرية لعقد الهُدن المنفردة على مستوى الأحياء والبلدات، وإحراق سجلات الملكية ومنع السكان من العودة إليها، وإفراغ بعض المناطق وإحلال عائلات شيعية لبنانية وعراقية، وإبرام اتفاقيات تهجير[38].
ومما يؤكد سياسة إعادة الهندسة الديمغرافية التي تخدم تثبيت الواقع والمكونات الجديدة قيامُ قوات نظام الأسد بتفريغ إجباري لمناطق معينة، وتغيير تركيبتها السكانية قسراً، كالضفة الجنوبية الشرقية من نهر الفرات ومناطق داريا والحدود اللبنانية، وذلك بهدف خلق رابط جغرافي يمتد من إيران مروراً بالعراق ثم سوريا ولبنان، وإسكانه مكونات علوية أو شيعية أو متشيعة، وافتتاح منظمات تقوم بعمليات تسهيل شراء المنازل وإعادة بناء المساكن التابعة لقوات الأسد والمليشيات الإيرانية، والضغط على سكان المناطق للتشيع[39].
كما فرض نظام الأسد على مَن يرغبون بالعودة إلى مناطقهم استخراج موافقة أمنية مسبقة كشرط أساسي للعودة، وسُجلت حالات اعتقال وإخفاء قسري وعمليات تجنيد إجباري بحق مَن تمت الموافقة على عودتهم للضغط عليهم، بالإضافة إلى مضايقة مَن بقي من السكان وابتزازهم، في محاولةٍ لدفعهم لمغادرة منازلهم. وهي السياسة ذاتها التي تم اتباعها مع الأفراد والمناطق التي وقّعت اتفاقيات مصالحة بضمانات روسية وشهدت حملات تجنيد إجباري، وتم الزجّ بأفرادها على خطوط الجبهات الأمامية، ومُنع الأهالي فيها من ترميم منازلهم، وحُرمت هذه المناطق من إعادة الخدمات، وقامت بعض الجهات الرسمية بهدم المباني القائمة بحجة تدمير الأنفاق؛ حيث تشير التقارير إلى أن العديد من المباني التي تم تهديمها كانت سليمة، وإنما تم هدمها لتحضير المنطقة للمشاريع الجديدة وإبعاد سكانها الأصليين عنها[40].
3- 4- تغيُّر نوعيّ وعدديّ في الهرم السكاني:
أسهمت العمليات العسكرية والهجرات الداخلية والخارجية بتغيُّر عدديّ ونوعيّ في الهرم السكاني؛ فقد انخفض عدد سكان سوريا 10 ملايين نسمة على الأقل بين لاجئٍ ومتوفى ومختفٍ قسرياً[41] على أقل تقدير، تركزت هذه الخسارة بشكل أساسي في الشرائح العمرية بين 15-39 عاماً، وهي الشريحة المنتجة التي انخفضت بنسبة 5% من إجمالي عدد السكان، وبين الذكور على وجه التحديد[42].
كما تشير الأرقام إلى أن الصراع العسكري ونتائجه تسببت بخسارة إضافية تُقدر بما يزيد عن 9.2 مليون سوري في عدد السكان كان من المفترض أن يصل إليها التعداد السكاني في سوريا لو لم يندلع الصراع، ويُتوقع أن يرتفع حجم الخسارة البشرية عام 2030 ليُقدر بـ 12 مليون سوري؛ نظراً إلى ضعف معدلات العودة إلى سوريا والرغبة في الهجرة، وارتفاع معدلات الوفيات بزيادة قدرها 60%عن معدل الوفيات الخام قبل عام2011، وذلك بسبب انتشار جرائم القتل وتفشّي العنف وفقدان الأمن، بالإضافة إلى الوفيات التي نتجت بشكل غير مباشر نتيجة ضعف الخدمات الصحية، ونقص الغذاء الحاد وتدهور الحالة المعيشية وعدم القدرة على تلقي الخدمات والحصول على سكن لائق[43].
| التغيرات العددية والنوعية في الهرم السكاني في سوريا | |
| انخفاض عدد سكان سوريا نتيجة الهجر ة واللجوء والقتل والاختفاء القسري | 10 مليون نسمة |
| الخسارة في الشرائح العمرية بين 15-39 عاماً | 5% من إجمالي عدد السكان |
| الخسارة في عدد السكان التي كان من المفترض الوصول إليها عام 2023 لو لم يندلع الصراع | 9.2 مليون نسمة[44] |
| الخسارة المتوقعة في عدد السكان التي كان من المفترض الوصول إليها عام 2030 لو لم يندلع الصراع | 12 مليون نسمة |
| ارتفاع معدلات الوفيات عن معدل الوفيات الخام قبل عام2011 نتيجة الوضع العام الأمني والصحي | 60% |
| خسارة اليد العاملة | 5 مليون عامل |
ويرى بعض الخبراء أن التحولات الديمغرافية التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية تشبه التحولات التي حدثت في بعض الدول التي شاركت في الحربَين العالميتَين الأولى والثانية؛ فالخلل لم يقتصر على مستوى التركيب العمري، وإنما امتد على مستوى التركيب النوعي للسكان، فانخفضت نسبة الذكور إجمالاً، وانخفضت بشكل ملحوظ ضمن فئة القادرين على العمل[45].
3- 5- فقدان الكفاءات كمّاً ونوعاً:
تجلّت تبعات الهجرة الخارجية التي ارتفعت معدلاتها بشكل مضاعف في أنها أثّرت على الكفاءات والعقول والخبرات الشابة التي كان يفترض أن تسهم في عملية إعمار البلاد، وليست هجرة الكفاءات من سوريا ظاهرة جديدة؛ فقد احتلت سوريا عام2010 المرتبة 77 عالمياً والمرتبة الخامسة بين الدول العربية الطاردة للكفاءات العلمية حسب مؤشر هجرة الأدمغة المعتمد وفقاً لبيانات البنك الدولي بـ 6.6 نقطة على المؤشر؛ إلا أن هذه الهجرة باتت أكبر وأوضح كمّاً ونوعاً في العقد الأخير، فأصبحت سوريا عام 2022 في المرتبة 11عالمياً والثالثة عربياً بعد فلسطين والصومال بـ 8.1 نقطة على المؤشر نفسه[46].
وتشير أرقام المكتب المركزي للإحصاء في سوريا إلى أن “الاقتصاد خسر خلال سنوات الحرب 5 مليون عامل في القطاعين العام والخاص، كما تراجع عدد الخريجين من الجامعات والثانويات المهنية ومراكز التدريب والعائدين من الإيفاد، وبلغ حدوده الدنيا عام 2018 بعدد لم يصل إلى 100 ألف خريج، وهو ما يشكّل خسارة 5% من القوة العاملة”[47].
وتشير دراسة صادرة عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» إلى أن الموجة الكبيرة من الهجرة واللجوء إلى خارج سوريا منذ 2011 شملت لأول مرة شباباً وأطباء ومهندسين وعلماء وفنانين وأساتذة جامعات ومهنيين من مختلف المناطق، استقبلت ألمانيا وحدها أكثر من 40% من هؤلاء من أصحاب المؤهلات العالية، إضافة إلى أعداد أقل اتجهت إلى بقية البلدان الأوروبية والولايات المتحدة وكندا، حيث كانت الخسارة في كوادر القطاع الصحي والمهندسين والأكاديميين واضحة جداً، دون وجود أي تدخل حكومي لوقف هذا النزيف[48].
3- 6- إمكانية تجدُّد النزاع، وسيناريو التقسيم:
رغم التراجع الملحوظ في وتيرة العمليات العسكرية منذ عام 2020، وارتفاع معدلات الهجرة الداخلية والخارجية؛ إلا أن من اللافت زيادة عدد القواعد العسكرية التابعة لإيران ومليشياتها في سوريا، رغم ارتفاع معدلات الضربات العسكرية “الإسرائيلية” التي استهدفت هذه القواعد، في حين لم تُلاحظ زيادة ملموسة في عدد القواعد العسكرية الأجنبية الأخرى، كالقواعد الروسية أو التركية أو حتى قواعد قوات التحالف الدولي في سوريا.
وتعكس هذه الزيادة وجود سياسة تسعى إلى استثمار الصراع العسكري وإطالة أمده وتعزيز شكله الطائفي، والاستعداد للمرحلة القادمة من خلال استقدام المزيد من المقاتلين وتجنيسهم وإعدادهم للاستقرار طويل الأمد؛ وذلك لتثبيت الوضع الراهن، خاصة ما يتعلق بتوطين المجموعات الشيعية الجديدة، حيث تصبح هذه القواعد العسكرية بمثابة ضمان يؤمّن وجودها ويعزّز سلطتها في المنطقة، لاسيما مع نمو أنشطة التجنيد عند تلك المليشيات واستقطابها المزيد من الشباب والمراهقين، وتقديم إغراءات مالية ورواتب مرتفعة ومساعدات وبطاقات أمنية تسمح لهم بحرية التجوّل والحماية.

الشكل 2 : تغيُّر عدد القواعد العسكرية التابعة للمليشيات الإيرانية واللبنانية[49]
لقد فرضت سياسة إعادة الهندسة الديمغرافية حالة من التغيير القسري غير المستقر (كما في الحالة الفلسطينية)؛ حيث أدت إلى استقواء قوات سورية الديمقراطية “قسد” -التي تمثل إلى حدّ ما الأقليات الكردية- بالولايات المتحدة الأمريكية، وإلى إحلال مكوّن شيعي ذي طبيعة عسكرية وزيادة أعداده بشكل مطّرد وقسريّ، مما يشير إلى ارتفاع احتمالية تجدُّد الصراع العسكري وصولاً إلى الحسم، وصعوبة الوصول إلى حالة من الاستقرار، كما يُنذر هذا بموجات هجرة جديدة وتغيرات مستقبلية قد تطال مناطق سيطرة المعارضة ذات المكون السّنّيّ على وجه الخصوص؛ وعليه فإن السيناريوهات المستقبلية في سوريا تشير إلى احتمالية حدوث تغيُّر جديد في التركيبة الديمغرافية، أو الاتجاه نحو شكل من أشكال التقسيم.
3- 7- أزمة اقتصادية بيئية:
أدّت تلك الحركة البشرية والإزاحة السكانية إلى تمركز أعداد كبيرة من السكان في مناطق لا تملك البنية التحتية اللازمة أو في مناطق زراعية، كمحافظة إدلب على سبيل المثال، والتي ارتفعت فيها الكثافة السكانية 4 أضعاف؛ مما أدى إلى استهلاك الموارد الطبيعية في المنطقة بشكل جائر وعشوائي وغير منظم، وتحولت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى مخيمات ومحاضر سكنية تجاوباً مع الاحتياج الكبير للإيواء[50].
كما برزت أزمة واضحة في تأمين مياه الشرب والصرف الصحي والاحتطاب الجائر وتحقيق الأمن الغذائي في تلك المناطق، خاصة مع محاصرتها وحرمانها من الوصول إلى الموارد المائية أو المحاصيل المنتجة في مناطق أخرى، أو استئثار بعض الفئات ببعض الثروات الباطنية بشكل منفرد، خاصة الحقول النفطية التي تفرّدت قوات “قسد” بالسيطرة على عائداتها.
ومن جهة أخرى أسهمت عمليات الهجرة والنزوح بتراجع أعداد السكان في بعض المحافظات الزراعية، وبتراجع الإنتاج الزراعي، خاصة في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية، كالزبداني والغوطة الشرقية وريف حمص وسهل الغاب وغيرها؛ فقد أُجبر أصحابها على مغادرتها وتُركت مهملة دون رعاية أو متابعة، أو استولت عليها بعض المليشيات واستثمرتها في زراعة الحشيش، أو قام أصحابها ببيعها للمستثمرين على عجل لتأمين كلفة الهجرة والرحيل؛ وهو ما تسبب بخللٍ في استهلاك الموارد الطبيعية والاقتصادية.
رابعاً: انعكاسات التغيير الديمغرافي الحاصل في سوريا عربياً وعالمياً:
لم يعد الصراع السوري بتداعياته وتعقيداته المختلفة شأناً محلياً، بل تحول إلى صراع بالوكالة تحركه مصالح فواعل أجنبية مباشرة وغير مباشرة، وباتت سوريا مسرحاً لتصفية الحسابات، وبات سكانها وقوداً لهذه المعارك، ولئن كانت إشكالية التغير الديمغرافي الكمي والنوعي والإثني شأناً سورياً داخلياً فإن ارتداداته ستشمل المنطقة العربية والساحة العالمية، خاصة بعد انتزاع سوريا من عمقها العربي وتقريبها إلى “الهلال الشيعي”.
لقد تمكنت إيران من إحكام نفوذها على مفاصل السلطة في سوريا، واستثمرت في ثروات البلاد الطبيعية والبشرية، وسعت منذ أعوام إلى استقطاب الآلاف من المقاتلين الأجانب “الشيعة ” وتمكينهم، وإلى استقطاب السوريين في مشروعها والعمل على تشييعهم وتجنيدهم لتزيد بذلك أعداد العناصر المؤدلجة التابعة لها، ممن يمكن استثمارهم واستخدامهم في صراعات عسكرية لاحقة قد تطال بلداناً جديدة.
ومن الصعب اعتبار التغير الديمغرافي الحاصل في سوريا أمراً عارضاً غير مخطط له، خاصة مع وجود العديد من الأدلة التي أشرنا إليها سابقاً وتؤكد وجود سياسات ممنهجة استهدفت المكوّن السّنّيّ وأجبرته على المغادرة، وقامت بإحلال مكوّن شيعيّ أجنبيّ محلّه امتلك من المزايا ما يجعله أسيراً للجهة التي وظّفته، ومرتهناً بقرارها.
ومن جهة أخرى يُنذر هذا التغيير الديمغرافي بإشكاليات حقيقية ستؤثر بشكل جدّيّ في مستقبل سوريا؛ فهذا التغيير ذو الطابع السياسي والإثني يعني أن أي تصويت أو عملية سياسية قادمة لن تمثل مطالب السوريين الحقيقية، لاسيما وأنها ستميل لصالح الفئات الجديدة التي تم تمكينها في المنطقة، ولربما تفرز قيادات مستقبلية تدير شؤون البلاد، كما حدث في العراق.
كما أن السياسات التي تبنّاها نظام الأسد من حصار وتجويع وملاحقة وإخفاء قسري حرمت العديد من السوريين وأبنائهم من الحصول على وثائق رسمية معترف بها دولياً؛ لأن الحصول على هذه الوثائق له تبعات أمنية، إلى جانب تبعاته المالية المرتفعة؛ فهناك شرائح واسعة من السوريين ليس لهم أية قيود أو سجلات رسمية معترف بها توثق حالات الولادة والزواج والطلاق والبيوع والشراء وغيرها، ولم يبدأ بحقهم أي مشروع للإحصاء والمتابعة، وهم محرومون من حقوقهم المدنية في الإرث والأملاك والانتخاب والمشاركة السياسية الحقيقية، بينما حصل آخرون من المقاتلين الأجانب وعائلاتهم على الجنسية السورية، فحلّوا محلهم واستولوا على أملاكهم وتمتعوا بحقوقهم.
وفي الوقت الذي قدّمت فيه الدول العربية مغريات لنظام الأسد، وتغاضت عن جرائمه، وقبلت بعودته إلى الجامعة العربية على أمل إبعاده عن الحليف الإيراني وكبح جماح تجارة المخدرات التي يديرها مع حلفائه، وقدّمت له مساعدات مالية تساعد البلاد على التعافي الجزئي؛ فإن هذه الخطوات لا تبدو قادرة على تحقيق ذاك الهدف، فالنفوذ الإيراني الاقتصادي والسياسية والعسكري يزيد يوماً بعد يوم، والليرة السورية تشهد انهياراً حادّاً إضافياً بعد انطلاق عمليات التطبيع، وعمليات إنتاج الكبتاغون وتهريبه إلى الدول العربية خاصة ما زالت نشطة قوية؛ وهو ما يشير إلى أن تلك الخطوات العربية لم تقدم حلولاً ذات فائدة، بقدر ما أفادت نظام الأسد وحلفاءه بشكل غير مباشر.
كما لا يُتوقع أن تتراجع معدلات الهجرة الداخلية والخارجية من سوريا نتيجة الوضع المتردي وانعدام أي أمل بالتغيير، ولا يُتوقع نجاح مساعي الدول الإقليمية بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم طالما أن الأسباب التي دفعتهم للمغادرة ما تزال قائمة، بل تتفاقم وتزداد يوماً بعد يوم، وهو ما يعني أن على دول الجوار والدول العربية والغربية توقع موجات مستمرة من المهاجرين غير الشرعيين، خاصة مع الاعتماد على الحلول المجتزأة وغياب حل شامل يعالج المشكلة من جذورها.
بالنظر إلى تجارب مشابهة في العراق وفي لبنان يمكن القول: إن سوريا تحولت إلى بؤرة توتر تعكّر استقرار المنطقة، وتشير إلى إمكانية تجدد الصراع واندلاع مشاكل جديدة تهدّد دول الجوار، كتجارة الكبتاغون التي أصبحت مصدر قلق عالمي، وعمليات خطف الرعايا العرب والأجانب وابتزاز عائلاتهم وحكوماتهم، أو تحول هذه المليشيات التابعة لإيران -سواءٌ كانت مليشيات محلية أو مليشيات تم تجنيسها- لاستهداف دول عربية وتهديدها وإثارة مشاكل مفتعلة جديدة لا يمكن توقعها؛ فقد برع نظام الأسد في العقود السابقة في تصدير مشاكل للمنطقة وتقديم نفسه على أنه الوحيد القادر على حلها.
ولهذا يُفترض على المجتمع الدولي عامة والدول العربية خاصة إعادة النظر في سياساتها السابقة، والنظر إلى تداعيات الصراع السوري بشكل استراتيجي، بعيداً عن المصالح السياسية الضيقة والآنية، وإنتاج المزيد من الدراسات والأبحاث التي تركز على ماحصل في سوريا وأسبابه ونتائجه، والاستفادة من الدروس والتعلم من الأخطاء، والعمل على احتواء ومعالجة التداعيات السلبية له؛ حتى لا تتكرر وتتفاقم بشكل مستقبلي يصعب احتواؤه.
حملات النزوح والتهجير القسري بين عامي 2016-2018، فريق “منسقو الاستجابة الإنسانية”، تاريخ النشر 23/09/2018.
مديرة الوحدة المجتعية في مركز الحوار السوري، بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة دمشق، ماجستير في حماية اللاجئين والهجرة القسرية من جامعة لندن، باحثة مهتمة في قضايا المرأة والهجرة والمجتمع المدني





