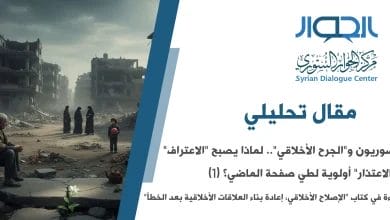نواب البرلمان والشعب.. كيف نُصحّح العلاقة ونُعزّز الشرعية؟
مقال تحليلي صادر عن الوحدة المجتمعية في مركز الحوار السوري
شهدت سوريا في نهاية أيلول وبداية تشرين الأول للعام 2025 انتخابات للمجلس التشريعي السوري “مجلس الشعب” الأول بعد سقوط نظام الأسد البائد، وقد تمت هذه العملية وفق نظام هجين متفرّد تم اختياره ليناسب وضع البلاد، إذ تم انتخاب 119 عضواً من قبل ممثلين عن الشعب “الهيئة العامة” والذين بلغ عددهم قرابة 7000، في حين ينتظر السوريون قائمة تعيينات الرئيس التي تضم 70 اسماً ليكتمل عدد الأعضاء ويباشروا في عملهم[1].
ورغم أهمية هذه الخطوة، وبعض المشاكل والتحديات التي اعترت إدارة العملية الانتخابية، إلا أن المشكلة الأبرز التي تتطلّب المزيد من الاهتمام هي كيفية إصلاح العلاقة بين نواب المجلس والشعب الذي لم ينتخبهم في هذه المرحلة، خاصة أن شرائح من السوريين لم تُلِم بالآلية المعقّدة التي جرت بها هذه العملية، واستغربت عدم إجراء الانتخابات بشكلها الاعتيادي، وكانت ردّات فعلها تُظهر انزعاجاً وتعتبر أن الأمر برمّته لا يعنيها لأنها لم تقم بأدوارها الحقيقية في اختيار ممثليها[2]، بالإضافة إلى أن نتائج الانتخابات لم تفرز تمثيلاً لمختلف الشرائح والمناطق، وهو ما يجعل مهمة اختيار القائمة الخاصة بالرئيس أصعب.
حدود العلاقة بين نواب المجلس التشريعي والشعب:
يُعتبر المجلس التشريعي أحد الأجسام الرئيسية في الدولة المدنية الحديثة، إذ يُمثّل بوصفه “السلطة التشريعية” سلطة الشعب وأدواره في إقرار التشريعات وفي مساءلة الجهات التنفيذية وتحقيق حالة من المشاركة الشعبية، بمعنى آخر فإن مهمة النائب المنتخب تتحوّل إلى الوساطة بين مؤسسات الدولة والمجتمع لتعديل السياسات والقرارات ونقل الاحتياجات والشكاوى، والرقابة على الأداء وتحقيق الشفافية، والتواصل مع مختلف فئات الشعب والسماع لشكواها ومقترحاتها، وإن نجاح النواب في مثل هذه المهام تزيد من شرعية عمل المجلس وتُعزّز الثقة بين النائب والجمهور. وبما إن أغلب الأنظمة الانتخابية تُراعي تمثيل مختلف المناطق والمكوّنات، إلا أن النائب الفائز بالانتخابات لا يكون ممثلاً سياسياً لدائرته أو منطقته فحسب، بل يصبح ممثلاً للشعب بأكمله سواء من كانوا في دائرته أم خارجها.
وفي المراحل الانتقالية، يصعب اختيار مجلس تشريعي بالطريقة التقليدية ما يستدعي حلولاً أخرى معروفة، كالتعيين الكامل للأعضاء من قبل السلطة الحاكمة أو اختيار نظام هجين يجمع بين الانتخاب والتعيين، وتسمح كلتا الحالتين بحل هذه الإشكالية ولكنها تنتج مجلساً تشريعياً بشرعية أضعف عن الحالة النموذجية التقليدية لغياب حالة الاختيار الحر والتفويض الشعبي والمنافسة العادلة، وبالتالي تتزعزع العلاقة التقليدية بين النائب والشعب، ويغيب مفهوم “الوكالة العامة” التي يمنحها المواطنون لممثليهم عبر الانتخاب لصالح “الوكالة السياسية” للنظام الانتقالي أو الجهة التي اختارت النائب، وتصبح عملية المساءلة أصعب وخاصة للجهات التي قامت باختيارهم وتعيينهم والتي قد يحرص على إرضائها أكثر من إرضاء الشعب.
ونتيجة لذلك يحتاج النواب عملاً دؤوباً إضافياً لتعزيز الشرعية الشعبية وإعادة بناء علاقات الثقة والشفافية وتصحيح أدوار هذا المجلس في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة خاصة أنها تُؤسِّس للمراحل التالية، والعمل على إنجاح التجربة وأداء المهام المنوطة في وسط عوامل تجعل حالة الإخفاق واردة.
مجالس تشريعية في مراحل انتقالية.. تجارب ودروس:
تقدم تجارب الدول العربية نماذج مختلفة عن مجالس تشريعية أنشأت في فترات انتقالية، حيث يمكن من خلالها استخلاص التجارب وتعلُّم الدروس خاصة مع تشابه ظروف سياسية واجتماعية مع الحالة السورية[3]، ويمكن التفصيل في أربع تجارب مختلفة منها:
- مجلس الحكم العراقي 2003 وإشكاليات التعيين من الخارج:
أُنشأ مجلس الحكم العراقي عام 2003 من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وعدد محدود من الجماعات والشخصيات السياسية العراقية التي اختارت الولايات المتحدة الاعتراف بها بعد الإطاحة بصدام حسين، وقد رحّب القرار رقم 1483 للأمم المتحدة بالمجلس لكنه لم يعترف به صراحة كممثل شرعي للشعب العراقي، وقد تألف المجلس من 25 شخصاً تم اختيارهم في محاولة لتحقيق التمثيل الإثني والطائفي، إلا أن هذه الطريقة عززت الانقسامات الداخلية، خاصة أن عدد النواب السنة كان أقل من عدد النواب الشيعة والأكراد، وربطت السلطة وعمل المجلس بالهوية الطائفية[4].
عانى المجلس من غياب الشفافية والمعلومات عن عمله، وتحوّل الى مساحة للصراعات المتضاربة، حيث اعتبره البعض أداة بيد الاحتلال، كما أضعف التعيين من قبل جهة خارجية الشرعية الشعبية وتسبَّب في غياب المواطنة لصالح بروز هويات طائفية أو إثنية، كما كانت صلاحياته محدودة وقراراته تحتاج إلى موافقة سلطة الائتلاف، ولذلك كانت وظيفته التشريعية غير مستقلة وغير كاملة[5].
لم يكن هذا المجلس تشريعياً بالكامل، وإنما قام هذا خلال مدة عمله القصيرة لأحد عشر شهراً بتشكيل حكومة مؤقتة، وإصدار قانون إدارة المرحلة الانتقالية التي شملت النظام السياسي ومبادئ الحقوق والحريات وكيفية كتابة الدستور الدائم وتنفيذ الانتخابات[6]، كما شارك في وضع الميزانية، ومع ذلك فشل في تحقيق الشرعية الشعبية[7] والقبول الجماهيري، إذ اعتُبر امتداداً للسيطرة الأمريكية، كما فشل في خلق توافق وطني، بل عزَّز روح المحاصصة التي استمرت حتى بعد انتهائه[8].
- المجلس التشريعي في مصر 2011؛ الثغرات القانونية وصعوبات التوافق:
أدّت ثورة يناير في مصر 2011 للإطاحة بنظام مبارك، ونقلت السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عمل هذا المجلس على إصدار إعلان دستوريّ يُنظّم الانتخابات البرلمانية وفق نظام خاصٍ يمنح ثلثي المقاعد وفق القوائم النسبية (قوائم الأحزاب) مقابل الثلث الذي يمنح للنظام الفردي (انتخاب الأفراد)، وتمت الانتخابات بشكلها المعتاد في 9 محافظات على مدى يومين، وسمح للمغتربين بالمشاركة عبر السفارات[9].
جرت الانتخابات المصرية في وقتٍ ظلت فيه مؤسسات الدولة متماسكة، إلى جانب كون الحياة الحزبية والسياسية الموجودة ناضجة إلى حدٍّ ما، ومع ذلك كان تطبيق الانتخابات ونظامها مُعقَّداً وفيه ثغرات، وقد حظي المجلس في بداية عمله بشرعية شعبية عالية إلا أن هذه الشرعية تراجعت لاحقاً، فقد انتقلت الصراعات السياسية بين الأحزاب إلى داخل المجلس ولم يتمكن من معالجة قضايا مهمة[10]. لم تكن هذه الصراعات الحزبية مقبولة لدى الجماهير في مثل هذه اللحظات الحرجة، بل كانت تنتظر توافقات من الفرقاء السياسيين للتركيز على تعزيز الاستقرار، وحلّ قضايا تُؤثّر بشكل يومي على حياة المواطنين، كما أثار تركُّز السلطة في بعض المواضع بيد المجلس العسكري استياء المواطنين وحنقهم واعتبروه ضد مبادئ الثورة. لم يتمكن هذا المجلس من العمل سوى بضعة شهور حتى تم حله من قبل المحكمة الدستورية التي طعنت بقانون الانتخابات[11].
- المؤتمر الوطني العام الليبي 2011 وصعوبة الحفاظ على الشرعية:
أما في ليبيا، فقد أسفر إسقاط نظام القذافي عام 2011 عن انتخاب المؤتمر الوطني العام الليبي كأول هيئة تشريعية منتخبة عام 2012 وفق نظام انتخابي مختلط (120 عضوًا بنظام الأغلبية، 80 عضوًا بنظام التمثيل النسبي)، وقد كُلِّف بصياغة دستور دائم لليبيا، ضمن عملية انتقالية. عيَّن هذا المؤتمر اللجنة الدستورية، إلا أن عمله ظل مفتقراً للشفافية ولم تَجرِ الانتخابات اللاحقة على النحو المرجو[12].
ورغم أن أعضاء المجلس منتخبين إلا أن شرعيتهم تراجعت بعد العام الأول نتيجة تمديد ولاية المجلس دون انتخابات أو توافق، بالإضافة إلى الانقسامات بين أعضائه وتحالف بعضهم مع بعض الجهات المتنفّذة، عدا عن ضعف إشراك الشعب في اتخاذ القرار[13].
- المجلس التشريعي الانتقالي في السودان؛ مجلس على الورق:
أما في السودان، فبعد الإطاحة بعمر البشير في أبريل 2019، تم الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي لإنشاء مرحلة انتقالية مدتها 39 شهراً تضم 3 أجسام رئيسية بينها المجلس التشريعي الانتقالي، وقد نصت الوثيقة على أن يضم قرابة 300 عضو، بتمثيل نسائي لا يقل عن 40%، ويتم تشكيله خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وتُناط به مهام سنّ القوانين، الرقابة على الوزراء، اعتماد الميزانية، المصادقة على المعاهدات، واختيار رئيس الوزراء في حال سحب الثقة، إلا أن إنشاء هذا المجلس تأخَّر بشكل كبير لأكثر من 6 سنوات تاركاً البلاد في حالة فراغ تشريعي فعلي حتى الآن[14].
تشير التجارب السابقة إلى أن العمل النيابي في ظل المراحل الانتقالية يطاله الكثير من التحديات المتعلقة بالشرعية والتوافق والإنجاز، وتبدو احتماليات فشله مرتفعة، إذ لا يحظى في العديد من الأحيان بسلطة تشريعية كاملة ويتأثر بنفوذ السلطات الموجودة، كما أن فترات عمله قد تكون قصيرة نتيجة الأوضاع غير المستقرة، ويمكن أن يفقد التأييد والشرعية الشعبية بسرعة، نتيجة سوء الأداء أو عدم إحساس الناس بتغيُّرات حقيقية، أو بسبب تحوّل المجلس إلى مكان للصراعات السياسية وتصفية الحسابات بدل تحسين وضع الخدمات ومراقبة عمل الحكومة.
وحتى في حالات اختيار المجالس وفقاً لشكل الانتخابات الاعتيادية كما في مصر وليبيا، والتي أعطت الأعضاء شرعية شعبية عالية على اعتبارهم ممثلين للجماهير، كانت التوقّعات العالية تتراجع بشكل سريع وبعد عدة شهور وتتحوّل إلى حالة من خيبة الأمل، خاصة عندما يتعثّر المجلس النيابي في أداء مهامه، ويعجز عن تحقيق نتائج ملموسة لاسيما في ملفات حساسة كمراقبة أداء الحكومة في مجالات الأمن، أو الأسعار، أو الخدمات، أو مكافحة الفساد، وتزيد الفجوة بين الجماهير عندما يتراجع التواصل بينهم وبين النواب.
تشير التجربة العراقية إلى أن مجلس الحكم افتقد الشرعية الشعبية لكونه جاء مُعيَّناً من طرف محتلّ غربي، إلا أن الدرس الأبرز الذي تُقدّمه هذه التجربة أن إنشاء مجلس تشريعي يقوم على المحاصصات الطائفية سيخلق شرخاً ويُعزّز هذه الفكرة في أذهان المواطنين يصعب معالجتها في المستقبل.
إن عمل المجالس النيابة في فترات الانتقال السياسي يتم في بيئة متقلِّبة وغير مستقرة، ويحتاج إلى ما يُعزّز هذا الأداء ويرشده لمواجهة الضغوط والعوامل الخارجية، ولهذا تصبح إدارة العلاقة بين نواب المجلس التشريعي وبين الشعب أمراً ذا أولوية قصوى في كافة الظروف، فمن الضروري بناء الثقة بين الطرفين، وإشعار الناس بأن النواب يقومون بعملهم، وأنهم مرئيون بالنسبة للشعب، والتعويض عن ضعف شرعية الانتخابات العامة بشرعية الإنجاز، ومحاولة تجنُّب الصدامات السياسية، وبناء توافقات داخلية، وتجنُّب هيمنة بعض المؤسسات عليه.
نصائح وتوصيات لنواب المجلس التشريعي في سوريا:
تعتبر المرحلة الانتقالية الحالية في سوريا مرحلة حرجة للغاية، إذ تعاني فيها البلاد الكثير من الإشكاليات على الصعيد الداخلي والخارجي على حدّ سواء، ويستشعر فيها السوريون صوتهم للمرة الأولى بعد ما يزيد عن نصف قرن من التجميد وكتم الحريات، وسط ما طفى على السطح من انقساماتٍ مجتمعية وتجاذبات سياسية، ومطالب مختلفة تبدأ من الخدمات وحتى شكل الدولة وتسميتها.
وعلى مستوى الأفراد يواجه النواب في هذا المجلس التشريعي العديد من التحديات الإضافية، أهمها إظهار نموذج عمل جديد لهذا المجلس يعيد تصحيح مساره وصورته في أذهان الشعب، ويدمجه مرة أخرى في المهام المنوطة به؛ سواء التشريعية أو الرقابية، إذ ينتظر المجلس تحديات كبيرة في التعامل مع البنية التشريعية المهترئة ودراسة التعديلات المطلوبة لما يزيد عن 800 قانون[15]، بما يتوافق مع الواقع الجديد ومتطلّباته وتسهيل حياة الناس فيه، وهو ما سيجعل هذا المجلس تحت ضغط الحكومة وأولوياتها الآنية بشكل كبير.
إلا أن أهم ما يجب على النواب الجدد العمل عليه هو توثيق وإصلاح علاقتهم مع الشعب الذي لم ينتخبهم بالشكل التقليدي، وتعزيز حالة الشرعية الشعبية التي يمكن من خلالها تعزيز مكانتهم بكونهم ممثلين عنه، وهو ما يتطلب منهم بذل الكثير من الوقت والجهد لإظهار نموذج عمل جديد، قريب من الجماهير قادر على تحويل مشاكلها وأولوياتها ذات الصلة بمجلس الشعب إلى أجندات عمل تتوازن مع أولويات الحكومة في هذا المجلس وضغوطاتها الآنية.
ويمكن أن تبدأ عملية الإصلاح هذه من خلال التركيز على أهم المسؤوليات المنوطة على النائب في المجلس التشريعي، وهي المساءلة والمشاركة، وذلك من خلال إلزام النواب أنفسهم بها في حال لم يلزمهم النظام الداخلي بذلك، فمن الضروري أن يشارك النائبُ الشعبَ بشكل دوري معلومات عن عمله وإنجازه، ويكون ذلك بإصدار تقرير دوري موجَّه للعامة يوضح نبذة عن أداء النائب، والتصويت الذي قدَّمه تجاه القرارات والقوانين وتبريرها وعرض وجهة نظره فيها، والملفات التي تابع الحكومة فيها، إذ إن ذلك يُصحّح الصورة الأولية التي تفترض ارتباط النائب بالجهة التي رشَّحته، ويُعيد تقريبه من الشعب الذي يُفترض أن يُمثّله.
يمكن للنواب أنفسهم إنشاء نهج مساءلة أفقية يُدرَج ضمن النظام الداخلي للمجلس، وذلك باعتماد نظام لتقييم أداء النواب وفق منهجية رصينة تتابع مدى حضورهم وأهمية مداخلاتهم ومقترحاتهم، وتضع تصوّرات للتعامل مع السلوكيات غير المنطقية كالغياب المتكرر وإساءة استخدام المنصب، كما يمكن تفعيل المشاركة المجتمعية الجانبية على نطاق أوسع، وذلك من خلال المطالبة بآراء الخبراء في قضية ما، أو طلب جلسات استماع علنيّة مع جهات اعتبارية كمنظمات المجتمع المدني والنقابات كنقابة المحامين وغيرها، أو طلب مذكرات وآراء مكتوبة من قبل مختصّين حول قضية ما بما يساهم برفع مستوى شرعية القرارات المتخذة، ويزيد من المشاركة الشعبية.
كما أن فتح قنوات تواصل متنوّعة وحقيقية مع الناس فرصة لزيادة الارتباط والتواصل، إذ إن تنظيم لقاءات دورية مع مختلف الشرائح أمرٌ مهم بشرط ألا تكون هذه اللقاءات شكليّة شرفيّة ومنصّات للتنظير فقط أو تستهلك عضو البرلمان بما ليس ضمن مهامه ومسؤولياته، والانتباه إلى عدم تقديم وعود مرتفعة السقف، مع ضرورة الإفصاح عن اللقاءات التي تتم مع الجهات الأخرى؛ حكومية كانت أو دولية، وعن الذمم المالية التي يمتلكها النائب قبل دخوله للمجلس، وإلى جانب ذلك فإن تنظيم عملية استقبال الشكاوى والالتزام بالرد عليها خلال مدة زمنية مُحدَّدة تعيد إصلاح العلاقة مع الشعب وتجعل النائب قريباً منه معنيّاً بالتفاعل معه.
إن غياب الانتخابات المحلية الخاصة بالبلديات أو المجالس المحلية، وتفاوت أدائها حسب المناطق ودرجة الدمار الحاصل، سيجعل أعضاء مجلس الشعب الوجهة الأولى لشكاوى المواطنين وإبداء الرأي والضغط لتحسين أوضاع مناطقهم، لا سيما ما يتعلق بضعف الخدمات، وهو ما قد يحرف النائب عن مهمته الرئيسية ويضعه تحت ضغط جديد، ويجعل تجاوبه مع هذه المشاكل هو معيار الشرعية الشعبية والقرب من المواطنين.
إن نواب المجلس التشريعي السوري الجديد أمام تحدٍّ كبير يتجلّى في الموازنة بين مهامهم الأساسية التشريعية والرقابية والتشاركية، وبين القوانين التي تحاول الحكومة الضغط لتمريريها لتنفيذ ما اضطلعت به من مسؤوليات، وبين مطالب الشعب الخدمية ورغبتهم في حدوث تغيير ملموس. ولهذا فمن الضروري أن يستحضر النائب دوماً دوره الرقابي خلال علاقته بالجمهور ويعمل من خلاله، ويتجنّب تقديم وعود خدمية، بل يوضح للناس وبكل شفافية أنه سيحوّل ويحوّل مطالبهم المحقة إلى ملفات ضغط على الجهات ذات الصلة بمطالبهم ويهتم بالمسائلة عن ضعف الخدمات؛ سواء في الجلسات العامة للمجلس أو في اللقاءات الفردية التي يجريها مع الموظفين الحكوميين، وينقل نتائج هذا التواصل بكل شفافية للشعب من خلال قنواته التي قام بإنشائها.
كما أن الدفع باتجاه إنشاء نظام انتخابي عادل، وتهيئة البيئة المناسبة لعقد هذه الانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية قد يكون من أبرز الإنجازات والمسؤوليات المتوقعة من هذا المجلس، والتي تبدأ بتنظيم الحياة السياسية وإقرار قانون الأحزاب ثم العمل على إنشاء دستور جديد للسوريين بشكل تشاركي، والترتيب لعملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية في نهاية المرحلة الانتقالية بحيث تضمن أفضل تمثيل ممكن للسوريين على المستوى الجغرافي والطائفي والإثني لمختلف الشرائح السورية من كافة المناطق والخلفيات.
إن العلاقة بين النائب والشعب يمكن إصلاحها وترميمها في المراحل الانتقالية، من خلال اعتماد النواب نهج مساءلة شخصية طوعية، تنطلق من ترسيخ حالة من الشفافية مع الجمهور، وتعزز المشاركة والشراكة الفعالة، والإسهام في إصلاح آلية عمل المجلس وتحسين أدائه لا سيما الدور الرقابي، وإدارة توقعات الجماهير، بما يعكس رغبة حقيقية لتحسين علاقة النواب مع الشعب وتمتينها، وتعويض “نقص الشرعية”، وسن مسار جديد يجعل التوجه للمواطنين أحد أولويات العاملين في الشأن العام، يحترم وجودهم ويشركهم في صناعة القرارات الحساسة، ويعزز أدوارهم في صناعة المستقبل.
مديرة الوحدة المجتعية في مركز الحوار السوري، بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة دمشق، ماجستير في حماية اللاجئين والهجرة القسرية من جامعة لندن، باحثة مهتمة في قضايا المرأة والهجرة والمجتمع المدني