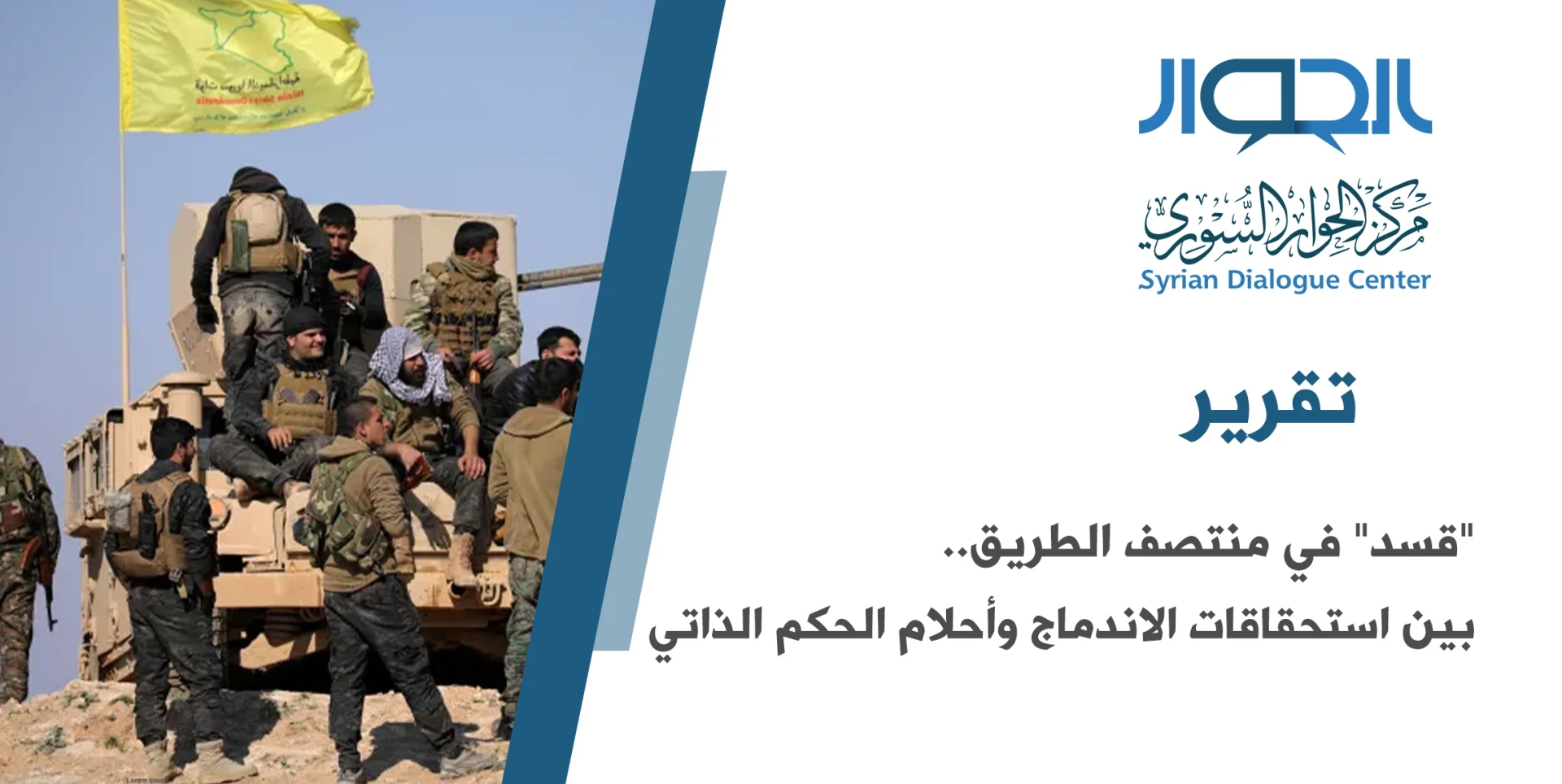
“قسد” في منتصف الطريق.. بين استحقاقات الاندماج وأحلام الحكم الذاتي
تقرير صادر عن وحدة تحليل السياسات في مركز الحوار السوري
تمهيد:
شهدت دمشق يوم 9 تموز 2025 انعقاد جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السورية ووفد لـ”قوات سوريا الديمقراطية-قسد”[1]، تزامناً مع وصول المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا إلى دمشق وأنباء غير رسمية أنه كان مشاركاً بشكل مباشر في هذه الجولة من المفاوضات[2].
جاء هذا الاجتماع بعد مرور نحو أربعة أشهر من توقيع اتفاق آذار بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي والذي نص على اندماج “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” في مؤسسات الدولة السورية[3]، غير أن تطبيق الاتفاق يشهد تباطؤاً في تنفيذ بعض البنود الجوهريّة، لا سيما فيما يتعلق بتسليم المعابر وحقول النفط والغاز[4].
ويلاحظ أن التباطؤ في التنفيذ لم يُترجم إلى توترات ميدانية، إذ إن الحالة الأمنية والعسكرية شمال شرقي سوريا توحي بوجود رغبة بالحفاظ على التفاهمات، حيث لا تزال خطوط الاشتباك في هدوء مستمر منذ التوصُّل إلى اتفاق آذار 2025.
تزامناً مع هذا، تسير “قسد” في مسار يبدو متناقضاً: فهي ورغم الاتفاق المبدئي مع دمشق إلا أنها ترفض الإعلان الدستوري والتشكيلة الجديدة للحكومة السورية ولا تزال تُروّج للفيدرالية أو الحكم الذاتي[5]، ومن جهة أخرى تواجه متغيّراً قد يُعيد تشكيل هويتها، وهو إعلان حزب العمال الكردستاني التركي حلّ نفسه واستعداده للحل مع الدولة التركية[6]، وهذا ما قد ينعكس على “قسد” لاسيما مع الارتباط الوثيق بين الطرفين.
ولا يمكن إغفال التأثير الأميركي في رسم هذا المسار، إذ طالما حرصت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على إبقاء “قسد” كذراع محلية لنفوذها العسكري في شمال شرقي سوريا، لكن ومع الدعم المعلن من إدارة ترامب للحكومة السورية الجديدة ورفع العقوبات عن سوريا ربما بات مصير “قسد” بالنسبة لواشنطن في محل إعادة تقييم.
ويطرح هذا المشهد مجموعة من التساؤلات الرئيسة لعل من أبرزها: ما الأسباب الكامنة وراء تباطؤ تنفيذ اتفاق آذار 2025؟ وما حدود التأثير الأميركي؟ وكيف سيؤثر إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه على هذا المسار؟ وما السيناريوهات المتوقعة؟
بناءً على ذلك، سيحاول هذا التقرير تقديم قراءة محدَّثة لمجريات اتفاق “قسد” مع الحكومة السورية معتمداً على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تتبّع وقائع الاتفاق وتحليل العوامل التي تُبطئ تنفيذه، ومدى تأثير الموقف الأمريكي، فضلاً عن إرث الانتهاكات السابقة والمتجددة في سِجلّ “قسد”، كما يُفرد التقرير فقرة خاصة لتحليل أثر إعلان حزب العمال الكردستاني (PKK) حلّ نفسه وانعكاساته المحتملة على مستقبل “قسد” وهويتها، باعتبارها أحد الأذرع المرتبطة بالحزب.
وفي فقرته الرابعة، ينتقل التقرير إلى استشراف مآلات الاتفاق من خلال طرح ثلاث سيناريوهات رئيسة، تراوح بين استمرار المسار التفاوضي، واحتمالات التصعيد العسكري، وحلول جزئية قائمة على إعادة الانتشار، انطلاقاً من الوقائع الميدانية ومعطيات التفاهمات الراهنة.
وتأتي أهمية هذا التقرير من توقيته المتزامن مع مرحلة دقيقة من مسار العلاقة بين الحكومة السورية الجديدة و”قسد” في ظل مستجدات داخلية وإقليمية قد تُعيد تشكيل ملامح المشهد في شمال شرقي سوريا.
بنود اتفاق الاندماج.. ملفات متوقفة وموقف أمريكي بين الحسم والتريث:
لم تُسفر جولة التفاوض الجديدة فيما يبدو عن تحقيق اختراق فعلي في ظل تمسّك “قسد” بمواقفها الأولية، ولعل هذا ما يظهر في البيان الحكومي الذي صدر بعد ساعات من انتهاء الاجتماع مع وفد “قسد”[7]، والذي أعاد التأكيد على ثوابت الدولة السورية القائمة على وحدة الأرض والجيش والحكومة، ورفض أي شكل من أشكال الفدرلة أو التقسيم، محذراً من أن أي تباطؤ في تنفيذ الاتفاق قد يُفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال شرقي البلاد، ما يشير إلى تصلُّب مواقف “قسد” في جولة المفاوضات على ملفات تراها الحكومة السورية فوق تفاوضية وخاصة ما يتعلق بتمسّك “قسد” بالفيدرالية.
هذه الرسائل تتقاطع مع تصريحات المبعوث الأمريكي توماس باراك الذي دعا “قسد” صراحةً إلى القبول بفكرة “سوريا الواحدة”، مؤكداً أن الفيدرالية “لا تعمل في سوريا”، ومشيراً إلى أن الطريق السياسي الوحيد المتاح لـ”قسد” هو “الطريق إلى دمشق”، خصوصاً أن البيان الحكومي ترك الباب مفتوحاً لـ”قسد” حينما أعلن عن الترحيب بانضمام “المقاتلين السوريين” من “قسد” إلى صفوف الجيش السوري[8].
توحي هذه الرسائل المتقاطعة –من دمشق والمبعوث الأمريكي– بأن “قسد” باتت يُنظَر إليها كطرف يراوغ في تنفيذ الاتفاق، ويؤخّر عمداً الانتقال إلى المرحلة العملية من الاندماج على أمل تحسين شروطه أو الحفاظ على مكاسب سياسية.
ولا تبدو هذه التصريحات مفاجئة من الحكومة السورية، إذ إن اتفاق آذار 2025 بين “قسد” والحكومة السورية شهد تقدُّماً في بعض الملفات مقابل جمود واضح في ملفات أخرى أكثر حساسية واستراتيجية لا تزال تراوح مكانها دون أي اختراق فعلي.
فعلى سبيل المثال، لم تُسلّم “قسد” الحكومة السورية المعابر الحدودية الواقعة ضمن مناطق سيطرتها في شمال شرقي البلاد، كما لا تزال حقول النفط والغاز والسدود –التي تُشكّل رافداً اقتصادياً بالغ الأهمية لسوريا– تحت سيطرة “قسد”، وإلى جانب ذلك لم يُطرح بشكل جدي حتى الآن أي إطار واضح لدمج قوات “قسد” ضمن المؤسسة العسكرية السورية، ما يشير إلى وجود فجوة في الثقة وتباين في الرؤى حول شكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين.
مع ذلك، شهدت العلاقة بين “قسد” والحكومة السورية الجديدة بعض خطوات بناء الثقة، كان أبرزها في ملف تبييض السجون بين الطرفين وخروج المئات من الموقوفين، رغم تباطؤ التنفيذ وتعليق الاتفاق مؤقتاً[9]، ومماطلة “قسد” حتى الآن في تنفيذ الانسحاب الكامل من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب[10]، بالتزامن مع تسجيل انتهاكات يُمارسها عناصر “قسد” وخاصة ما يتعلق باعتقال القُصّر للتجنيد[11].
كما حصل تقدّم في ملف التعليم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية تأجيل امتحانات الشهادتين حتى يتم فتح خمسة مراكز امتحانية في مناطق سيطرة “قسد” لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، ويمكن النظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مؤشراً على محاولة دمج المؤسسات المدنية في مناطق “قسد” ضمن مؤسسات الدولة، رغم أنها قد تصبّ بشكل مباشر في مصلحة “قسد” أكثر من الحكومة السورية، إذ تمنح اعترافاً رسمياً بالشهادات الصادرة من تلك المناطق بعد سنوات من غياب الاعتراف في عهد نظام الأسد المخلوع.
مع ذلك، فإن هذه الخطوة -رغم رمزيتها- إلا أنها قد تفتح الباب أمام تفعيل مؤسسات مدنية أخرى مثل دوائر النفوس، والهجرة والجوازات، ووزارة الداخلية… الخ، ما يُعزّز الاندماج الإداري تدريجياً، إلا أن استمرار هذا المسار يبقى مشروطاً بتقديم “قسد” خطوات ملموسة على الأرض تؤكد التزامها بما تم التوصل إليه في تفاهمات آذار الماضي، وتدلّ على استعدادها للانتقال من مستوى التنسيق الجزئي إلى التخلي عن الهيمنة على المؤسسات الرسمية.
إلى جانب التفاهمات في ملف التعليم؛ سمحت “قسد” بزيارة وفد حكومي إلى مخيم الهول[12]، ثم أذنت بخروج دفعات من نازحي ريف حلب إلى قراهم بعد سنوات من المنع[13]، ورغم هذه الخطوات إلا أنها لا ترقى إلى مؤشرٍ حاسم على نية “قسد” تسليم مخيمات عوائل داعش أو سجون مقاتلي داعش للحكومة الجديدة، فـ “الإدارة الذاتية” (الجناح السياسي والإداري لقسد) تُدرك أنّ ملف المخيمات والسجون يُشكّل ورقة ضغط أساسية تستجلب بها الدعم المالي والأمني من التحالف الدولي ويُبقي الإدارة الذاتية في صلب أي نقاش دولي حول مكافحة الإرهاب[14]، ولذلك تُبقيه في دائرة المماطلة وتؤجّل آليات التنفيذ، لكنها في ذات لا الوقت لا تريد أن تبدو كمن يعرقل العودة الطوعية والآمنة للمدنيين.
لهذه الأسباب يبدو أن “قسد” تُفضِّل المراوحة؛ فهي تتقدّم خطوات محدودة، ثم تتباطأ في تسليم المعابر أو النفط أو المخيمات، ريثما تتضح بالنسبة لها توازنات النفوذ في شرق الفرات، وخاصة ما يتعلق بالانسحاب الأمريكي من عدمه، لاسيما مع التصعيد الإيراني “الإسرائيلي” الأخير ودخول الولايات المتحدة حرب الـ 12 يوماً بشكل جزئي، ما قد يجعل الولايات المتحدة أكثر ميلاً إلى تخفيف قواعدها العسكرية في سوريا بحيث لا تصبح هدفاً للصواريخ الإيرانية عند أي تصعيد محتمل.
وقبل جولة التفاوض الأخيرة في تموز الجاري، أشاد المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك بدور “قسد” في قتال “داعش” لكنه اعتبر أن ما يجب أن يحدث الآن هو الاندماج سياسياً وعسكرياً في سوريا الجديدة[15]، وأن “هناك دولة واحدة سنتعامل معها، وهي الحكومة السورية”.
خطاب باراك يوحي بتحوُّلٍ في المقاربة الأميركية تجاه “قسد” من شراكةٍ عسكرية ظرفية (الحرب ضد داعش) إلى مقاربة احتواء وإعادة هيكلة تدعو “قسد” إلى الاندماج في مؤسسات الدولة لاسيما مع تزايد الاندفاع الأميركي نحو تعويم الحكومة السورية الجديدة ورفع العقوبات عنها.
لكن الملحظ الأهم أن الولايات المتحدة، وعلى الرغم من تبلور توجُّهاتها بشكل أوضح تجاه الملف السوري، إلا أنها لم تمارس في الأشهر الأربعة الماضية ضغطاً كبيراً على “قسد” لتسريع عملية الاندماج، وهذا التراخي قد يشير إلى أن واشنطن فضّلت لعب دور الراعي لحوارٍ متدرّجٍ بين الطرفين بدلاً من فرض مسار إجباري، وربما هذا ما شجع “قسد” على التصلب بمواقفها خلال جولات التفاوض مع الحكومة في دمشق.
وفي مؤشر إضافي على استمرار هذه المقاربة، طلبت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تخصيص 130 مليون دولار في ميزانية العام المالي 2026 لدعم “قسد” شمال شرقي سوريا و”جيش سوريا الحرة” في منطقة التنف[16]، ما يعكس قناعة المؤسسة العسكرية الأمريكية بأن اندماج “قسد” لن يحدث قريباً، وأن الحفاظ على الشراكة المؤقتة مع “قسد” ضروري لضبط الوضع الأمني حتى نضوج التسوية السياسية، بعكس باراك الذي يبدو أكثر اندفاعاً لتسريع وتيرة الاندماج.
ومع ذلك، فإن مراقبين ينظرون إلى طلب الموازنة على أنه إجراء روتيني وأن “قسد” فقدت أهميتها القتالية بعد نهاية داعش في آخر معاقله بمعركة الباغوز[17]، فضلاً عن أن الميزانية تتناقص سنوياً، حيث وصلت إلى 130 مليون دولار في 2026 بعدما كانت 500 مليون دولار في 2018[18].
ما بعد الـPKK ومفترق الهوية.. استحقاقات التحوّل الوطني أمام “قسد”:
بعد صراع مسلّح دامَ أكثر من أربعة عقود بين حزب العمال الكردستاني (PKK) والدولة التركية، خلّف آلاف الضحايا داخل تركيا وخارجها[19]؛ جاء إعلان الحزب حلّ نفسه ليشكل محطة مفصلية يتجاوز أثرها الداخل التركي نظراً لشبكة امتداد الحزب في سوريا والعراق وإيران وأوروبا.
ففي شمال شرقي سوريا تُعدّ “قسد” الذراع السوري للحزب وترتبط به ترابطاً تنظيمياً وعقائدياً، لكن قائد “قسد” مظلوم عبدي حاول تقليل أثر إعلان حزب العمال نفسه خارجياً معتبراً القرار “يتعلق بالحزب ولا ينطبق على سوريا”[20]، لكنه أثنى عليه بوصفه خطوة “جديرة بالاحترام”[21]، إلا أن هذا التصريح لا يخفي بطبيعة الحال الواقع البنيوي والارتباط العضوي، فـ”قسد” اعتمدت منذ تأسيسها على كوادر الحزب وتخضع في قراراتها المفصليّة لتوجيهات قيادات متمركزة في جبال قنديل[22]، ويتجلى ذلك عملياً بالمناهج التي أقرتها “الإدارة الذاتية” التي تُمجّد فكر أوجلان، فضلاً عن المسيرات الداعمة له سنوياً أو العقد الاجتماعي الذي أقرته “قسد” قبل نحو عامين[23].. الخ.
ومن هنا يمكن فهم الموقف التركي الذي يدعو إلى ضرورة أن يشمل حل حزب العمال كافة فروعه وامتداداته وهياكله[24]، وقد ساهم اتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع مع مظلوم عبدي في تخفيف حدة التوتر بين “قسد” وتركيا، ثم جاء إعلان حلّ الحزب ليعزز حالة “الارتياح الحذر” لدى أنقرة، إذ باتت ترى في تفكيك “قسد” هدفاً ممكناً عبر التفاهمات، لا العمليات العسكرية، ويتجلى ذلك عملياً بغياب الضربات التركية منذ تفاهم الشرع وعبدي في مؤشر على تحول تكتيكي تركي في التعامل مع الملف دون استبعاد الخيار العسكري حال فشل الاندماج[25].
في خلفية هذا المشهد، تحضر تداعيات حرب “إسرائيل” على غزة كمؤثر غير مباشر، إذ تسعى أنقرة إلى الحيلولة دون استخدام الورقة الكردية من قِبل “إسرائيل” التي تستحضر بشكل متكرر خطاب “حماية الأقليات” في سوريا ومنها الشمال الشرقي[26]، ومن هذا المنطلق تُبدي تركيا انفتاحاً على دمج “قسد” ضمن الجيش السوري، شرط أن يتم تفكيك التنظيم[27] بحيث لا يبقى كتلة صلبة مستقلة يمكن أن تشكّل تهديداً استراتيجياً في المستقبل، وشرط ألا يؤدي الاتفاق إلى الحكم الذاتي[28]، وبالتالي قطع الطريق أمام “إسرائيل” في إشعال التوترات بالمنطقة.
وهنا يبرز رهان تركي على انسحاب كوادر PKK من سوريا كفرصة لتجفيف المنابع الأيديولوجية للتنظيم، وفتح الطريق أمام تمثيل كردي سوري أكثر استقلالاً وأقرب للاندماج في المؤسسات الوطنية، ولذلك فإن أردوغان انتقد أكثر من مرة مماطلة “قسد” في تنفيذ بنود الاتفاق[29]، بينما تتحدث “قسد” بذات الوقت عن اتصالات مباشرة بينها وبين تركيا دون الخوض في التفاصيل[30]، وسط أنباء عن دور أمريكي في رعاية التفاوض[31].
لكن ومع غياب التفاصيل والمعلومات حول الوجهات التي يمكن أن ينتقل إليها قياديو pkk من تركيا يبرز سيناريو آخر وهو احتمال أن يتحوّل شمال شرقي سوريا إلى “ملاذ بديل” لقيادات PKK بعد حلّ وجودهم في تركيا، إلا أن هذا الخيار -وإن كان وارداً كسيناريو- لكنه يبقى ضعيفاً خصوصاً مع وجود توجه تركي بإنهاء مخاطر تنظيم حزب العمال داخل تركيا وعلى الحدود مع دول الجوار وإغلاق جميع فروعه وامتداداته وهياكله غير القانونية.
في المجمل، يُشكّل إعلان حزب العمال الكردستاني عن حلّ نفسه والتهدئة المستمرة بين “قسد” ودمشق فرصة لـ”قسد” لإعادة تعريف موقعها والتخلّي تدريجياً عن الإرث الأيديولوجي القادم من “قنديل”، فعلى مدار سنوات حاولت “قسد” الدفاع عن “استقلالها” عن حزب العمال، وباتت الأوضاع أمامها الآن مهيأة أكثر لفك الارتباط الفعلي، وهو تحوّل لا يمكن أن يتحقق دون التخلي عن أيديولوجية الحزب ومشروع الفيدرالية الذي لا تزال “قسد” تتمسك به، وبالتالي فإن إعلان الحزب يمنح “قسد” فرصة للخروج من عباءة الاتهام بأنها الفرع السوري للتنظيم وبما يُشكّل لحظة حاسمة لها لإثبات الوطنية السورية.
لكن الوصول إلى هذه التحوّلات لن يكون ممكناً ما لم تراجع “قسد” بنيتها التنظيمية وتُقدِم على خطوات عملية تعكس انفكاكها عن مشروع “قنديل” كإخراج الكوادر الأجنبية، وحصر القرار السياسي والعسكري بيد السوريين، وعدم الاستمرار في التعويل على الدعم الخارجي والوجود الأمريكي.
ولا يعني تخلّي “قسد” عن الفيدرالية –بأي حال– التخلّي عن الحقوق الثقافية واللغوية للمكوّن الكردي، بل إن أحد أهم شروط نجاح هذا التحوّل هو تحصين هذه الحقوق وجعلها فوق تفاوضية، ومن باب أولى ضمان حقوق الأكراد في المواطنة وحقوقهم الدستورية والتمثيل في المؤسسات ضمن صيغة تشاركية، وهي بالأصل روح وجوهر البنود المتفق عليها في اتفاق آذار بين الشرع وعبدي[32]، كما إن المادة 7 من الإعلان الدستوري تنص على أن الدولة تكفل التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين[33].
إرث الانتهاكات وتجدُّدها.. عقبة أمام بناء الثقة:
وفي خضم الجدل الدائر حول مستقبل “قسد” ومكانها في الدولة السورية الجديدة، تبرز معضلة إرث الانتهاكات وتجدُّدها في العديد من المناطق بعد اتفاق القيادة السورية الجديدة وقيادة “قسد” في آذار 2025، فـ”قسد” التي راكمت إرثاً ثقيلاً من الانتهاكات طيلة السنوات الماضية مثل الإخفاء القسري[34]، والقتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، وعمليات تجنيد الأطفال القُصّر، والاستيلاء على الممتلكات[35]، واستخدام النازحين كورقة ضغط سياسية[36]؛ تقوم بتكرار بعض هذه الانتهاكات منذ اتفاق آذار[37].
فرغم استمرار المفاوضات السياسية مع الحكومة السورية الجديدة، إلا أنه تم تسجيل العديد من حالات تجنيد الأطفال القُصّر في صفوفها[38]، وشنها حملات اعتقال تستهدف كل من يرفع العلم السوري الجديد أو يُعبّر عن موقف مخالف[39]، كما سُجّلت حالات قتل وإعدام منها لأطفال[40]، الأمر الذي يكرس الشكوك بشأن نواياها الحقيقية في التحوّل إلى كيان وطني، فضلاً عن أن ذلك قد يشير إلى وجود صراع أجنحة داخل تيارات في “قسد” منها من يحاول عرقلة التفاهمات مع الحكومة الجديدة[41].
لهذا تبرز قضايا أساسية ينبغي أن تكون مستحضرة في خضم المفاوضات الجارية:
- أولاً: لا ينبغي التعاطي مع ملف دمج “قسد” في الدولة السورية من زاوية المكاسب السياسية أو الاقتصادية فقط – كاستعادة موارد النفط والغاز والمعابر – دون مراعاة العامل الشعبي والمجتمعات المتضرّرة من ممارساتها خلال السنوات الماضية، فـ”قسد” مارست ممارسات شبيهة بممارسات النظام البائد من قتل وتهجير وتمثيل بجثث السوريين[42]، بل كانت شريكة له في حصار حلب عام 2016[43].
- ثانياً: ينبغي الحذر من تكرار إدماج شخصيات مثيرة للجدل – كما حصل مع فادي صقر في مسار العدالة الانتقالية – لأن ذلك قد يُفجّر موجة غضب جديدة ويضعف الثقة الشعبية، ولذلك يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار مسؤولية الأفراد والجهات عن الانتهاكات، فلا يجوز التساهل مع أي شخصية لدى “قسد” متورطة بانتهاكات تحت ذريعة المصلحة الوطنية، بل ينبغي أن يكون من صُلب أي عدالة انتقالية حقيقية تحييد جميع الشخصيات المتورطة في الانتهاكات ومنعها من تولّي أدوار مستقبلية في مؤسسات الدولة شمال شرقي سوريا.
سيناريوهات ما بعد “اتفاق آذار”: بين التفاوض والنار
رغم حالة الهدوء العسكري المستمر في شمال شرقي سوريا، إلا أن التعثّر المتواصل في تنفيذ اتفاق آذار يفتح المجال أمام ثلاثة سيناريوهات محتملة، تختلف في درجة واقعيتها بناءً على تطورات الميدان ومواقف الأطراف المحلية والدولية:
1- الاستمرار في تنفيذ الاتفاق عبر مسار تفاوضي تدريجي:
يُعد هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً في المدى المنظور، نظراً للرغبة المتبادلة بين الطرفين في تفادي المواجهة العسكرية، واستمرار الخطوات المحدودة لبناء الثقة مثل فتح المراكز الامتحانية في مناطق “قسد”، والتعاون الجزئي في ملف مخيم الهول، وإطلاق سراح بعض الموقوفين، ومؤخراً وصول فرق إطفاء من شمال شرقي سوريا للمشاركة بإخماد حرائق الساحل[44].
ويعزّز هذا السيناريو استمرار الإدارة الأمريكية في لعب دور الضغط على “قسد” لتشجيعها على الاندماج دون فرض مسار دمج سريع، ولعل هذا ما يظهر في تصريحات جديدة أدلى بها المبعوث الأمريكي توماس باراك وأشار فيها إلى أن واشنطن “تريد التأكد من حصول قوات سوريا الديمقراطية على فرصة محترمة للاندماج بالحكومة”[45]، لكن بالمقابل قال إن “قسد تشعر أن على واشنطن التزاماً تجاهها لكننا لسنا ملزمين إذا لم يكونوا منطقيين[46]“.
2- الانزلاق نحو تصعيد عسكري محدود أو شامل:
يبقى هذا السيناريو قائماً في حال وصلت التفاهمات إلى طريق مسدود، خصوصاً فيما يتعلق بالملفات السيادية كالنفط والمعابر والفيدرالية، أو إذا أقدمت “قسد” على خطوات أحادية من شأنها استفزاز دمشق، وهنا ستكون تركيا في الواجهة أيضاً نظراً لكونها تراقب عملية تفكيك “قسد”.
لكن تتوقف واقعية هذا السيناريو على حجم الوجود الأمريكي؛ إذ إن أي تقليص كبير في الدعم أو انسحاب جزئي للقوات الأميركية قد يشجّع دمشق وحلفاءها على اعتماد خيار الحسم الجزئي، بينما تبقى احتمالاته محدودة في ظل ثبات خطوط الانتشار الأميركية شرق الفرات حتى الآن.
3- تسوية جزئية قائمة على إعادة الانتشار:
يفترض هذا السيناريو حلولاً وسطاً تقضي بانسحاب “قسد” من محافظتي دير الزور والرقة، مع إعادة تموضعها في محافظة الحسكة، على أن يُرحّل ملف الحسكة لمرحلة لاحقة.
يستند هذا السيناريو إلى إمكانية لجوء واشنطن إلى استخدام أدوات ضغط مركّبة على “قسد”، تتيح الحفاظ على الحد الأدنى من الشراكة معها، وتُخفّف استياء الحكومة السورية من استمرار تعنّت “قسد”، ويستحضر هذا السيناريو نموذجاً مشابهاً تم تطبيقه بعد سقوط النظام البائد حين انسحبت “قسد” من مدينة دير الزور تحت ضغط شعبي[47]، بعد أن كانت قد دخلت المدينة في ظل فراغ أمني وعسكري أعقب فرار جنود النظام البائد، وقد جرت تلك الانسحابات بتنسيق غير مباشر مع التحالف الدولي الذي حرص حينها على منع وقوع أي مواجهة مباشرة بين “قسد” وقوات “ردع العدوان” داخل المدينة[48].
خاتمة:
بالرغم من أن فترة أربعة أشهر قد لا تكون كافية للحكم على نجاح أو فشل اتفاق دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية- بحسب البعض-، إلا أن إصرار “قسد” على ربط اندماجها السياسي والعسكري بشروط تتعلق بالفيدرالية واللامركزية الموسعة يزيد من احتمالات فشل هذه العملية أو استمرار التفاوض لفترة مطولة، علماً أن التفاوض على أشكال من اللامركزية الإدارية قد يكون ممكناً في مرحلة لاحقة خاصة مع الإمكانيات المحدودة للحكومة الجديدة بالمرحلة الحالية، إلا أن طرحه كشرط أساسي منذ البداية قد يُفقد العملية السياسية جوهرها ويشجع مناطق أخرى على صيغ مشابهة.
من جانب آخر، يُمثّل هذا المسار فرصة لـ”قسد” لإعادة تعريف موقعها ضمن العقد الوطني السوري خاصة بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه، ما يتيح لها الانفصال عن الإرث العقائدي والتنظيمي القادم من قنديل، لكن هذا التحول يتطلب أولاً معالجة جدية لإرث الانتهاكات التي راكمتها “قسد” طوال السنوات الماضية والتوقف عن تكرارها، إذ لا معنى لأي عملية اندماج طالما بقيت الاعتقالات التعسفية، وتجنيد القُصّر، والقتل خارج القانون، واقعاً متكرراً في مناطق سيطرتها.
ومع الهامش المتاح لـ”قسد” في المناورة، إلا أنه لا يمكن إغفال التأثير الأميركي في تحديد مسار تفكيكها أو إعادة تشكيلها، إذ لا تزال تحظى بدعم يرتبط بذرائع تتعلق بمحاربة تنظيم داعش، غير أن التصريحات الأخيرة للمبعوث الأميركي توماس باراك ورفضه للفيدرالية وتأكيده لـ”قسد” أن طريقها هو إلى دمشق فقط تشكل ضغطاً حقيقياً في الدفع باتجاه الاندماج فيما لو تعزز بخطوات إضافية من الإدارة الأمريكية والتحالف الدولي، وبالتالي فإن الخيارات المطروحة أمام “قسد” بين البقاء كقوة أمر واقع أو التخلي عن أحلام الفيدرالية ونموذج كردستان العراق، تبقى رهناً ليس فقط بمدى استعدادها للمراجعة، بل أيضاً بجدية الأطراف الداعمة لها –وعلى رأسها واشنطن– في دعم مشروع التحول الوطني في سوريا، لا سيما في ظل ضعف الإمكانيات لدى الحكومة الحالية وسعيها إلى تجنّب الحلول العسكرية في التوصل إلى التفاهمات مع الأطراف المحلية المدعومة خارجياً كقوى أمر واقع.
باحث مساعد في مركز الحوار السوري، يعمل ضمن وحدة تحليل السياسات، كتب وشارك في العديد من الأوراق المتعلقة بتحليل سياسات الفاعلين في سوريا، يحمل إجازة في الأدب العربي من جامعة الفرات السورية، عمل كاتباً وصحفياً ومدققاً لغوياً لعدة سنوات في العديد من المواقع والقنوات الإخبارية.





